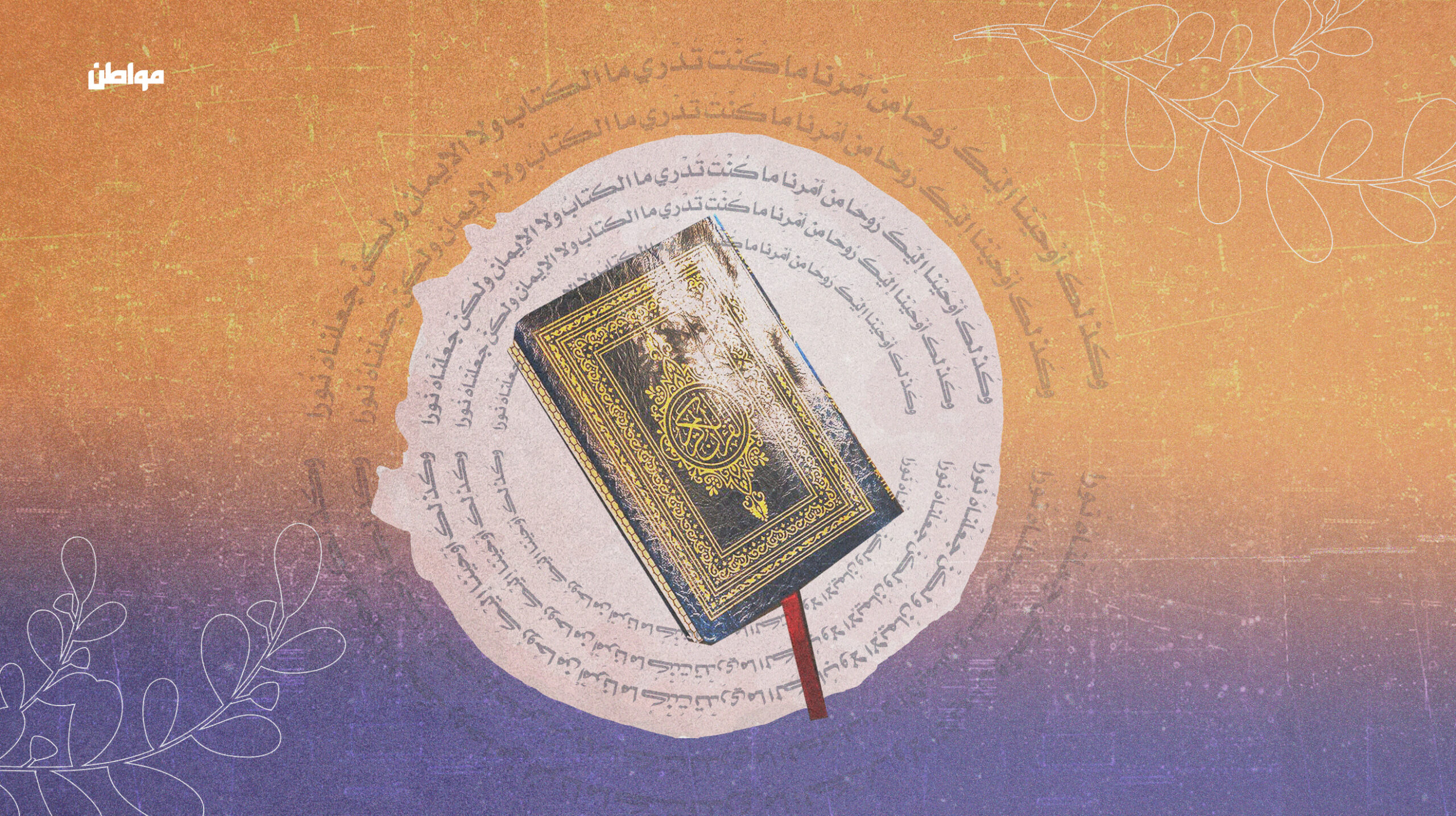قبل الفترة الليبرالية العربية في العصر الحديث وتحديدًا منتصف القرن 19م فما أقدم، كانت الثقافة حِكرًا على رجال الدين، فمنهم الأدباء والفقهاء والأطباء والفلاسفة والمهندسون. . إلخ، لم يكن مفهوم الثقافة حينها معروفًا كاتجاه إنساني معرفي شامل غير مرتبط بنصوص دينية، ومصدره الإنسان نفسه لا الكتب المقدسة، وبعدما خرج مفهوم “المثقف” بدايات القرن 20 ليكون موازيًا لرجل الدين ومنافسًا له في العلم.
جرى تقسيم المعارف إلى دينية وثقافية، فاحتكر المثقفون شتى المعارف الإنسانية الأخرى من علوم عقلية واجتماعية؛ كالأدب والشعر والتاريخ والفلسفة والمنطق والسياسة. . إلخ، وعلوم تجريبية أخرى كالطب والفيزياء والهندسة والكيمياء والفلك والاقتصاد، إلخ.
ومنذ هذا الحين أيضًا لم تتوقف الصراعات بين المثقفين ورجال الدين؛ حيث يميل المثقفون إلى المعرفة الإنسانية الأكثر شمولاً واتساعًا دون قيود دينية، بينما يميل رجل الدين إلى المعرفة المقيدة بالنص الديني؛ فيقبل ويرفض بناء على معتقده الخاص في المذهب، مع اعتبار أن كل جديد مرفوض وفقًا لقاعدة “أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”.
مثّلت هذه القيود حصارًا على معارف المتدينين وصنعت حواجز بينهم وبين العلم، فما من عالِم متخصص في مجاله التجريبي ويخرج باكتشاف لا يُرضي رجل الدين إلا ونجد مقاومة عنيفة تصل لحد التكفير، وما من عالم متخصص في مجاله العقلي والأدبي يخرج باجتهاد إلا ويجد نفس المصير، فالذي يحكم رجل الدين هو حاكمية الماضي واعتباره أصل الأصول، بينما علماء الطبيعة والمثقفون بالكامل يميلون إلى أن الحاضر هو بوابة العبور للمستقبل، وأنه لا نهوض أو تقدم يحدث سوى بالعقل والتجريب.
أما الماضي فيمكن اكتشاف القيم والجذور الإنسانية الصالحة منه لفهم الحاضر، ومن تلك الزاوية لم يحدث صراع بين الثقافة والأديان، لأن الدين عند المثقف هو قيم وجذور إنسانية هامة جدًا لبناء الإنسان وفهم مجتمع الحداثة، عدا ذلك من قصص وحكايات تمثل أصحابها في الزمان والمكان، لكنها لا يجب أن تحكم مجتمع الحداثة لقصورها الزمكاني وخصوصيتها الشديدة ومحدوديتها العلمية ما قبل ارتقاء الإنسان في عصر التنوير.
في القرن العشرين ظهرت فلسفة إنسانية جديدة تشرح جزءً هامًا من تلك العلاقة بين الثقافة والدين، أو بين الثقافة عمومًا بكل أنواعها على اعتبار أن الدين هو جزء من الثقافة؛ يجب فهمه وفقًا لسياق لغوي واجتماعي، فهي فلسفة مهتمة أكثر بجانبي “اللغة والاجتماع” كمقدمة لفهم كافة العلوم الأخرى، باعتبار أن هذه العلوم الأخرى هي نتاج تطوري في الزمان والمكان للغة والمجتمع، هذه الفلسفة هي “البنيوية”، واصطلح عليها بالإنجليزية structuralism وقد ظهرت أولا على يد عالم اللغات السويسري “فرديناند دي سوسير” المتوفى عام 1913 وشُرحت أكثر وتطورت على يد الفيلسوف والمؤرخ والأنثروبولوجي الفرنسي “كلود ليفي شتراوس” المتوفى عام 2009.
وملخص هذه الفلسفة أنها منهج لمعرفة “علاقة الأجزاء ببعضها داخل بنية معرفية واحدة” كمقدمة لمعرفة هذه البنية وعلاقتها ببنيات أخرى. . وهكذا، وبالتالي فهي منهج معرفي استقرائي أكثر منها فلسفة عقلية، أو هي طريقة استقصاء علمية أكثر من كونها علمًا بحياله، والذي دفع علماء البنيوية لهذا الاتجاه هو الغموض الكامن في النصوص الدينية والأدبية والشعرية، وصعوبة إيجاد معرفة حقيقية من هذه النصوص في الماضي.
مما دفع الإنسان قديمًا للتقليد كوسيلة مضمونة وآمنة للمعرفة تكون بديلة عن المغامرة التي كانت سمة للفلاسفة والنُقاد المعارضين للنهج التقليدي العام، وبالتالي فالبنيوية هنا هي حركة عقلية ثورية ضد التقليد ترى ضرورة استقصاء المعارف الجزئية للخروج بحكم كُلّي يساعد الإنسان على المعرفة، أو بتعبير آخر؛ هي مهتمة لمعرفة النظام بناء على تفاعلات أجزائه مع بعضها بعضًا، كلوحة الرسام مثلاً لا يمكن فهمها سواء بإيجاد العلاقة بين الألوان وبعضها وبين الأشكال الهندسية الصغيرة والكبيرة وطرح الأسئلة حول ضرورة رسم هذه الأشكال بخلفيات معينة وألوان معينة. .
ولتبسيط البنيوية أكثر فلو فرضنا أن هناك دولة ما، هذه الدولة لا يمكن فهم طبيعتها وأهدافها إلا بإيجاد العلاقة الاجتماعية واللغوية بين سكانها، فيجري تقسيم شعبها وفقا للغة، ويكون هذا التقسيم لمعرفة كم مجموعة لغوية في هذا المكان، ومن داخل كل مجموعة يجري تقسيم اللهجات. . وهكذا، فيجري البحث داخل نصوص تلك اللغات واللهجات لإيجاد العلاقة بين التراكيب اللغوية والدلالية والمصطلحات والمفاهيم لمعرفة المقصود.
فالذي يحدث هنا هو استقصاء علمي يهدف لمعرفة ثقافات وأعراف وأديان هذا الشعب، فاللغة هي وعاء الثقافة الذي يصنع جزءً كبيرًا من هويات الشعوب، ثم وبطريقة استقصائية أكبر يجري تقسيم الشعب لمجموعات عشائرية أو قروية أو مدنية لفهم العلاقة الأنثروبولوجية بينهم، وهذا يلزمه استقصاء الجذور التاريخية لتلك المجموعات وأثرها على تكوين ذلك المجتمع، مما يؤدي لفهم الأعراق والأنساب في مرحلة لاحقة.
هذا العمل يسمى طريقة تفكير بنيوية تأثرت بالنهج التحليلي الذي ظهر في أوروبا بالقرن 19، والذي كان يهتم بتقسيم الكليات إلى جزئيات، وبتقديم اللغة كمنهج أصيل للمعرفة الإنسانية، وصُنعت وتأثرت أيضًا باتجاهات فلسفية وتاريخية نشأت في القرن 20 كعلم أصول الكلمات “أتيمولوجي” Etymology وفقه اللغة العام “فيلولوجي”، أو الذي اصطلح عليه بتعبير آخر “فقه اللغة المقارن” Comparative linguistics فإذا كان هناك علم مقارنة الأديان والمذاهب. فهناك علم آخر حديث نشأ بناء على ظهور البنيوية؛ وهو علم مقارنة اللغات.
وبناء على تلك الأدوات اللغوية المستحدثة أصبحت وظيفة الفيلسوف والباحث البنيوي أكثر سهولة لاستقصاء معرفة (بنية النظام) بناءً على معرفة طريقة تفاعل أجزائه مع بعضها، أو تفاعل أجزائه مع (بنيات أخرى) إذا وجد ذلك، مما يعني أن العقل البنيوي هو تفكيكي بالأساس لا ينظر لأي نظام معرفي بشمولية كما كان يحدث بالماضي؛ بل يفككه إلى أجزاء ثم يُعيد تركيبه مرة أخرى بعد معرفة هذه الأجزاء.
وبناء على هذا فالبنيوية التعريف هي “دراسة من خارج الصندوق”، لأنه لا يمكن معرفة أجزاء الصندوق المعرفي إلا بعد تمييزه من الخارج كصندوق؛ بمعنى أنه يصعب أو يستحيل على من يعيش داخل هذا الصندوق أن تكون لديه القدرة على العلم بأجزائه؛ فرجل الدين مثلا الذي يقول بالخلافة الإسلامية هو يرى صندوق الخلافة من الداخل ولا يثق أو يحترم من يرى هذا الصندوق غير ملائم لهذا الزمان، وأنه إذا كان مناسبًا للماضي لكنه لا يصلح للحاضر كونه يتناقض أساسًا مع فكرة الدولة الحديثة والمواطنة وحقوق الإنسان والعقد الاجتماعي والدستور.
فالعقل الديني الذي يفكر من داخل الخلافة لا يرى علاقة أجزائها ببعضها، كاقتصاد الخلافة مثلها أو سياستها وطريقة حُكمها وثقافة شعبها وعاداته وأعرافه ولغاته وتاريخه، فينظر لهذه الجوانب المعرفية الهامة (كوحدة شمولية) تخدم فكرة الخلافة نفسها وتساعد في إيجادها وحمايتها، ولولا أن طريقة تفكير هذا الشخص سلطوية استبدادية ما نظر للخلافة بهذا المنظور.
ومن تلك الزاوية اهتمت البنيوية بتهذيب سلوكيات ونفس الباحث بوضع شروط تضمن استقامة هذا السلوك دائمًا بالنظر خارج الصندوق وامتلاك القدرة على النقد بشكل دائم.
أي لا يمكن للفيلسوف البنيوي أن يكون متعصبًا أو مستبدًا، سيمنعه هذا التعصب والاستبداد من رؤية عناصر وأجزاء النظام من الداخل إذا كان متعصبًا للبنية العامة أو النظام العام المُراد تفكيكه
فالميول البشرية تتحكم في صنع أعرافهم وثقافتهم وبحوثهم في الغالب، وإذا كان الباحث المتجرد عن الحقيقة لا يخضع لميوله الشخصية سوف يمتلك القدرة على البحث البنيوي، وكلما كانت درجة تحييده لهذه الميول أكبر ستكون قدرته على البحث والعمق البنيوي أكبر.
الفكر الإسلامي هو كأي فكر ديني مرتبك بظروف منشأ تأثرت بعوامل السياسة والاقتصاد والعشائرية والمذهب والصراعات والمصالح والميول الشخصية واللغة. . إلخ، ستكون معرفة هذا الفكر محكومة بالعلم بتلك العوامل التي صنعته كطريقة تفكير بنيوية، وهذه الطريقة في البحث لم يملكها الأقدمون، لكنها ظهرت مع المستشرقين الألمان في القرن 19 أولا، ثم تطورت بشكل لافت مع ظهور وتطور المناهج التحليلية والبنيوية والتفيكيكية والوضعية بالقرن العشرين.
فأصبح تناول الفكر الإسلامي المقصود به موضوعات شتى، كمعرفة تاريخ المسلمين ومجتمعاتهم في الزمان والمكان، وتصرفهم السياسي وميول حكامهم ورجال الدين إضافة لتحليل وتفكيك النصوص الدينية والأدبية والشعرية في الموروث الثقافي عامة، ولا يخلو هذا الاتجاه من نقد هذه المجتمعات والسلطات والنصوص باعتبارها علامات وأجزاء شكّلت بنية النظام الفكري الإسلامي.
فالتفكير البنيوي دقيق وعميق لدرجة الفصل بين الألفاظ والجُمَل “الدينية والأدبية والشعرية” من حيث حقيقتها اللغوية ومقاصدها الأدبية والاجتماعية، بمعنى أن كثيرًا من نصوص التراث الإسلامي تم تمييزها كاستعارات ودلالات وعلامات مقاصدية للكاتب محدودة بظروف وحوادث لم يذكرها النص، لكن البنيوية كشفتها بناء على حقائق علمية انطلقت منها “كالسلطة الاجتماعية واللغوية” فما من مجتمع إلا وتحكمه أعراف محلية، هي بنية معرفية تشكلت من سلطات رجال دين وحكام ونافذين وأعيان وحوادث سياسية مفصلية.
وتوجد أيضًا سلطة لغوية تحدد طريقة تفكير هذا المجتمع المحدودة في الزمان والمكان، فاللغة لها تأثير بالغ في صنع الأفكار بناء على كونها تعبيرًا عن ما يراه الإنسان في الحِس أولا، وما يشعره في نفسه ثانيا، وبناء على ذلك توجد علاقة شرطية بين اللغة والمجتمع باعتباره مصدر معلومات الحس الذي يشكل ويصنع علامات اللغة، وكذلك شعور الإنسان من خوف وقهر وسعادة ونشوة. . إلخ، في صُنع لغاته التي غالبًا ما يستعير معانيها إذا شعر بالتهديد ويكون صريحًا واضحًا إذا شعر بالأمان.
من تلك الزاوية عرفنا أنه كلما كان الفقيه الإسلامي قديمًا يُكثِر من الاستعارات والمجازات والعلامات؛ كلما شجّع ذلك الباحث البنيوي لدراسة مجتمعه وحوادثه السياسية والاجتماعية وظروف هذا الفقيه النفسية، فإذا حصل الباحث على المعلومات، كان الوصول (لبنية) هذا الفقيه أو (بنية هذا النص) تحديدًا أكثر سهولة، فإذا لم تكن المعلومات متاحة سوف يجري تفكيك ودراسة هذا النص وفقًا للنهج البنيوي، فمن الباحثين من يفصل بين المجتمع الحقيقي والمجتمع الوهمي، حيث يجري تمييز هذا الحقيقي إذا توفرت المعلومات المؤكدة عنه، بمعنى أن الفقيه إذا عبر بوضوح عن أفكاره وطرح مقدماته وأسبابه التي حملته على هذا الفكر منه، سيكون من السهل معرفة حقيقة مجتمعه والعلاقة النفسية والمادية.
في حين، إذا غابت تلك المعلومات وكان الفقيه كثير الاستعارة والإلغاز يمكن اعتبار أن جانبه الأدبي ظهر تعويضًا عن ذلك المجتمع الحقيقي، فصنع آخر وهميًا له ليستمتع بآدابه وتشوّقه للتعبير أولا، ولكي ينجو بنفسه من سلطات ذلك المجتمع ثانيًا، أو يمكن اكتشاف واقعية ذلك المجتمع من شهود آخرين من خلال فقهاء آخرين معاصرين له في الزمان والمكان، أو بعلامات تاريخية صدرت من آخرين لفهم ذلك المجتمع الذي عاصره الفقيه.
الشيخ ابن تيمية الحراني مثلا والمتوفي عام 1328م/ 728هـ يمكن اعتباره من أكثر فقهاء المسلمين وضوحًا وتعبيرًا عن أفكاره؛ فالموروث عنه كتب كثيرة أشهرها “الفتاوى الكبرى ومنهاج السنة” أصبح الوصول لبنية نظام ابن تيمية أكثر سهولة؛ حيث يجري تمييزه عن أقرانه بهذا الوضوح، فقد علمنا ظروف منشأ هذه الأفكار التيمية من تأثير العامل الطائفي في زمانه ومكانه، فالرجل كان يعيش في حرّان على الحدود بين سوريا وتركيا، أي كان يعيش في منطقة جغرافية، هي محور اشتباك طائفي بين المسلمين والمسيحيين أيام الحرب الصليبية، ومحور اشتباك طائفي آخر بين السنة والشيعة، ومحور اشتباك طائفي آخر بين المغول والشرق الأوسط، ومن هذا التصور الجغرافي يمكن فهم أصول ودوافع طائفية هذا الشيخ في كثير من فتاويه وردوده العنيفة والقاسية والتكفيرية ضد الفرق والأديان الأخرى.
أما تحليل بنية خطاب ابن تيمية فيلزمه السؤال عن حقيقة تمثيل ابن تيمية لمجتمعه في عباراته، وهذا الملف الثقافي لم يُحسَم بعد. فبرغم وضوح ابن تيمية إلا أن خصومه كثيرًا ما يتهمونه بالكذب وتأليف الروايات والأخبار عن أئمتهم، فوفقًا للنَهج البنيوي يكون حقيقة تمثيل ابن تيمية لواقعه مختلفًا عن معنى هذا الواقع وتمثلاته في ذهنه، هذا لو فرضنا أنه كان حَسَن النية في عدم اختلاق الأخبار عمدًا على خصومه.
وقد كتبت في ذلك رسالة منشورة في شهر مايو عام 2020 بعنوان “حقيقة لقاء ابن تيمية بسلطان التتار محمود غازان” وصلت أن حكاية ابن تيمية عن هذا اللقاء في كتابه “الفتاوى الكبرى” كانت أكذوبة من ابن تيمية في سياق إثبات شجاعته وبطولاته، وأن هناك علامات وشواهد في التاريخ تؤكد ذلك، منها شهادة الإمام شمس الدين الذهبي المتوفي عام 748هـ في كِتابيه “تاريخ الإسلام والعبر في خبر من غبر” وقرائن تاريخية أخرى كتشيع السلطان المغولي وحرص تلاميذ ابن تيمية المخلصين – كابن كثير – على نشر هذا اللقاء والحديث عنه كثيرًا دون التحقق من صدقية المصدر.
هذا المنهج الذي استخدمته في نفي لقاء ابن تيمية هو “الفلسفة البنيوية” بتحليل بنية نص الرجل أدبيًا؛ كعبارة “ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى الإسلام؛ لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه” (الفتاوى الكبرى 28/ 618) فالمحاكاة التي فعلها ابن تيمية لهذا الحدث وهي “انتساب سلطان التتار للإسلام” فيها لفظ (انتساب) ومدلول هذا اللفظ أن ابن تيمية لم يكن يرى السلطان مسلمًا، بقرينة لغوية أخرى في ذات النص وهي ” لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه”.
بينما الذهبي ينفي هذا الكفر الضمني الذي ادعاه ابن تيمية على غازان، وكان يراه مسلمًا طبيعيًا بل صالحًا في بعض الحوادث، وكذلك المؤرخ كمال الدين ابن الفوطي في كتابه “الحوادث الجامعة والتجارب النافعة” ولولا عبارات ابن تيمية الأدبية ما شككت في صدقية كلامه أو بحثت في القصة من أصله، لكن النهج البنيوي يهتم بعبارات اللغة ومدلولاتها الذي بناء على ذلك تُفتَح فروع أخرى من العلم قائمة على البحث البنيوي كأساس.
وبشرح أكثر؛ فالاتجاه البنيوي في العلم يهتم بتفسير الألفاظ والجُمل اللغوية كأجزاء مع فهم مجتمع النص تاريخيًا وسياسًيا وأنثروبولوجيًا كأجزاء أخرى، يجري البحث عن علاقة وتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها لفهم (بنية النص العامة) ، وهذا ما فعلته مع ابن تيمية، حيث عرفنا أن مجتمع النص تاريخيًا وسياسيًا هو (طائفي)؛ بالتالي فعبارات واستعارات ابن تيمية ومدلولات ألفاظه محكومة بتمثلات هذا الواقع الطائفي في ذهنه، سيكون ذلك هو أساس البحث في فهم حقيقة عباراته في مرحلة تالية، لأن الواقع يُنتِج تمثلات في ذهن البشر كحقيقة فلسفية وتاريخية.
وابن تيمية ليس بدعا من ذلك، بل هو بشر يتأثر بهذا الإنتاج، ما بالنا وأن النص يتكلم عن مُختلِف في الدين في واقع طائفي بالأساس؟ سوف تكون الدلالة التي انتهى إليها ابن تيمية لها علاقة بتمثلات الواقع في الدال والمدلول، فالدال هنا هو طائفية مجتمع ابن تيمية، وكونه فقيهًا حنبليًا تقليديًا لم يخرج عن ثوابت وإجماعات مذهبه في الغالب، بينما المدلول هو تمثلات ذلك الدال في ذهن ابن تيمية، وهو تمثيل محكوم بميول الرجل النفسية ونزعته الطائفية وانحيازه التأكيدي.
وبالطبع فكل الفقهاء الذين قَبِلوا رواية ابن تيمية عن نفسه هم من قَبلوا أيضًا رواية البخاري عن نفسه، وأنه كان يتوضأ ويُصلي ركعتين قبل كل رواية. وهم من قبلوا أيضًا رواية الصحابي أبي هريرة عن نفسه أن كل الصحابة الآخرين انشغلوا بالبيع والتجارة والدنيا ما عدا هو الذي اهتم بالرواية، برغم أن معنى كلام أبي هريرة يمثل طعنًا فاحشًا في كل الصحابة الآخرين بمن فيهم “الخلفاء الأربعة” و”العشرة المبشرين بالجنة”.
وهؤلاء الذين قَبلوا ذلك ولم ينظروا في حقيقة تلك الروايات، هم من ينظرون إلى السيارة كمركبة لنقل الأشخاص فقط، وهي رؤية سطحية لا تهتم بأجزاء السيارة وطريقة تصنيعها، الفيلسوف البنيوي هنا لا ينظر للسيارة كمركبة فقط للنقل؛ بل ينظر لأجزائها وطريقة تفاعل هذه الأجزاء مع بعضها، فيبحث في كيفية عمل المُحرّك ضمن الهيكل والجسم والوقود والعَجلات وصندوق السرعات. . إلخ، ثم علاقة كل هذه العناصر في السيارة ببعضها بعضًا.
وبناء على هذه الرؤية البنيوية عرفنا لماذا اختلفت أشكال السيارات وسرعاتها وأنظمتها، وكيف ظهر القطار والطائرة والصاروخ، فكل هذه وسائل نقل أيضًا لكن البنيوية لم تستسلم لهذا التعريف الشمولي لكنها اهتمت بطبيعة تكوين هذا التعريف بناء على تسميته “بنية معرفية” حتى يمكن القول بأن هذا النَهَج البنيوي لو جمعناه مع التحليلي والتفكيكي سنقول بكل حسم إنه السر في التطور الصناعي والتكنولوجي الرهيب والمدهش الذي وصل إليه الإنسان في القرنين 20 و 21.
. فما من تقدم علمي واكتشافات واختراعات حدثت في هذا الزمان إلا وتأثرت بطريقة التفكير البنيوية والتحليلية والتفكيكية، وغياب هذه الرؤية قديمًا لآلاف السنين هو السر أيضًا في جمود وتخلف الإنسان رغم امتلاكه رؤية عقلية متطورة منذ عصر الإغريق، لكن العقل وحده لا يكفي، إنما الأهم طريقة استخدام ذلك العقل وطبيعة هذا التفكير في الوصول.
أختم بأن علاقة البنيوية بعلم الأنثروبولوجيا هامة لمعرفة طريقة تفكير علمائها وتصورهم للفكر الإسلامي – كمثال –؛ فالذي صنع الفكر الإسلامي كما تقدم هم مجموعات اجتماعية ولغوية مكونة من عناصر كرجال دين وحكام وأدباء وأعيان. . إلخ، هذه العناصر وفقا للأنثروبولوجي يجري تقسيمهم لقبائل وعشائر وأعراق لها تاريخ وجذور ثقافية يجب البحث عنها واستقراؤها في التاريخ.
فالذي يصنع فكر المجموعة “عشيرةً أو عِرقًا” له لغة مخصوصة تتمتع بخصائص سيميائية واجتماعية مختلفة عن الأخرى، كالعرب مثلاً؛ فهم مختلفون عن الفُرس وعن الأتراك والأقباط، هنا يجري البحث في منظومة فكر الأتراك والأقباط والفرس والعرب للوقوف على الاختلاف والتباين اللغوي والاجتماعي بينهم، ومن ثم لا يمكن تعميم فكر العربي على الفرس والعكس صحيح إذا تبين بشكل مؤكد أن هذا الفكر له خصائص محلية مرتبطة بالمكان.
ومن هذا المنظور يبحث الأنثروبولوجيون عن طريقة تصور الأعراق لدينها، فما يُنتجه الواقع المادي من تمثلات ذهنية يخلق أيضًا تعابير لغوية وتراكيب يجري فهمها بالبحث البنيوي – كما تقدم –، وأبرز مثال على ذلك آلهة العرب القديمة، فتماثيلهم كانت بسيطة نظرًا لعدم تقدم هذه القبائل في النحت، ولأن هذا المنتوج المادي في التمثال محكوم بتمثلات الواقع الهندسي البسيطة في مجتمع الصحراء في ذهن العربي.
وهو كثيًرا ما كنت أشرحه في محاضراتي وكتبي أن بدائية مجتمع الصحراء مصدرها فقر هذا المجتمع الجغرافي والطبوغرافي هندسيًا، بخلاف المجتمع الزراعي الغني بتنوع الأشكال الهندسية، مما يفسر حقيقة تاريخية هامة: لماذا ظهرت الحضارات الكبرى في مجتمعات زراعية أولا، ثم انتقلت بعض معالم تلك الحضارات لمجتمع الصحراء من أثر الاحتكاك والتفاعل؟
أما اللغة فهي ليست مجرد صوتيات ومعان للتعبير؛ بل هي إشارات إنسانية عامة يملكها أي إنسان؛ فمجتمع الصُمّ والبُكم مثلاً له إشارات لغوية خاصة، حتى الحيوانات والطيور والحشرات لها إشاراتها الخاصة
عرفنا – وفقا للمنهج البنيوي – أن هناك كلمات ومعانيَ إنسانية لا توجد في اللغة؛ بل في النفس يعجز الإنسان عن التعبير عنها بالصوت، وهناك كلمات ومعانٍ أخرى أيضًا يعجز الإنسان عن التعبير عنها حتى بالإشارة، لكنها تبقى في النفس تصنع ألفاظًا وجُملاً يقصدها الكاتب، لكنها تصل للآخرين بمعانيها الاجتماعية الشائعة، وهو ما عرفه البنيويون واللغويون المعاصرون (بالنص الميت) ، ويعني ذلك أن النص لا يتحدث بذاته، لكن يجري فهمه وفقًا لثقافة ولغة المتلقي، وهو فهم قد يكون قاصرًا عن الإحاطة بمقصود الكاتب، ومن تلك المرجعية وصل البنيويون لاستحالة واقعية ما أنتجه مفسرو الكتب المقدسة وتمثيلهم الحقيقي للنص الأصلي، وأن هذه التفاسير مجرد محاولات واجتهادات قاصرة عن إيجاد معنى النص وواقعه الاجتماعي واللغوي.
علمًا بأن تفاسير الكتب المقدسة بالماضي لم تكن مجرد محاولات بشرية فقهية؛ بل نصوص مقدسة أخرى شارحة للنص الأصلي، تسببت في صنع مذاهب وأديان خاصة نتيجة لاعتبار تلك الشروح، هي تمثيل حقيقي للدين كواقع ونصوص، ويمكن اعتبار أن أفضل ما أنتجه التفكير البنيوي هو إعادة الاعتبار للعقل والاجتهاد من جديد وإعادة فهم الأديان والنصوص بطريقة مختلفة أكثر تطورًا ودقة عما فعله الأسلاف، وأن هذا الاجتهاد الجديد سيظل كما هو مجرد تمثيل نسبي للواقع والنصوص لا يجب اعتباره عملا مقدسًا أو نسبه لله أو العلم إلا بأدلة قاطعة ومؤكدة وتجريبية لا تحتمل الشك.


!["ونزلنا عليك الكتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" [النحل: 89] وكل شيء هنا -أي من الثوابت والأركان](https://muwatin-vpn.net/wp-content/uploads/2022/07/سامح-عسكر-مقال-scaled.jpg)