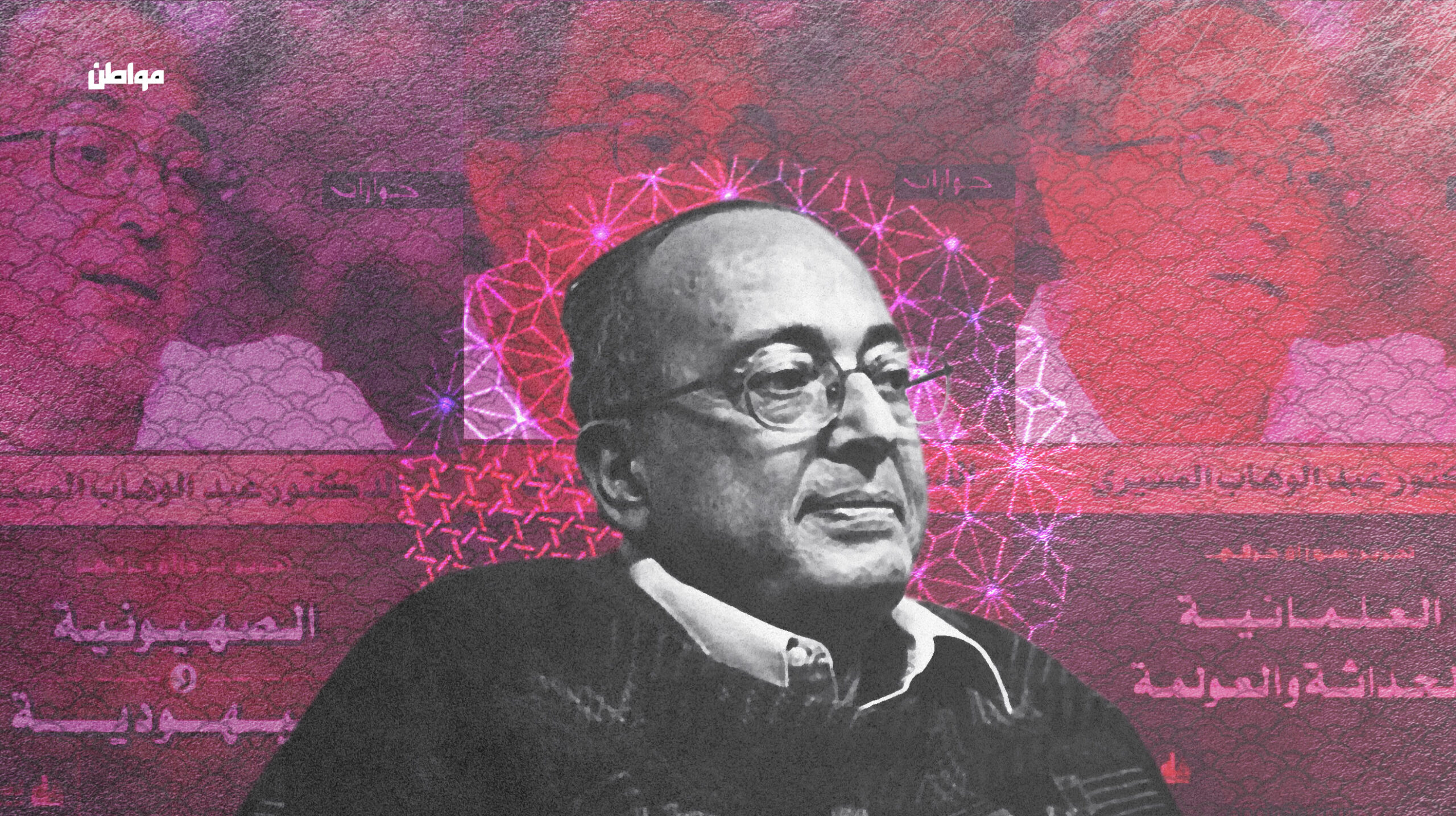حين زار محمد عبده أوروبا نُقلت عنه المقولة الشهيرة “رأيت إسلامًا بلا مسلمين وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام“، هذه المقولة أيدت رؤية مستقرة في الوجدان والعقل العربي أن الإسلام دوما براء مما عليه أهله، ليقرر “عبده” بناء على رؤيته تلك العودة إلى الأصل النقي الذي تمثل فيما حققه الغرب من تقدم، حتى يتسنى لمجتمعاتنا مفارقة حالة من التخلف استسلمت لها طويلاً.
فَصَلَ الأب البطريرك لمشروع “النهضة” بهذه العبارة البليغة الإسلام كدين عن المسلمين كمتدينين يدينون به، هناك المقدس، المفارق للزمان والمكان، وهناك المتدينون الذين يحلون في الزمان والمكان وضلوا سبيل “الدين الصحيح”، موغلين في الانحطاط، ليمتد بهم عصورًا طويلة.
تلاقت رؤى من تتبع عبده من التنويرين مع ما استقر عليه المحافظون، فتجد مفكرًا تنويريًا مثل زكي نجيب محمود، يفرّق بين الدين والتدين وعلم الدين؛ فالدين “قائم في نصوصه المحددة المعينة، ثم أتي الطرفان الآخران؛ طرف منهما متمثل فيمن يؤمنون بذلك الدين، وهم من يصفونهم بـ”التدين”، وأما الطرف الثاني فهو “علم الدين” (أو علومه) التي تقوم على تلك النصوص، وهي واقع الدين فتستخرج منها ما تستخرجه من مبادئ وأحكام”.
في حين تجد عالمًا أزهريًا تقليديًا مثل عبد الله دراز يجعل الدين “معرفة الحق الأعلى وتوقيره”، بينما الخلق (أو المتدينون) يمثل “قوة النزوع إلى فعل “الخير” وضبط النفس عن الهوى”، بذلك نحن أمام “حقيقتين مستقلتين، يمكن تصور إحداهما بدون الأخرى؛ فتختص أولاهما بالفضيلة النظرية والأخرى بالفضيلة العملية، غير أنه لما كانت الفضيلة العملية يمكن أن تتناول حياة الإنسان في نفسه، وفي مختلف علائقه مع الخلق ومع الرب، كان القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يرسم طريق المعاملة الإلهية، كما يرسم طريق المعاملة الإنسانية، وكذلك لما كانت الفكرة الدينية الناضجة هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير فعال فحسب؛ بل مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه”.
على ذات النسق تقدم عبد الجواد ياسين فأفرد لهذا الطرح مؤلف “الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع” ليعمق الفكرة ويفصلها، ومن خلال أطروحته اتفق مع دراز في أن الدين “في ذاته” يضم “الله- الأخلاق الكلية”، وإن اختلف مع الشيخ الأزهري بعدها، فأقصى التشريع من الدين “في ذاته” وألحقه بالتدين؛ على اعتبار أن التشريع “يعالج معطيات هي بطبيعة الاجتماع نسبية ومتغيرة، من ثم لا يمكن أن يكون هو “الدين في ذاته“، بينما يمكن التعرف على الدين في “مادته الخام الأولية” من خلال “مقدماتها الافتتاحية، قبل أن تنغمس في أي تلزيمات ذات مضمون تشريعي أو طقوسي”، ويمكن تتبع تلك “المادة الخام الأولية” عبر “التاريخ المتدرج للنص الإسلامي الذي قدم طوال المرحلة المكية (13 عامًا) طرحًا أخلاقيًا صرفًا”.
هذا التنويع أو العرض المغاير للفكرة الذي ضم التشريع إلى مساحة التدين؛ حيث يختص الدين “في ذاته” بـ”الله – الأخلاق الكلية” فقط، في محاولة لتضييق مساحة المطلق، لا يمنع من التساؤل حول وجاهة الفكرة في أصلها، وهي الفصل بين الدين والتدين.
في رأيي أن الفصل بين الدين والتدين، هو فصل أقرب لما يقوم به طفل حين تصحبه إلى الملاهي، فتدخله بيت الرعب ثم القطار السريع ومنه إلى السيارات المتصادمة، وحين ينتهي يسألك في سذاجة: لكن أين الملاهي التي أخبرتني عنها؟ ستضطر حينها إلى إعلام الطفل الساذج أن الملاهي ليست شيئًا منفصلاً عما لمسه ورآه، وأن هذه الألعاب المنتشرة في ترابطها وعلى تنوعها هي الملاهي، وأنه ليس هناك كيان مستقل يسمى الملاهي.
إذا كان مقبولاً من طفلنا الساذج أن يقوم بهذا الفصل؛ فليس مقبولاً من رجل بالغ راشد و”مفكر”، وإذا كان معقولاً أن يتبنى التيار المحافظ الفصل غير الجائز بين الدين والتدين؛ فليس من المنطقي أن يسايره “مفكر تنويري” في تبني فكرة رجعية ساهمت في إشعال الحروب والصراعات بين كافة الفرق والمذاهب الإسلامية على مدار التاريخ، وحرضت موجات التطرف والتعصب حتى اليوم؛ على اعتبار أن كلاً من تلك الفرق والمذاهب يحوز الكائن الخرافي المسمى بـ”الدين الصحيح” التي تحافظ أطروحة الفصل بين الدين والتدين على حضوره.
لا يُعفي ياسين من هذا النقد تضييقه مساحة الدين “في ذاته” وحصرها في “الله ـ الأخلاق الكلية” وذلك من أجل الخروج بنتيجة متواضعة ولعلها هزيلة؛ هي أن التشريع لا ينتمي إلى تلك المساحة المطلقة، رغم أن الواقع تجاوز بدرجة كبير الحاجة لهذا التنظير، وهو ما يثبته ياسين نفسه، حين يدلل على أن الشريعة لا تنتمي إلى مساحة “الدين في ذاته” ليكتب: “ألم يفرض الواقع الاجتماعي المتغير على شريعة القرآن، مثلما فعل في شريعة التوراة، أن تتنحى عن هيمنتها التاريخية في المجتمعات الإسلامية مع ظهور الدولة الحديثة؟”، وهذا الأمر -التنظير لواقع تجاوز ما كُتب له- شيء يشترك فيه كثير من “مجددي” التيار الإسلامي.
يستمر عبد الجواد في نفي ما يثبته، حين ينقل رأي فيتغنشتاين ـ دون إحالة ـ من أن اللغة “آلية اجتماعية”، ولا ينتبه “المفكر التنويري” إلى نقل يفند الفكرة في أصلها؛ فإمكانية الفصل الذي يقره “المفكر التنويري” في طرحه تنتفي وفق ذلك؛ لأنه لا وجود لـ “الدين في ذاته” خارج اللغة التي هي مثلما ذكر ياسين “آلية اجتماعية“، وفي موضع آخر “كائن اجتماعي تاريخي” لا يمكن تصور حضوره خارج عمليات التواصل الإنساني أو بعيدًا عن تاريخ معاملاتنا وتجاربنا في استعمال الكلمات والعبارات، واللغة بذلك ليست حالة عقلية نقوم من خلالها بتصوير الواقع والمعاني المختلفة؛ لأن حدود التفكير هي حدود اللغة، من هنا لا يصح ما ذهب إليه ياسين من أنه نتيجة لتفاعل الاجتماع مع الدين بمجرد حلوله في الاجتماع يصبح هناك “صعوبة في الإمساك باللحظة الافتراضية التي يمكن عندها معاينة الدين مفارقًا للاجتماع أو سابقًا عليه”؛ فهذا “الإمساك” لا إمكانية لتحققه مطلقًا، لأن لغة النص هي “مؤسسة اجتماعية” جرى تشييدها داخل الزمان والمكان لتتطور وفق استعمال المجتمع الإنساني لمفرداتها وتراكيبها.
وإمعانًا في التناقض يورد ياسين هذه الفقرة العجيبة في صياغتها: “يعني ذلك أن الفهم الناجم عن ملامسة النص ينبصم ببصمة الذات مرتين؛ الأولى عند (تلقيه داخل الذات) ، ولدى التعبير عنه (تعديته خارج الذات)؛ إذ لا يكون “الشيء في ذاته” بعد دخوله الذات وخروجه منها هو الشيء في ذاته؛ بل هو الشيء من منظور الذات المدركة”.
السؤال هنا: من أين لياسين إذن هذا التخييل؛ أن تكون هناك إمكانية للفصل بين "الدين في ذاته" وإدراك الذات له؟!
فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد لعبة لغوية، لا إمكانية لتحققه إلا على مستوى اللغة، فحين يُعرفنا عبد الجواد نفسه على مفهوم الدين “في ذاته” فهو يعرفنا على إدراكه له، ذلك ما يثبته هو نفسه في الفقرة السابقة، ثم نجده بعد ذلك يضع المعايير والضوابط لتمييز “الدين في ذاته” عن التدين، ويقدمها كأنها معايير وضوابط في ذاتها، لا مجرد معايير وضوابط أو صورة ذهنية تشكلت في ذهن عبد الجواد ياسين محاولاً إلزامنا بها.
نستنتج من ذلك كله، أنه لا وجود لتلك المساحة الفاصلة المتخيلة بين الدين “في ذاته” والتدين؛ حيث لا إمكانية لتحقق هذا الفصل الذي يزعمه “مفكرنا التنويري”، مثلما لا إمكانية للفصل بين الملاهي ومكوناتها أو ألعابها المختلفة على اعتبار أن الملاهي كيان مستقل كما تخيله طفلنا الساذج.
أطروحة ياسين ـ بما أنه هو من اعتنى بتعميق فكرة الفصل بين الدين والتدين ـ هي الأغبى والأكثر هشاشة، توصيف يتناسب طرديًا في عنفه مع سذاجة الفكرة، إلى جانب دور خطير لعبته؛ فالفصل بين الدين والتدين الذي سعى عبد الجواد لتثبيت ركائزه، مسؤول بدرجة كبيرة عن صراع وحروب خاضتها الطوائف والمذاهب الإسلامية عبر تاريخنا، كذلك عن موجات تشدد وعنف لا تنقطع، على اعتبار أن كل فرقة أو مذهب أو تيار أو مؤسسة تدعي حيازة الكائن الخرافي المسمى “الدين الصحيح”، حيازة تشرعن كل عنف وتطرف وتعصب وإقصاء للآخر، لكن المزعج في حالتنا ـ علاوة على ما سبق ـ أن ياسين يسوق هذا الطرح تحت يافطة التجديد والتنوير أمر يدعو إلى مراجعة؛ ليس فقط ما يطرحه نموذج كهذا؛ بل عديدًا من الأطروحات التي ترفع ذات اليافطة؛ فكثير منها لا نصيب له من المفهوم إلا اللفظة.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.