انشق المسلمون بعد وفاة الرسول لمئات الفرق السياسية والفقهية والعقائدية، كل فرقة تنسب لنفسها الفهم الصحيح للدين واتباع الرسول، بينما تنكر على الأخرى لدرجة وصفها؛ إما بالكافرة أحيانًا أو المبتدعة أو الخاطئة، والوصف الأخير عزيز نوعًا ما في التاريخ الإسلامي؛ إذ الغالبية العظمى من خلافات المسلمين حدثت تحت عنوان (الكُفر والبدعة) ولم يكن المسلم منفردًا في هذا المصير عن العالم؛ بل هو سلوك فطري داخل كل دين ومذهب، شرحت معالمها في السابق بنظرية الدين بين الطبيعة والتحدي.
تنقسم مراحل أي فكرة ودين لثلاثة مراحل تاريخية، الأولى وهي مرحلة النشأة التي توضع فيها كل ثوابت وكليات الفكرة/ الدين، ثم مرحلة الصراع التي يتصارع فيها خلفاء المؤسسين على جوهر الفكرة بمرحلة النشأة، ثم مرحلة التقليد التي يُقلد فيها الأتباع جيل المتصارعين؛ إذ لا يمكنهم تقليد جيل المؤسسين لانقطاع الصلة والرابط الفكري والجغرافي أولا، والانقطاع التاريخي وبُعد الزمن ثانيًا، ومن هذه النظرية خلصنا لنتيجة مؤكدة تقول إن مذاهب التقليد في أي دين هي تقلد المتصارعين في الواقع بعد موت المؤسس وانقضاء جيل النشأة، ولا يمكنها – واقعيًا – أن تقلد أو تفهم جوهر فكرتها الرئيسية، ومن هذه النتيجة كانت هناك حاجة دائمة للعقل والتفكر يمكنها الفصل بين ما هو أساسي وتقليدي، وبين ما هو جوهري وفرعي، وبين ما هو ثابت كلي ومتحرك جزئي.
من هذه الأجواء خرجت فرقة المرجئة الإسلامية؛ فقد ظهرت بعد موت مؤسس الإسلام مباشرة؛ وهو الرسول محمد – عليه السلام –، ثم نسبت ما تقوله للرسول، وأنه الفهم الصحيح للدين الإسلامي، ولأن الفهم البشري للأفكار نسبي. اختلف البعض معهم واتهموهم بالضلال والابتداع، وحدوث هذا الاختلاف طبيعي نظرًا لأن كل مجتمع يخلق في ظروف معينة (أصنامًا اجتماعية وسياسية) له بشكل تلقائي، وتلك الأصنام هي التي تمنعه من المعرفة الموضوعية، وتخلق بينه وبين الحقيقة حواجز تعوق تفكيره بشكل سليم، مع العلم بأن نفوذ تلك الأصنام دائمًا يكون متعلقًا بالقوة؛ سواء العسكرية والسياسية أو الخطابة والكاريزما، وهذه الأمور لا علاقة لها بالمعرفة؛ بل قدرات اجتماعية للفرد والمجموعة، إذا تحققت امتلك هؤلاء القدرة على التأثير وتشكيل المجتمع وفقًا لأهوائهم ومصالحهم وصراعاتهم.
من هنا فهمنا أن مذهب المرجئة لم يملك أتباعه القوة السياسية والعسكرية أو الخطابة والكاريزما في الزمن الأول، مما أدى لانقضائه سريعًا وعدم تمكنه من الحُكم وتشكيل قناعات الشعب وفقًا لمذهب مؤسسيه، وأن هؤلاء المرجئة الأوائل، حتى لو امتلكوا القدرة على المعرفة الموضوعية والتفكير السليم والفهم الصحيح للدين الإسلامي، لكن وبفقدانهم القدرة السياسية والعسكرية والخطابية ظلوا في الجانب الآخر من التاريخ، مجرد معارضة مشاغبة أو فرقة مبتدعة كل همها الانقلاب على الحُكم، وأن زعماءهم زنادقة يهدفون للقضاء على الإسلام، برغم اعتراف الجيل المتأخر من المسلمين بإسلام المرجئة وأنهم لم يكونوا كفارًا، لكن القارئ لكتب التاريخ – السني والشيعي – يرى شيئًا آخر؛ وهو أن بعض زعماء المرجئة قتلوا بتهمة الردة والبعض الآخر تم تكفيره علانية.
اسم “المرجئة” من الإرجاء؛ أي التأخير والإمهال كما في قوله تعالى: “قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين” [الشعراء : 36]؛ فمعنى كلمة “أرجه” هنا يعني أخره وأمهله، ويكون معنى المذهب هو تأخير الحكم على الناس للآخرة، وعدم الجزم بكفر وإيمان أحد في الدنيا، وهو ما يتفق مع قوله تعالى: “وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم” [التوبة : 106] وبهذه الفرقة القرآنية قال زعماء المرجئة الأوائل بعدم كفر مرتكب الكبيرة، ومن السياق التاريخي تبين أن أول خلاف حدث بعد موت الرسول كان بين (المرجئة والخوارج)؛ فالأولى تثبت إيمان مرتكب الكبيرة، والثانية تقول بكُفره، وعليه كان الدافع الأساسي لتكوين مذهب المرجئة هو (عدم تكفير المسلمين)، لما يترتب على ذلك من أحكام وهي الحرب والقتال، لأن الكافر وفقًا للفقهاء ليس فقط هو غير المسلم؛ بل هو الذي لا يدفع الجزية ولا يؤتمَن ولا يُعاهَد.
فتعريفات الفرق خرجت في ظل وضع سياسي معقد، كان فيه العرب يغزون الأمم المجاورة، وينسجون مصطلحاتهم الدينية بناء على السياسة، وبرغم أن المشترك كبير بين المرجئة وأهل السنة، فكلاهما يقول بإيمان مرتكب الكبيرة ورفض تكفير الأعيان، إلا أن الخلاف الكبير بين المذهبين كان بفعل السياسة ولجوء كثير من الحكام لتكفير معارضيهم بغرض حشد الجنود.
وهنا لمحة هامة يجب ذكرها لشرح فرقة المرجئة وأجواء تشكلها؛ وهي أن الدولة العربية الإسلامية الأولى كانت مترامية الأطراف وواسعة النطاق، فكانت تحكم ملايين الكيلومترات المربعة، مما يُصعّب جدًا من قدرة الخليفة على السيطرة، لبُعد المسافة أولا، ولتخلف نُظُم الاتصالات ثانيًا، وبدائية وسائل السفر ثالثًا، ومن هذه الأجواء كان من الصعب أن يجبر الخليفة شعبه على التجنيد إلا بالتأثير على شعوره وعواطفه الدينية تجاه الأعداء، فكان لزامًا على الخليفة أن يحكم بكفر معارضيه الذي أراد غزوهم؛ وبالتالي كان حشد الجنود من القرى والمدن البعيدة أكثر سهولة لرغبة هؤلاء الجنود أن يظفروا بالجنة والحور العين، وهذا لن يتحقق لهم بالطبع فيما لو كان العدوّ مسلمًا، لأن القاعدة القرآنية تقول: “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين” [الحجرات : 9]
مما يعني أن عدم تكفير الخليفة لمعارضيه سيجعل من هؤلاء الجنود (بغاة ومعتدين)، يجب على المسلمين كافة أن يجتمعوا على حربهم لإيقاف البغي الذي صنعوه، فكان تصرف الخليفة تلقائيًا بتكفير معارضيه لحشد هؤلاء الجنود عاطفيًا.
لكن وفي ظل هذه الأجواء كان فقهاء المرجئة يرون ما يحدث وهم معترضون، لأن ما فهموه من القرآن خلاف ذلك، وأن الله لا يرضى بتكفير المسلمين وفقًا لتصورهم، فكانوا يخرجون في المساجد معلنين إيمان الأعداء والمعارضين، ويحذرون الجماهير من سياسة التكفير التي اشتهر بها الخوارج، وبالطبع ستكون ردة فعل الخليفة هي قمعهم واضطهادهم ظنًا منه أنهم (خونة وعملاء)، وهذا ما كان يحدث ضد أي من يرفض تكفير المعارضين بالمجمل، حتى لم يسلم من ذلك فقهاء لم يُعرفوا بالإرجاء؛ بل اتهموا به، ومنهم أئمة مسلمون كبار؛ (كأبي حنيفة النعمان – وسعيد بن جبير – ومقاتل بن سليمان – ومحمد بن شبيب.. وغيرهم) مما يعني أن الإرجاء وصل في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي لكونه (تهمة) وليس فرقة بحيالها، لها زعماء وأمراء، وهذا التصور الأخير كان خياليًا محضًا؛ فلم تكن المرجئة أبدًا فرقة لها زعماء وأمراء وحشود وجنود؛ بل كانت منذ بداياتها (خيارًا فقهيًا) يرفض تكفير المسلمين، ثم تحولت (لتُهمة) يطارد بها كل مفكر وكل معارض للخليفة.
إن الناظر لأحوال فرقة المرجئة يجد صمت الفقهاء المسلمين – سنة وشيعة – عن ذكر زعمائهم، حتى أنه يصعب جدًا على الباحثين مثلي استنتاج أسماء مؤسسي هذه الفرقة، وهذا يثبت أنها كانت خيارًا فقهيًا أكثر من كونها فرقة معروفة، وبالتالي هي اجتهاد علمي صدر من عدة فقهاء وصحابة، ظل فترة من الزمن مقبولاً لمقاومة الخوارج، لكن وبعد أن ضعف الخوارج بعصر عبدالملك بن مروان وسيطرة أبنائه على الحكم، دارت الدائرة على المرجئة ومن يقول بأقوالهم، وهذا تفسير لكيفية ظهور اتهامات الإرجاء في التاريخ الإسلامي؛ فقد بدأت مع حقبة عبدالملك بن مروان في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، ثم استمرت طيلة الفترة المتبقية من العصر الأموي وطيلة العصر العباسي، ولولا أنها كانت خيارًا فقهيًا تبناه بعض كبار الصحابة ضد الخوارج، لذكر زعماء ومؤسسي هذا المذهب بكل ارتياح، لكن صمت الرواة والقصاصين عن ذكر فقهاء المرجئة -بالاسم- في عصر الخلفاء الراشدين، ثم معاوية وولده لهو لدليل على أن بعض الصحابة الكبار قالوا به.
ويعترف الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه “تاريخ المذاهب الإسلامية صـ 118” أن بعض كبار الصحابة الأوائل عرفوا بالإرجاء، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين.. وغيرهم، حتى إن المؤرخ ابن عساكر سماهم (بالشُكّاك) ومن تلك المرجعية انقسم فقهاء السنة لتسمية المرجئة إلى (مرجئة أهل سنة) و(مرجئة بدعة)، في محاولة منهم لتفسير هذا الغموض والصمت الغريب عن مؤسسي الإرجاء الأوائل، وقد نسبوا مرجئة السنة لأبي حنيفة خشية أنصاره؛ فلو قالوا مرجئة بدعة لاشتعل الصراع الطائفي مثلما اشتعل في محطات كثيرة بالتاريخ الإسلامي، وتنقل كُتب الرواة والمؤرخين لنا مشاهد وصراعات كثيرة بين الأحناف وغيرهم لهذا السبب؛ مما دفع بعض الفقهاء من ذوي الاتجاهات التقريبية والتوفيقية للصلح بين المتخاصمين واختراع أقوال للأئمة (مالك وابن حنبل والشافعي) تمدح أبا حنيفة، وهي كلها أقوال مخترعة مكذوبة ظهرت في حقبة زمنية تميزت بالصراع الطائفي، وبداية رصد هذه الكلمات المادحة لأبي حنيفة منذ القرن الخامس الهجري وما قبل هذا الزمن، كانت كتب التكفير والهجوم على أبي حنيفة بالعشرات، وأكثرها لعلماء أهل الحديث والحنابلة بالخصوص. (راجع مقالي المنشور عام 2015 بعنوان “طعن علماء السنة في الإمام أبي حنيفة” مدعوما بالمصادر.
من ناحية أخرى؛ فتسمية المرجئة عليها خلاف، فالبعض ينسب هذا الاسم لمن قال (بتأخير نصب الإمام لاختيار الأمة)، وبالتالي فالإمامة لديهم ليست نصية، وهذا ما فجر الشقاق والصراع بين الشيعة والمرجئة، ثم تطور لاحقًا لتكفير صريح شيعي للمرجئة بسبب عدم قولهم بكفر يزيد بن معاوية، وتنقل كتب الشيعة أن الإمام الصادق لعن القدرية والخوارج مرة واحدة، لكنه لعن المرجئة مرتين بسبب قولهم بإيمان قاتلي الإمام الحسين في كربلاء. والحق يقال؛ إن موقف المرجئة من عدم التكفير هو موقف (مبدئي) وليس سياسيًا، لكن الآخرين لا يفكرون بهذا الشكل؛ إذ يغلب عليهم الطابع السياسي في تصور عقائدهم الدينية.
فالمرجئة مثلما قالوا بإيمان يزيد بن معاوية، قالوا أيضًا بإيمان الحسين، الذي يوصف في الأدبيات الأموية بالمارق الخارجي، وكان يُسبّ ويُلعن على منابر الأمويين حتى زمن الخليفة "عمر بن عبد العزيز".
ومن المأثور أيضًا عن الإمام الرضا أنه لعن المرجئة وأبا حنيفة لقولهم إن القرآن مخلوق، وعن الإمام الصادق أيضًا في كتاب الكافي قوله: “بادورا أحداثكم – يعني أطفالكم – بالحديث قبل أن يسبقكم إليه المرجئة”. وهذان القولان عن الرضا والصادق يتضمنان بعض الإشارات حول تهمة الإرجاء في القرن 2 هـ، والراجح فيها أن فقهاء المرجئة في هذا العصر كانوا يجمعون بين عقائد واتجاهات شتى؛ من بينها الاعتزال الذي اصطلح عليه في هذه الحقبة الزمنية (بالقدر)؛ فكان الفقيه يقول بخلق الإنسان لفعله ليقاوم عقيدة الجبر، وفي ذات الوقت يرفض تكفير الناس والحكم على مصائرهم في الآخرة، وهاتان الصفتان اجتمعتا في المفكر المغدور (غيلان الدمشقي) المتوفي عام 106 هـ بعد مناظرته الشهيرة أمام الإمام الأوزاعي، فما كان من الخليفة الأموي “هشام بن عبدالملك” إلا أن أصدر عليه حكمًا بالإعدام مع تسفيه أقواله وتكفيره بين فئات الشعب، ومنذ هذا التاريخ عُرف غيلان وسط الفقهاء (بالقدري) تارة، و(المرجئ) تارة أخرى، لكن الوصف الأول اشتهر عنه في كتب التاريخ لأسباب تتعلق بمجهولية زعماء المرجئة، وميول الرواة للصمت عن تحديد أسمائهم أو القطع بهم لأسباب غير معروفة.
لكني اجتهدت هنا في بيان دوافع وأسباب هذا الصمت الذي يؤكد أن بعض كبار الصحابة الأوائل قالوا بالإرجاء؛ مما دفع فقهاء السنة للتفريق بين مرجئة السنة ومرجئة البدعة، ثم نسبوا الأول لبعض الأئمة والصحابة، ونسبوا الثاني لشخصيات مجهولة الاسم، لكن العقال افلت منهم، ووسط ركام من الروايات اضطر بعض الرواة للبوح بأسماء زعمائهم؛ مثل الإمام أبي حنيفة النعمان؛ مما أدى لتفجير بعض الصراعات الطائفية التي أشرنا إليها منذ قليل.
نقطة هامة في فكر المرجئة، وهي (تسامحهم الديني)؛ فالأصل لديهم أن الإيمان يتحقق بالإقرار القلبي والقناعة الفكرية، وهذا يمثل الصلة والرابط بين العبد وربه، أما غير ذلك من سلوكيات خير وشر فيُحاسَب الإنسان عليها في الدنيا وفقًا لقوانين وأعراف المجتمع، لكن لا يمكن الخلط بين العلاقتين أبدًا؛ فلا يجوز الخلط بين صلة العبد وربه، وبين صلة العبد مع أخيه، والقرآن وفقًا لتصورهم يفصل بين الاثنين بشكل واضح، كما في قوله تعالى: “إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” [النساء : 48] فالإيمان – الذي هو نقيض الشرك – هو تصور عقلي وقناعة قلبية وارتياح نفسي بوحدانية الله، وما دون ذلك من سلوك بين العباد وربهم، يمكن التسامح فيه وغفرانه، ما دام الله قد جعله من الأمور مُحتملة الغفران، وهذه الفكرة كانت عدائية للغاية ضد فريقين اثنين:
- الأول: الفريق الجبري الذي يرى أن مجرد الاعتراض على أفعال الخلفاء والأمراء هو اعتراض على إرادة وأفعال الله؛ مما يستوجب حكمًا قاطعًا بالكفر على صاحبه، فهذا الفريق لم يكن يفصل بين ما هو خاص بين العبد وربه، وبين ما هو خاص بين العبد وأخيه، وهؤلاء الذين لصقوا تهمة الإرجاء لزعماء المعتزلة كغيلان الدمشقي مثلما تقدم.
- الثاني: أهل الحديث الذين بنوا معتقداتهم على الرواية، وهؤلاء كانوا يبنون تصورهم للخالق على كلام بشر وصراعات بشرية بين الرواة وبعضهم؛ فلم يكونوا يفرقون بين علاقة العبد وربه وبين علاقة العبد وأخيه، فوسط هذه التلال الكبيرة من الروايات، ترسخت عقائد أهل الحديث أن الدين والسياسة واحد، مما يعني أن فكر المرجئة كان أول محاولة علمانية للفصل بين الدين والدولة في التاريخ الإسلامي، ويتأكد ذلك من ظهورهم لأول مرة على مسرح الأحداث لمقاومة فكر الخوارج التكفيري، الذي كان يرى أن الدولة والدين واحد، وأن حكم البشر لله؛ فكان المرجئة يردون عليهم أنه لابد للناس من أمير، وأن الإمام هو مجرد وكيل للناس يعمل على مصالحهم وليس إلهًا مختارًا من السماء.
ومن تلك الزاوية لا يمكن الاطمئنان لبعض الأقوال المنسوبة للمرجئة وهم منها براء؛ فالثابت أن التاريخ الإسلامي يخلو من كتب المرجئة، ولا تفصيل عقائدهم أو حتى معرفة أسماء زعمائهم، ومن ثم كان نسب الأقوال المكذوبة لهم عملاً مفضلاً عند فقهاء السنة والشيعة في سبيل إعلاء مذاهبهم والترويج لأنفسهم على طريقة رجل القش، وهي طريقة تعني اختراع (صنم وهمي)، ثم رميه بالحجج العقلية والمنطقية، بينما في الواقع هذا مجرد صنم وهمي، وأن بعض الأقوال المنسوبة للمرجئة لا تستقيم مع خطهم الفكري وسياق وجودهم التاريخي وتصور ردود أفعالهم مع مخالفيهم.
من تلك الأقوال مثلا نسبهم للمرجئة قولهم: “لا تضر مع الإيمان معصية، ولا ينفع مع الكفر طاعة” وحقيقة هذا القول أنه صدر من تكفيري يرى مشروعية تكفير الناس على أعمالهم وأقوالهم أو على كبائرهم، وحين نتصور ردة فعل المرجئة بناء على مذهبهم الذي شرحناه عاليه؛ فالرد الطبيعي (أنه لا شأن لنا بإيمان وكفر الناس، وما يشغلنا فقط هو قوانين الدنيا وأعرافها ومصالح البشر)؛ فالله وفقًا لتصور المرجئة قد أرجأ حساب الناس في الآخرة، وأنه لا اعتبار لتسمياتهم في الدنيا وفقًا لقوله تعالى: “إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابؤون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ” [المائدة : 69] مما يعني أن الفقيه المُرجئ كان يتحاشى الجواب عن هذا السؤال بالأساس لعلمه أنه سؤال خطأ مبني على فرضية مسبقة بضرورة تكفير الناس على أعمالهم وكبائرهم، وهو اتجاه خارجي، نشط زعماء المرجئة الأوائل في مكافحته عقب موت الرسول، أو تورط بعض ضعاف العقول من المرجئة في الرد بهذا الجواب؛ فتم تعميمه على كل المرجئة وفقًا للتعميم الملحوظ والمتبع في نسب الأقوال الضعيفة للمخالفين.
وهذا يستوجب منا البحث في صدقية مقولة أخرى شائعة عن المرجئة وهي: ” إن الإيمان قول بلا عمل“، وهي على نفس الشاكلة من الأقوال الضعيفة المختزلة التي شنع بها الفقهاء على المرجئة واستنتجوا بأن الإرجاء يقول بأن (إيمان الأنبياء مثل إيمان الفساق وأهل الكبائر)؛ حيث إنه وبمحاكمة بسيطة لمذهبي السنة والشيعة، نجدهم يقولون بنفس المقولة؛ وهي: “إن الإيمان قول بلا عمل، وبالتالي إيمان الأنبياء مثل إيمان الفساق وأهل الكبائر” وفقًا لتصور مسبق بعدم تكفير هؤلاء مرتكب الكبيرة، ولا يشفع لهم القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن هذه القاعدة تعني أن هناك معصية سوف يصل فيها المسلم لحد الكفر، إذا قلنا (بحد الإيمان)، وهذا عين مذهب الخوارج حين قالوا بأن الكبيرة هي حد الإيمان وحصولها في النفس يعني خروجًا عن الحد وبالتالي الكفر.
كذلك فقول الفقهاء بأن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إن إيمان النبي مثل إيمان الفاسق، لأن (كليهما إيمان) من حيث الوصف، ولكنهم يختلفون في الدرجة، وهذا ما عابوه على المرجئة في كتبهم دون مناقشة تبعات هذا القول، أو يحللوه بشكل عقلي صحيح، وعليه نرى أن تلك المقولات صدرت من تكفيري يرى كُفر المعارضين السياسيين أو مرتكب الكبيرة، مما يدل على أن كثيرًا من فقهاء السنة والشيعة الأوائل تبنوا مذهب الخوارج دون دراية منهم للرد على المرجئة. وقد ورثت الجماعات الإرهابية هذه التلال الكبيرة من الروايات، وفهموا منها تكفير المعارضين والمخالفين بالرأي؛ فحين يكتشف تلاميذهم هذا التناقض يجتهدون في بيان شرح التفريق بين مرجئة السنة ومرجئة البدعة، ثم، وفي مرحلة لاحقة يبتكرون (موانع التكفير) التي بالنظر فيها نجدها أدلة المرجئة في عدم تكفير المسلمين بالأساس.
وهذه أحد آفات الفكر الديني المتشدد؛ حيث وباضطهاد المرجئة شاع سلوك التكفير بين الفقهاء، فتورط الشافعية في تكفير الأحناف وإمامهم والعكس. وهذا تفسير لظهور بعض الأحاديث التي تحذر من أبي حنيفة والشافعي منسوبة للرسول، فبرغم تضعيف علماء الحديث لتلك الروايات لاحقًا؛ إلا أن رواجها في زمن ما ومكان ما، أنتج رواسب وتراكمات تكفيرية أدت لانفصال وجداني بين المسلمين، هو الذي أنتج في حقب زمنية تالية هذه الصراعات الطائفية التي حكت بعضها كتب التاريخ ونقلت مشاهدها المؤلمة كأننا نرى عملاً سينمائيًا حربيًا في القرون الوسطى، لأسباب تافهة صغيرة تشبه حرب البسوس، وما كان هذا ليحدث لولا اضطهاد المرجئة وتكفيرهم أو الحكم عليهم بالبدعة، ونسب الأقوال المغلوطة على زعمائهم دون بيان، أو عدم دراسة كيفية نشوء وارتقاء هذا المذهب الإسلامي كيف تكون وأسباب ظهوره وعوامل ضعفه وقوته بموضوعية.
ولمن يدعي أن فقهاء السنة والشيعة لم يُكفّروا المرجئة؛ فأين نضع أحاديث (لُعِنَت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيًا) ، و(القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة) و(صنفان من أمتي ليس لهم من الإسلام نصيب؛ المرجئة والقدرية)؛ فهذه الأحاديث المنسوبة للنبي خرجت في ظل صراعات سياسية كما قلنا، بدأت منذ حقبة عبد الملك بن مروان، ونجاح الدولة الأموية في السيطرة عقب الخلاف الشهير بين الفرع المرواني والفرع السفياني بعد موت يزيد، فخرج المفكرون للاعتراض على تكفير المسلمين وحشد الجنود بناء على الدين والعقيدة ضد قبائل مؤمنة كما يراها المفكر، فكانت النتيجة تكفير هؤلاء المفكرين ووصفهم بالقدرية والإرجاء، ثم اغتيالهم وقتلهم فيما بعد، وهي صفات متشابهة لحد كبير في معنى القائل، أو كما يقال (المعنى في بطن الشاعر)؛ فالدمج الذي حدث بين الفرقتين (المرجئة والقدرية/ المعتزلة) لم يكن ليحدث لولا أن هاتين الفرقتين كانت تجمعهما صفات كثيرة مشتركة؛ كالحرية في الاختيار، وخلق الإنسان لأفعاله وعدم تكفير المسلمين والبعد عن تكفير الأعيان وخلافه.


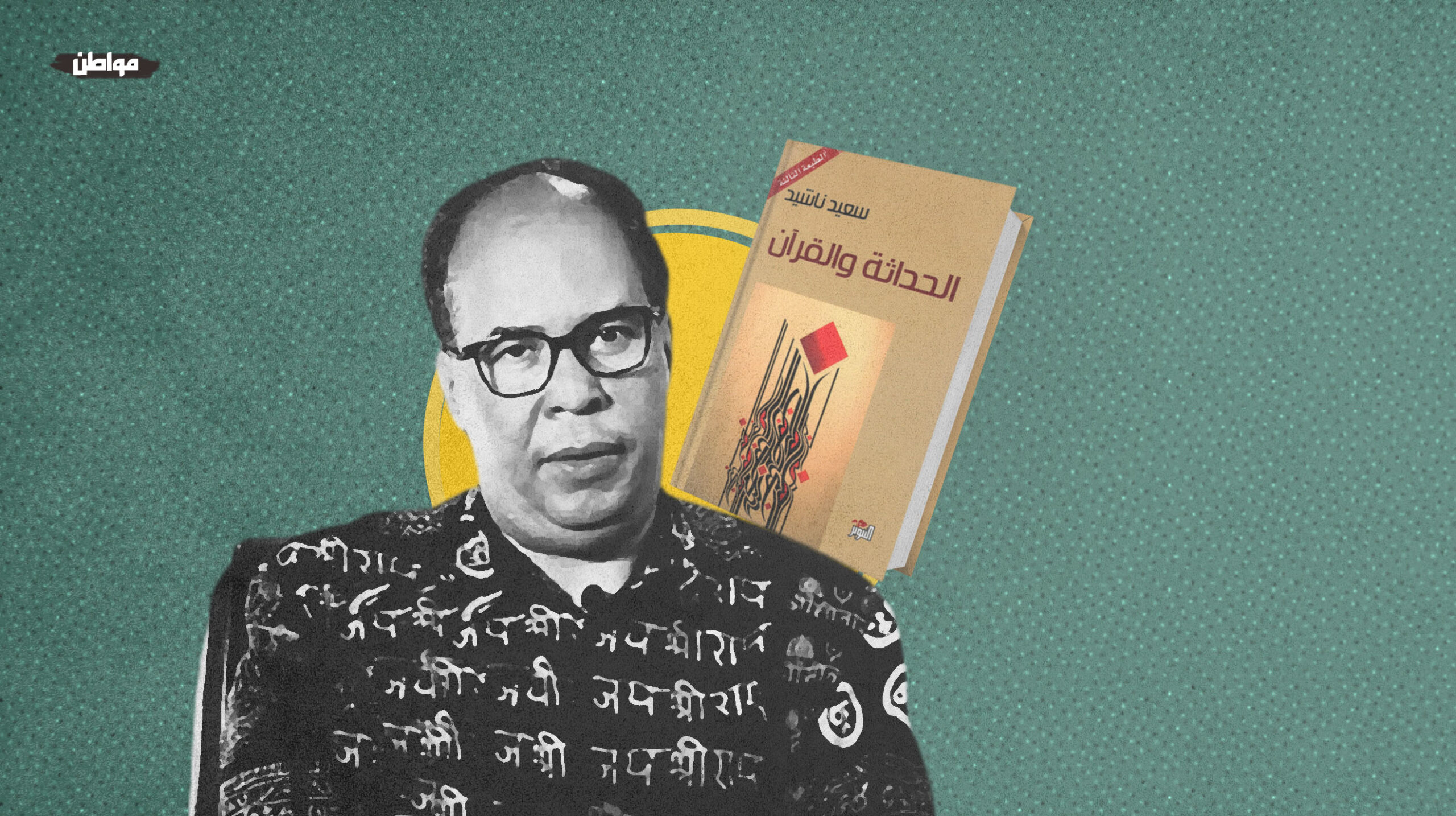
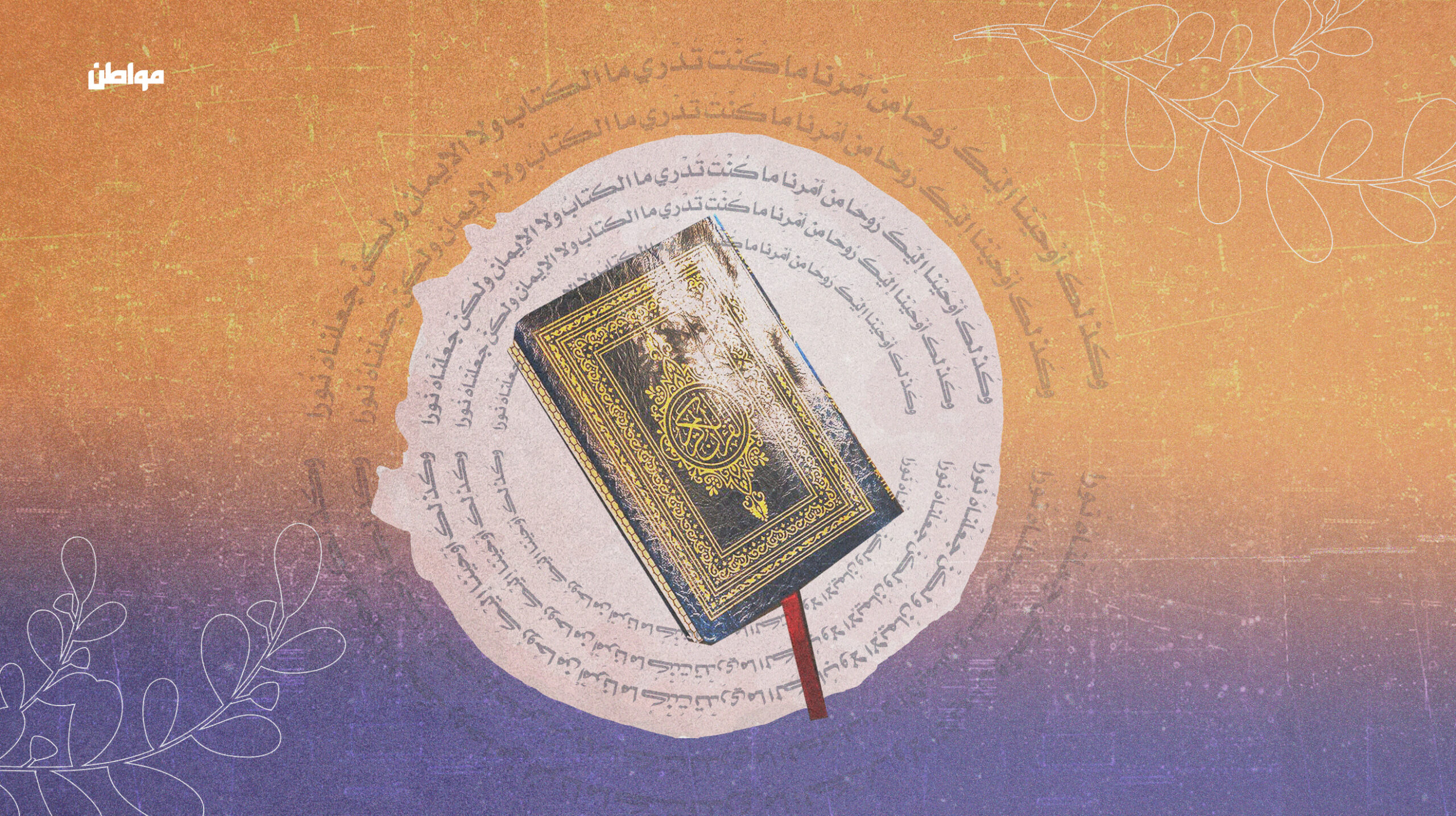
!["ونزلنا عليك الكتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" [النحل: 89] وكل شيء هنا -أي من الثوابت والأركان](https://muwatin-vpn.net/wp-content/uploads/2022/07/سامح-عسكر-مقال-scaled.jpg)



