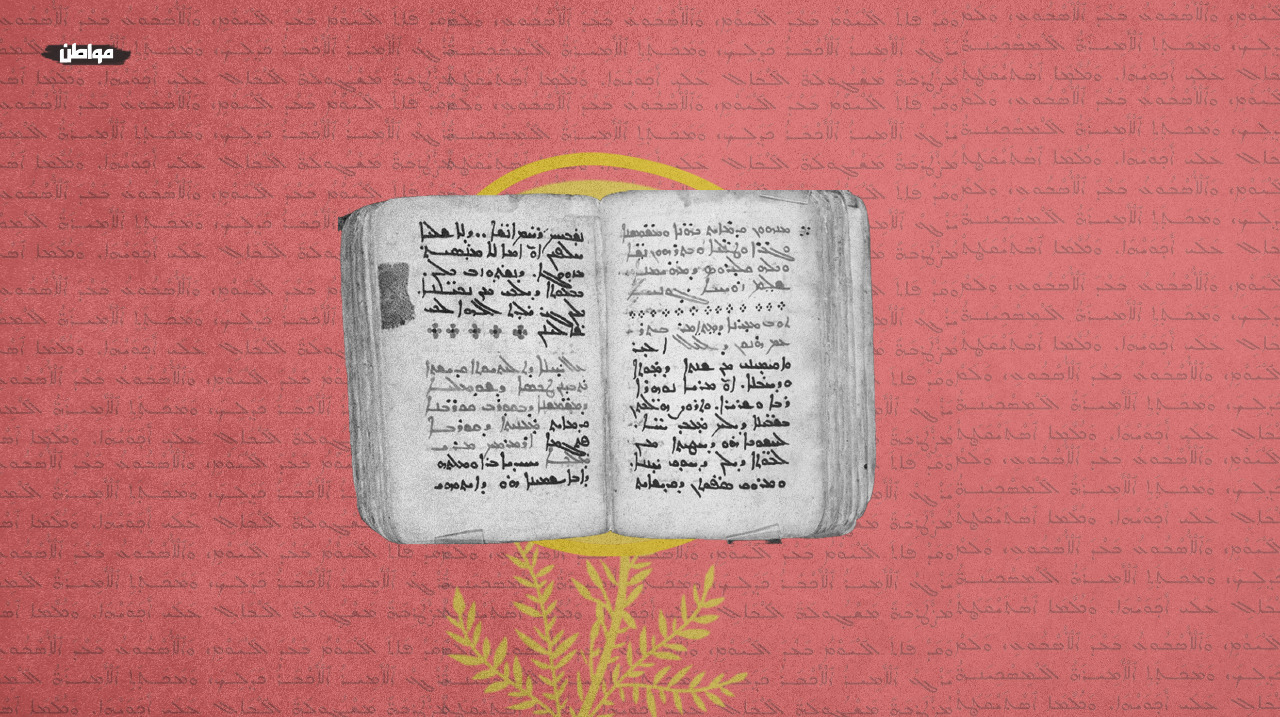تمثل ظاهرة الاستشراق أحد أكبر المعضلات في الفكر الإسلامي الحديث، ليس لأنها خرجت فقط من بطن دول الاستعمار الأوروبي ولكن لكيفية تناولها للتاريخ والفكر الإسلامي غير المسبوقة التي اعتمدت مناهج جديدة في التفكير لم يألفها المسلمون ربما منذ عصر المعتزلة ، ومن ثم أضحت هذه الظاهرة هدفا لسهام الطعن والتشويه والشيطنة لكل الحركات الأصولية والمحافظة في المجتمع الإسلامي والتي رأت طريقة تناول المستشرقين للإسلام ومجتمعاته والشعوب الشرقية بالعموم ليست نزيهة ويشوبها العوار وسوء النوايا.
الاستشراق هو حركة ثقافية أوروبية ظهرت في القرن 19 م كتيار يميل لدراسة مجتمعات الشرق الآسيوي والأوسط تحديدا دون أي مجتمعات أخرى، وبالتالي هي لم تدرس أو تهتم بالحالة الأفريقية أو اللاتينية أو الأوروبية ، فقامت على دراسة مجتمع العرب وفارس والهند والصين وجنوب شرق آسيا..أي لم تكن الحركة موجهة فقط للمسلمين والعرب بل هي أشمل بكثير وجهودها لم تنحصر في مناقشة الأديان والتاريخ بل طال ذلك أمورا أخرى كالأعراف والتقاليد والأدب والشعر..وخلافه، وبرأيي أنه لولا الثورة الصناعية في القرن 19 م والتي أدت لتغير هائل في البنية التحتية الأوروبية ما نشأ هذا التيار وظل الاستشراق على حالته القديمة المحصورة فقط بجانب الرحلات والأسفار إضافة لترجمات القرآن المختلفة بهدف دراسته أو الطعن فيه وفقا لوجهات النظر المسيحية المتشددة التي سادت أوروبا في القرون الوسطى.
أي أن الاستشراق هو أقدم بكثير مما نعرفه، فقد بدأ بمرحلة الرحلات الاستكشافية الأوروبية منذ القرن 13 م ومن أشهر هؤلاء رحلات الإيطالي ماركو بولو(1254- 1324 م) وقد كان تاجرا إيطاليا ورحالة سافر لأقصى بلاد الصين ووصل إلى مملكة المغول، أما المرحلة الثانية للاستشراق فقد كانت بترجمة القرآن منذ القرن 16 خصوصا بعد ظهور آلة الطباعة والشغف الكبير الذي تمتع به مفكري وقساوسة أوروبا لدراسة مجتمع المسلمين وكتابه المقدس رقم 1 أما الاستشراق المعاصر فقد بدأ في القرن 19م كما قلنا كجزء من الثورة المعرفية الهائلة التي اجتاحت أوروبا في هذا التوقيت وظهرت بناء عليها حالات (كالثورة الحقوقية النسائية) و (الثورة الصناعية) و (ثورة تحرير العبيد) و (فصل الدين عن الدولة)..وغيرها كالثورة الفلسفية والعلمية التي خرجت بفلسفات وعلوم ماركس وداروين وكيركيجارد وهيجل وفيورباخ وعلماء الطب والفيزياء والكيمياء..وغيرهم، وبالطبع كان الشرق الآسيوي والأوسط هدفا لفهم العالم كجزء لدراسة وفهم هذه الأبعاد.
لكن هذه الجهود الاستشراقية صارت هدفا للطعن والتشويه والشيطنة ككل بفضل الحركات الأصولية والجماعات الإسلامية لعوامل كثيرة منها أنها خرجت من بلاد الاستعمار الأوروبي “كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا”..وغيرهم، فبالطبع سيكون العامل السياسي مساعد على رفض هذه الجهود من جهة سوء النوايا والتقدير والجهل بمجتمعات المسلمين من ناحية، ومن جهة الطمع والجشع والتوسع الاستعماري من جهة أخرى، ولم يكن هذا التفسير للاستشراق حكرا على الأصوليين أو المتزمتين بل طال بعض الأدباء والمفكرين كإدوارد سعيد (1935- 2003) وهو مفكر فلسطيني كتب مصنف “الاستشراق” في التسعينات ، والذي كان يرى فيه أن للاستشراق سلطة معرفية ارتبطت بالسياسة فعلا، من جهة تأثير القوي في الضعيف علما بأن القوي الذي يقصده إدوارد ليس فقط في السياسة بل صارت قوة الغرب اقتصاديا وعلميا تساعد بشكل كبير على فرض هيمنتهم وثقافتهم وطريقة تصورهم للكون فيما اصطلح عليه لاحقا بتأثير “العولمة”.
وانتقد إدوارد الاستشراق أيضا من جهة فهم الغرب المحدود لمجتمعات المسلمين والسبب في ذلك تناولهم لمجتمعات الشرق كقطعة واحدة متشابهة ومتجانسة وغير متباينة..وهذا التصور بالطبع قاصر ليس فقط عن فهم مجتمع المسلمين بل هو قاصر أيضا عن رؤية أي مجتمع يجهل فيه المستشرق بنية هذا المجتمع سياسيا ودينيا ولغويا واجتماعيا وعشائريا..إلخ، وبالتالي سوف يصبح فهم المستشرق أكثر شمولية من الواقع الذي يصنع الفارق، ويكثر تعميم الرجل الغربي عن الشرق بأكمله، ولو أن هذا الاتجاه الاستشراقي وإن شابه بعض القصور في نظر إدوارد سعيد هو في رأيي صنع حالة ثقافية جديدة وميزة خلقت بعد ذلك تيارات نقد وتقريب ذاتية إسلامية، كمثال تناول المستشرقين لمذاهب السنة والشيعة (كمجرد اجتهادات علمية) لا (كمذاهب سياسية وتكفير) كما هو راسخ ويفهمه كل سني وشيعي.
فكان من أثر هذه الشمولية الاستشراقية ظهور حركات النقد داخل مذاهب السنة والشيعة انقلبت فيه أحيانا على الفكرة المؤسسة، مثلما كتب المرحوم الشيخ “محمد حسين النائيني” (1869- 1936م) كتابه “تنبيه الأمة وتنزيه الملة” ليضرب فيه معتقد ولاية الفقيه وفكرة الإمامة المقدسة والمتصلة بالسلطة التي تهيمن على الفكر الشيعي ، وهي نفس المرجعية التي دفعت الشيخ علي عبدالرازق (1888- 1966م) في مصر لكتابه “الإسلام وأصول الحكم” ليضرب فيه أيضا معتقد الخلافة المهيمن على الفكر السني، ولولا حركات الاستشراق وتناولها الشمولي للإسلام كتاريخ ما ظهر النائيني وعبدالرازق، فالصدمة الإسلامية حدثت بفعل الإدراك والوعي بعدم قدسية التفاسير والأحاديث وبداية ظهور موجات شك في النصوص والتاريخ الإسلامي برمته مثلما حدث مع المرحوم طه حسين (1889- 1973م) في كتابه المشهور والمؤثر “في الشعر الجاهلي” الذي استخدم فيه المنهج الديكارتي التأملي في قراءة النصوص والتاريخ والعقائد.
وقد ذهب طه حسين في هذا الكتاب إلى أنه لم يكن هناك شعراء مشهورين في الجاهلية، وأن الشعر المسمى بالجاهلي هو مدونات وقصائد شعرية متأخرة عن زمن النبي على الأرجح من العصر العباسي، ونفس الشئ حدث مع الدكتور لويس عوض (1915- 1990م) في كتابه “في فقه اللغة العربية” الذي ذهب فيه أن العرب أمة حديثة وأن اللغة العربية مشتقة من اللغة النبطية والمشتقة هي الأخرى من المصرية القديمة، وهذا يعني أن أصل اللغة العربية كان في مصر وليس في الحجاز، وأنه لم تكن هناك لغة عربية في الألف الأول قبل الميلاد، فمن الواضح هنا جُرأة الأفكار وحداثة المناهج التي دفعت هؤلاء للنظر إلى الدين والمجتمع بطريقة مختلفة عن التي سادت في الماضي السحيق أو حتى القريب قبل زمن الاستشراق والثورة الصناعية.
بخلاف ذلك أدى الاستشراق لظهور تيار التقريب المذهبي بين السنة والشيعة، فتناوله للإسلام بشمولية وعدم تفريقه بين المذهبين من ناحية السياسة واعتبارهما مجرد اجتهادات غرس في نفس القارئ لهذا النوع من الاستشراق تقاربا وجدانيا، وتكسرت هذه الجبال والتلال الطائفية التي صنعها الحكام والفقهاء بين السني والشيعي على مدار التاريخ، وصار تناول المذهبين لبعضهما فيه لمحات من العلم والإنصاف..خصوصا بعد اقتحام الشيعة مجال الفلسفة والتصوف والعرفان والكتابة فيه بتوسع.. وهو المجال الذي تركه وأهمله معظم فقهاء السنة القدامى في العصرين الأموي والعباسي، فداعب ذلك خيال كثير من مفكري السنة ونخبتها العاشقين للفلسفة والتصوف أن يميلوا نفسيا لدعاوى التقريب ، وتكثر مساحات الأعذار السياسية والتاريخية لنرى في الأخير تيار التقريب قد اكتمل نموه في عصر الملك فاروق الذي صاهر أسرة بهلوي الإيرانية الشيعية فكان جراء ذلك أن تشجع كثير من المسلمين في الانضمام لهذا التيار والكتابة في أحواله ومستقبله.
الأولى: مدرسة اللغة وتزعم هذا التيار المستشرق الألماني “تيودور نولدكة” (1838- 1930) في كتابه “تاريخ القرآن” في أجزاءه الثلاثة، وقد عني في هذا الكتاب بالبنية اللغوية للقرآن وتفكيك مفرداته وأسلوبه وعباراته للحد الذي يقال فيه أنه (ثورة معرفية لغوية) لم يفعلها أحد قبله، ولا زال هذا الكتاب من أهم أعمال المستشرقين الناقدين والمحللين للفكر الإسلامي الذي استعان فيه الكاتب بمصنفات “علوم القرآن” أشهرها كتاب الإتقان للإمام السيوطي (1445- 1505م) وقد وصل فيه لبعض المفاجآت منها تكذيب قصة نزول القرآن على أحرف سبعة، واعتبار ذلك من إرسال وأوهام المؤرخين الذين لم ينتبهوا أن الرسول في كثير من الروايات سمح بقراءة القرآن بلهجات ولغات مختلفة أكثر من السبعة المشهورة، ثم تتبع فكرة النسخ عند مصادرها الأولى في الدين المسيحي ورصد كتب الناسخ والمنسوخ أيضا وأساليبها اللغوية ومصادرها المعرفية.
الثانية: مدرسة التاريخ والتي من بين مؤسسيها المستشرق الألماني “يوليوس فولهاوزن” (1844- 1918م) في كتابيه “المملكة العربية وسقوطها”و “الخوارج والشيعة” الذي ساعده تخصصه في الدراسات الإسرائيلية بكتابين “تاريخ بني إسرائيل” و “مقدمة لتاريخ بني إسرائيل” في مناقشة تاريخ المسلمين بنفس المنهجية التي قرأ بها الأوربيون تاريخ العهد القديم، وهي منهجية نقدية تعتمد على فرضية التوثيق أكثر من الاعتماد على الروايات المرسلة التي لا يمكن التأكد من صحتها، وقد اصطلح على هذه المنهجية باسم “الفرضية الوثائقية” في محاولة منهم لتتبع أصل الكتب المقدسة التاريخي ..متى وأين كتبت وتحت أي ظرف في ظل فقدان تام للمعلومة الموثقة التي تؤكد ذلك، مع تحليل سياسي نقدي لروايات المسلمين في يثرب لا يخلو من الهجوم على الإسلام ورسوله وفقا لتصوير المؤرخين المسلمين لغزوات الرسول في المدنية خصوصا ضد اليهود.
وكان مما كتبه فولهاوزن أن شخصية النبي تظهر من القرآن والتاريخ أنها كانت إقليمية لا تعلم الغيب، وبالتالي صارت كل مزاعم علم النبي بالحوادث المستقبلية بعد موته موضع شك، وفي هذه تأثر فولهاوزن بالمدرسة المادية التاريخية التي أنشأها هيجل وماركس في القرن 19 م والتي تقول بأن تفكير الإنسان يحدث وفقا لظروفه المادية وأحواله الراهنة، ولو كان منشغلا بالغيب بهذه الصورة التي تخيلها الرواة وأفاضوا بها لدرجة المبالغة ما خطى الرسول خطوة واحدة خارج مكة، ولظل ساكنا في مسقط رأسه يدعو ويحدث عن أحوال المستقبل..وكأن فولهاوزن يرى أن شخصية النبي التي نقلها الرواة والتي تكثر من التنبؤ والحديث المستقبلي متأثرة بالفكر اليهودي في أسفار “أشعياء وحزقيال” المختصين بأحوال وفتن نهاية الزمان ويُكثرون فيها من التنبؤ بالمستقبل وعالم الغيب، وهو ما لمّحت إليه في دراستي المنشورة بمواطن قبل أيام بعنوان “الدور اليهودي في نشأة مذهب الحديث” التي برأت فيها شخصية النبي وطريقته من هذا الكهنوت المتخيل.
المدرسة الثالثة: وهي المذاهب والعقائد التي من بين مؤسسيها المستشرق المجري “إجناتس جولدتسيهر” (1850 – 1921م) بمجموعة كتب منها “مذاهب التفسير الإسلامية” و “العقيدة والشريعة في الإسلام” و “الحديث في الإسلام” وهي المدرسة الأكثر شمولا في الأربعة والتي أسست الاتجاه الرابع لنقد الحديث النبوي الذي يعد المستشرق الألماني “جوزيف شاخت” من أبرز رموزها، وبما أن مدرسة جولدتسيهر الأكثر شمولا وتناولا بحكم تخصصها في بيان الفرق والمذاهب ونقد العقيدة والحديث النبوي صارت هي المدرسة الأكثر شيطنة بين الأربعة، والأكثر طعنا ونقدا من الأصوليين المسلمين بحكم اتساعها الفكري ومدى تأثيرها في الحركة الاستشراقية عامة.
ومن خطورة مدرسة جولدتسيهر أنها مسُت جُرحا عند الأصوليين المسلمين – سنة وشيعة – حين عرضت الخلافات بين تلك المذاهب باعتبارها خلافا أصليا بين مسلمين معتبرين، ولعل هذا الجانب هو الذي حفز “إدوارد سعيد” لنقد الاستشراق من جهة شموليته وتناوله للإسلام دون اعتبار للخلاف الشديد والجذري الذي حدث بين أتباعه لدرجة التكفير، لكن هذه الشمولية كما عرضنا أفادت المسلمين بنزع بذور التعصب الطائفي وفتحت الباب نوعا ما لنقد الفكر الديني الإسلامي وتهذيبه مما علق به من جهالات القرون الوسطى ، علاوة على الاتجاه “الفينومينولوجي” الذي ميز مدرسة جولدتسيهر في البحث عن جذور الأفكار والمعتقدات والنصوص الأدبية ، والتعامل مع نصوص المسلمين بنفس الروح والشغف الذي يبحث عن جذور تلك النصوص عند الحضارات الأقدم منها في بلاد فارس واليونان والرومان، مثل قوله في كتاب “العقيدة والشريعة في الإسلام” أن الدين الإسلامي متصل بشكل كبير في روحانيته بالتصوف الهندي والأفلاطونية المحدثة وفي سياساته ببلاد فارس وقوانينه بالدولة الرومانية.
المدرسة الرابعة: وهي نقد الحديث النبوي التي من بين مؤسسيها المستشرق الألماني “جوزيف شاخت” (1902- 1969م) بعدة كتب منها “تراث الإسلام” و “أًصول الفقه المحمدي” الذي اعتبر فيه الأحاديث النبوية موضوعة لغرض فقهي ما بين القرنين الثاني والثالث الهجريين، وما قاله كان ثورة معرفية في زمنه تأثر فيها بمدرسة جولدتسيهر كما قلنا، وأسس لاحقا لظهور حركة نقدية للحديث في الفكر الإسلامي تجلت في ظهور “حركة القرآنيين” التي كان أول نشاط لها في مجلة المنار عن طريق الدكتور “محمد توفيق صدقي” (1881- 1920) ثم ظهور كامل لها في التسعينات عن طريق الدكتور “أحمد صبحي منصور” فالمذهب القرآني هنا متأثر بجهود جوزيف شاخت وجولدتسيهر لحد كبير، ولا يعني ذلك وجود علاقة مباشرة ولكنها علاقة تطورت عبر عدة أجيال وظروف دولية وسياسية ظهر فيها القرآنيين كخصوم لجماعات الإرهاب والتيار السلفي الوهابي كأبرز تيار يحمل فكر أهل الحديث مما أكسبه قبولا عند بعض المثقفين والنخبة.
والحقيقة أن ما فعله جوزيف شاخت لم يؤسس فقط لمدرسة نقدية للحديث النبوي واعتباره منتجا أدبيا لقصاصين وفقهاء بالقرنين الثاني والثالث، بل أسس لفكرة أكثر خطورة وهي عدم قدسية الأئمة الأربعة والمذاهب الإسلامية كافة واعتبار ما قدموه يناسب مصالح وأعراف وثقافات زمانهم، وهي الفكرة التي تحدث عنها جولدتسيهر ولكنه لم يتوسع فيها كشاخت ، ومن تلك الزاوية صار نقد الحديث والأئمة يتعاظم بمرور الوقت حتى وصل أوجه الآن في القرن 21 خصوصا بعد انهيار الجماعات الإسلامية سياسيا وأخلاقيا بعد الربيع العربي 2011 وثبوت فشل منتجهم الفكري من حيث التطبيق، وظهور عدة تيارات نقدية ضمت ملايين الشباب ضد الجماعات وفيها تنوع كبير بين مفكرين مسلمين وغير مسلمين لنقد الفكر الروائي القديم.
إن الحقيقة التي عبَّر عنها الاستشراق هي استدعاء ما كان عليه المسلمون في عصر الاجتهاد أول 200 عام بعد وفاة الرسول، فخلال هذه الحقبة كان الاجتهاد نشطا والصدام السياسي المختلط بالدين أيضا نشطا..وهو وضع يشبه ما عليه المسلمين في القرنين 20، 21 ويفسر عودة الحروب الدينية بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم من جديد، فالعالم الإسلامي يعيش عصر اجتهاد حقيقي وهو وإن لم يخرج بعد على قدسية وإلزامية المذاهب الأربعة السنية والثلاثة الشيعية لكنه يتطور بالتدريج من ناحيتين، الأولى: إخضاع الفكر الإسلامي القديم للتطبيق وتركه مفردا وحيدا لإثبات نفسه أمام موجات الحداثة والعقلانية العاتية، وهي منافسة محسومة لصالح موجات الحداثة الأكثر واقعية من جهة والأكثر معقولية وقدرة على المعرفة من جهة أخرى، والناحية الثانية: هي التمثيل السئ والتجارب الفاشلة والصادمة لتلك المذاهب الآن مما يعزز صدقية مقولة أن تلك المذاهب بنت زمانها وأن المسلمين يجب أن يبحثوا عن نسخة فكرية جديدة لهم أكثر واقعية ومعرفة خصوصا بعد ظهور ميثاق حقوق الإنسان في الأربعينات وتضمين معظم دول العالم مواده الأساسية في دساتيرهم، وهو ميثاق يتعارض جذريا مع شريعة الفقهاء المثبتة في كتب المذاهب القديمة.
وقد وصلنا الآن لمدرسة استشراقية أكثر حدة وعنفا في تناول الإسلام، فالاستشراق وإن بدأ ظهوره بشكل علمي أكاديمي هادئ لكن ظواهر الاستشراق متباينة بشدة وقد خلصت حاليا إلى تيار استشراقي حديث توسع نشاطه بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 والهدف منه الهجوم على كل ما هو إسلامي ليس فقط تناول المسلمين تاريخيا من كتبهم مثلما فعل المستشرقين القدماء ولكن تناول الإسلام من خصومه والاعتماد على بعض الأقوال والنظريات المسيحية التي تدعي نسبة الإسلام لفرقة مسيحية مهرطقة ظهرت في القرون الأولى بعد المسيح، وأن هذه الفرقة اعتمدت كتب الأبوكريفا التي اعتبرتها الكنائس المسيحية مزيفة ومدسوسة على الدين المسيحي، وأن هذه الفرقة المسيحية أيضا اعتمدت كتب وقصص المدراش والتلمود اليهوديين في تشكيل عقائدها الدينية وتصوراتها ناحية الأنبياء.
يُمثل هذه المدرسة عدة مستشرقين منهم الدانماركية “باتريشيا كرون” (1945 -2015) ببعض الكتب منها “المشركون والمسيحيون اليهود في القرآن” و “الهاجرية ..صناعة العالم الإسلامي” و “السلطة الدينية في العصور الإسلامية الأولى..خليفة الله” وبرغم ظهور بعض هذه الأعمال قبل 11 سبتمبر لكنها انتشرت بعد الحادثة وحصلت على شغف العلم والاطلاع من قِبَل الباحثين الأوروبيين الذي كان الشعور المعادي للإسلام في الغرب كبير هذه الفترة واعتبار ما فعله تنظيم القاعدة ممثل أصيل عن الدين الإسلامي ويعبر عن جوهر الرسالة المحمدية ، ومن أمثلة بعض المستشرقين الذين يعملون في هذا النطاق أيضا مايكل كوك ولوكسمبرج فضلا على حصول هذه المدرسة الاستشراقية على دعم القساوسة المتعصبين في الغرب وتبني بعض الناقدين لها في الشرق، وتقوم فكرة هذه المدرسة على البحث التاريخي عن جذور الإسلامي وربطه بالهراطقة المنتسبين للمسيحية واليهودية في القرون الأولى للميلاد، وطرح عدة نظريات منها أن جذور الإسلام كانت في الشام أو البتراء ليست في مكة معتمدين فيها على تأويل بعض نصوص القرآن والتاريخ.
وقد درست هذه الأفكار لمدة عامين منذ عام 2016م وهضمت ما يقولوه إما بقراءة كتب أو متابعة أعمالهم على السوشال ميديا، وخرجت بدراستين للرد عليهم الأولى سنة 2018 بعنوان “مكة بين التاريخ والقدسية” والثانية 2019 بعنوان “رحلة في جدليات الإسلام المبكر” وإن كنت أعيب لمن يتصدى للاستشراق بعض الأخطاء منها تعميم النظرة السوداوية على حركة الاستشراق عامة، فمثلما كان هناك ناقدين ومهاجمين للإسلام يوجد أيضا مدافعين ومنصفين للإسلام منها ما كتبته المستشرقة الألمانية “سيغريد هونكة” (1913 -1999م) بكتابها “شمس الله تسطع على الغرب” والكثير من أعمال المستشرق والمؤرخ الفرنسي “جوستاف لوبون” (1841 -1931م) وغيرهم.
كذلك إذا كنا نعيب على حركة الاستشراق تناول الفكر الإسلامي دون اعتبار للخلافات الجذرية لأصحابه واعتبارهم متجانسين ومتشابهين، فتناول خصوم الاستشراق له لا يخلو من نفس الخطأ المعرفي وهو الخلط بين مناهج المستشرقين والبحث في جذورهم الدينية لتدعيم فكرة المؤامرة الطائفية كادعاء البعض أن ليهودية شاخت وجولدتسيهر سببا مباشرا في نقدهم للحديث النبوي والتاريخ الإسلامي، ولا ندرك أن نقود هؤلاء أول ما وجهت كانت لمجتمعاتهم والبحث في مراجع وخلفيات الفكر الديني الأوربي، أي أن جزء كبير مما فعلوه كان بتأثير الحركة العقلية النشطة في القرن 19 والتي امتدت آثارها للقرن العشرين وانسجمت وتعايشت مع ظروف وأحوال الحروب العالمية والباردة، وأخيرا إذا كنا نعتب على هؤلاء المستشرقين عدم الموضوعية في تناول الفكر الإسلامي والكتابة فيه بانطباعاتهم الشخصية والتعسف في الاستنتاج والتحليل فالأمر نفسه يعاني منه شيوخ المسلمين الذين لا يتناولون خصمهم الديني بموضوعية ويتعسفون في قراءة مذاهب الخصوم ويتناولون نصوص الغير الدينية بانطباعاتهم الشخصية دون تطبيق أي منهج نقد موضوعي معروف.
وما الحروب الطائفية بين السنة والشيعة وظهور مئات الجماعات التكفيرية ومقتل ملايين الأبرياء وتدمير بعض الدول إلا نتيجة طبيعية لسوء التقدير الذي حدث وتناول فيه الفقهاء والزعماء غيرهم بتعسف وجهالة، وفرضهم لأوهامهم على الناس كأنها حقائق لا يخالجها الشك..وأن التعايش بين المسلمين وبناء مجتمعاتهم على أساس علمي تقدمي لن يحدث في ظل سيادة هذه الرؤى القاصرة للغير بل يلزمه تواصلا كبير وانفتاحا يؤهل الباحثين منهم لدراسة الغير دراسة موضوعية تقف على الخلافات الحقيقية وحجم الأضرار إذا تركت هذه الخلافات دون حل أو تعظيمها بأثر التعصب الديني والسياسي.