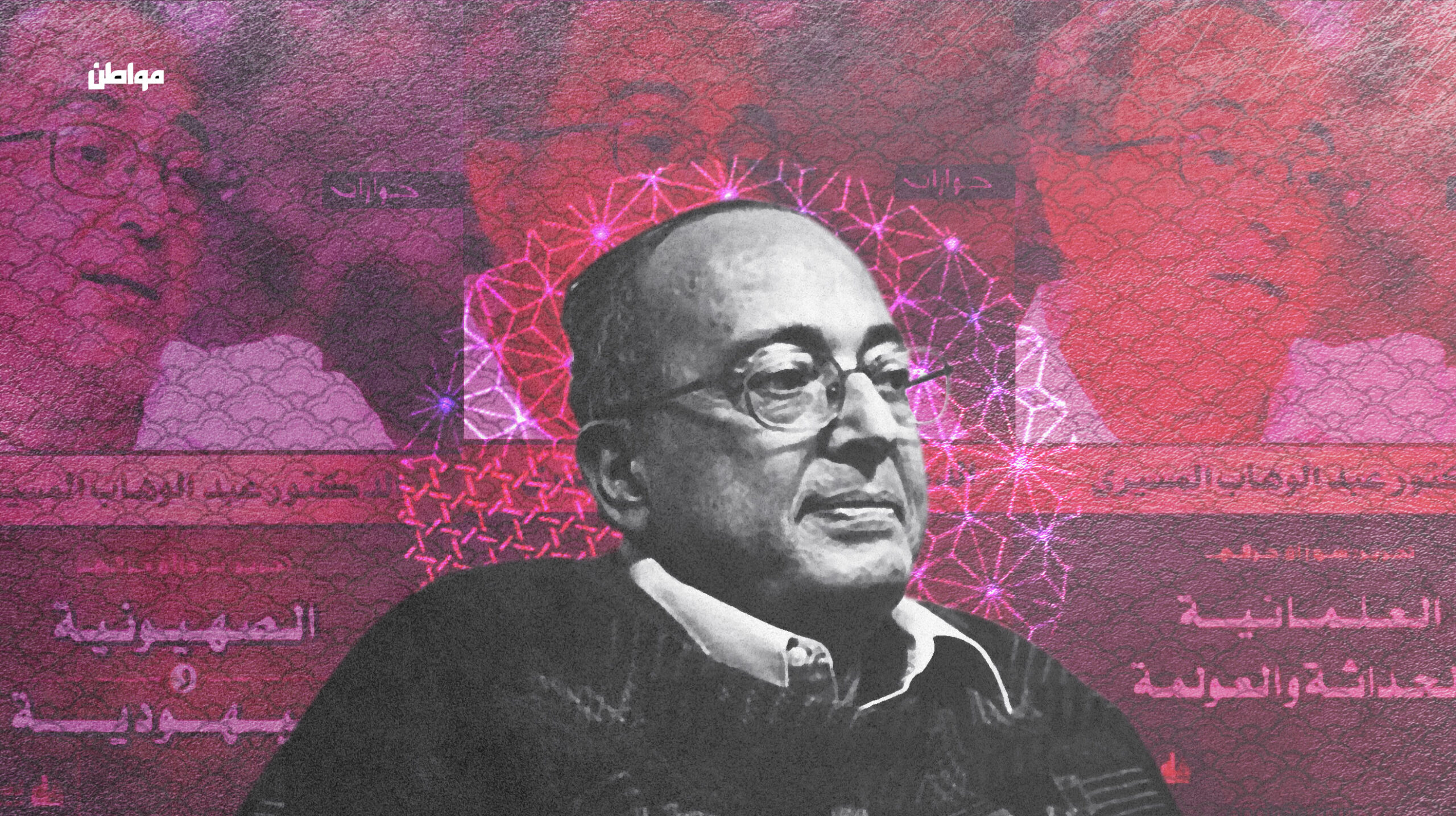المدهش في جماعة الإخوان المسلمين أنهم ظلوا في مصر يمتلكون ذكاءً سياسيًا ملحوظًا منذ السبعينات حتى صعود الرئيس مرسي للحكم عام 2012؛ فكانوا يتوددون للأحزاب ويعقدون الصفقات ويمنحون الهبات والعطايا، ولا يتشددون في علاقتهم بالدولة أو رموزها ومراكز قواها كما تشدد السلفيون، وكانوا يضعون أنفسهم دومًا في مصاف الأحزاب الليبرالية ضد الجهاديين قبل ثورة يناير 2011، حتى نجحوا في الثمانينات والتسعينات بعقد التحالفات والتفاهمات مع حزب الوفد والغد الليبرالي وقوى اليسار المصرية، ممثلة في أحزاب التجمع والأحرار، ومؤخرًا الكرامة لحمدين صباحي، أستثني من ذلك فشلهم في تدجين القيادي اليساري “رفعت السعيد”، الذي ظل على موقفه المعادي منهم حتى وفاته عام 2017، ويمكن فهم ها الاستثناء من زاوية موقف سعيد الأيدلوجي من اليمين الديني بشكل عام، والذي صاغه في كتبه ورواياته.
إنما مع هذا الذكاء، كان الإخوان يعانون من الفقر المعرفي والفلسفي الحاد الذي يمكنهم من فهم العالم والإنسان والدولة الحديثة، وبالتالي ما لاحظناه من ذكاء سياسي كان ثمرة شعور كاسح داخل الجماعة منذ السبعينات يتحسس خطر الانهيار وتكرار التجربة الناصرية معهم؛ فكانت مواقفهم السياسية منذ العصر الساداتي حتى ثورة يناير 2011 موصوفة بالاتزان وحرصهم على كسب ثقة الدولة وأحزاب اليمين واليسار مع شتى جماعات التيار السلفي في آن واحد، وهي خلطة سياسية لن يفهم قدرتهم على إنجازها من لم يقرأ موسوعة ترشيد الصحوة للشيخ يوسف القرضاوي؛ وهي سلسلة كتابات خطها القرضاوي لإحداث الفارق بين الإخوان وجماعات الجهاد والتكفير التي حاربت الدولة منذ السبعينات، ونجح من خلال تلك السلسلة إقناع الفرد الإخواني بالانتماء لوطنه وأنه جزء لا يتجزأ من نسيج شعب مصر. في محاولة التف فيها القرضاوي على مفاهيم القومية الإسلامية التي اكتسحت جماعات العنف في ذاك التوقيت، وكانت تطالب علنًا بالخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وكانت نتيجة هذا الفقر المعرفي والفلسفي الحاد للإخوان، أن عملوا على ثلاثة مسارات:
الأول (سياسي) يقدمون فيه أنفسهم كتيار مدني سياسي يطالب بحقه المشروع في العمل الحزبي، ومن تلك الزاوية حصلوا على ثقة كثير من النخبة المصرية المعارضة التي تعاونت معهم وأفردت لهم مساحات الصحف للتعبير عن آرائهم.
الثاني وهو: (فكري ديني)، وفيه كانوا يقدمون أنفسهم لنظرائهم في الجماعات الأخرى أنهم تنظيم ديني معتدل وسطي، يطالب بالتوفيق والوحدة بين المسلمين، ومن تلك الزاوية حصلوا على ثقة التيار السلفي الذي تعاون معهم اجتماعيًا في تأسيس الآلاف من المدارس الدينية والمساجد والجمعيات الخيرية، وحصلوا أيضًا على ثقة علماء الشيعة الذين تعاونوا معهم في تأسيس بعض المؤتمرات والهيئات الدولية العاملة في مجال (التقريب بين المسلمين).
أما المسار الثالث وهو الأهم في رأيي والذي عايشته داخل الجماعة مدة 21 عامًا منذ عام 90 حتى عام 2011، وفيه كانوا يدرسون كل مفاهيم السلفية الحرفية الجامدة المعتمدة على قدسية كتب التراث والأئمة، فكانوا يقولون لنا داخل التنظيم إن الهدف هو إنشاء دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة، ثم الانتقال لمرحلة أخرى لسيادة الإخوان على العالم أسموها (بمرحلة الأستاذية)، وفيها يعتقدون بأن نجاح دولة الخلافة سوف يؤدي لصنع النموذج التقدمي الذي تتسارع فيه الأمم والشعوب لتقليده والانضواء تحت لواء الجماعة في حُكم العالم.
وبرغم سطحية هذا المعتقد وافتقاره لأدنى مقومات التفكير البسيط؛ لكنه كان يغزو شرائح الإخوان بشكل غريب، وتبنته النخبة؛ ليس فقط داخل الإخوان؛ لكنه صار ينتشر داخل السلفيين أنفسهم، الذين كانوا يقنعون الجماهير بأن الحل في الخلافة والرخاء والنماء لن يحدث سوى في ظل دولة الشريعة، والعدل لن يتحقق سوى بإعلان الجهاد ضد الطواغيت.
هذا الانفصام وتلك الازدواجية داخل الإخوان تمثلت نتائجها بسرعة في انهيار سريع لسلطة الجماعة، منذ توليها السلطة على مصر عام 2012، لأن المسار الثالث كان جوهريًا في الواقع، ويمثل حقيقة الجماعة دون تزييف؛ فهم كانوا على عداء مع العقل والفلسفية والتفكير الحر، شأنهم في ذلك كشأن أي جماعة سلفية تراثية، ولم تنجح كتابات القرضاوي سوى في صنع (الفارق السياسي) بين الإخوان والجهاديين لا غير، أما (المشترك الفكري) فقد رسخه القرضاوي بكتاباته أيضا في تبني نسخة سلفية أصولية ناحية أمور التجديد والفقه، فكتاب الحلال والحرام على سبيل المثال، والذي صار هو عمدة ودستور الجماعة الفقهي، بالإضافة لكتب أخرى كفقه السنة للشيخ سيد سابق، لم تحلّ هذه المؤلفات معضلة التجديد التي كان يرفعها مفكرو الجماعة، بيد أن فتاوى القرضاوي في تحريم البنوك والتماثيل وغيرها، ثم التصريح بكفر العلمانية والشيوعية والفتوى بكراهية حلق اللحية وغيرها، من الفتاوى كانت تتسق مع الخط السلفي الأصولي العام.
واقع كهذا كان ينبئ بعزلة حادة بين الإخوان والواقع، وترسيخ صورة لهم في ذهن الآخر أقرب للنفاق والجهل؛ فلم تكن لهم مرجعية علمية واضحة، ولا منهاج فكري يمكن وصفه بالصواب والخطأ؛ فالجماعة خلصت إلى تنظيم شعاراتي فاقد لأبجديات العمل السياسي (في الحكم)؛ فهم وإن كانوا مُجيدين للعمل السياسي (المعارض) سابقًا، لكن البون شاسع بين الحكم والمعارضة؛ فالأولى فلسفيًا تميل للعملية والبراجماتية؛ بينما تميل الثانية للتنظير والشعارات طبقًا للمسؤولية الملقاة على عاتق الحكام في خدمة الجماهير، وهي مسؤولية تفرض عليهم العمل للصالح العام، وأن يتسم سلوكهم بالحكمة والبعد عن التفاهات والصراعات العبثية، وأنى لهم ذلك وهم يدرسون في داخل التنظيم كل مفاهيم الشريعة والخلافة القرووسطية، التي لا تحترم الآخر وتعاني من التمييز العنصري تجاه المرأة والأقليات والمعارضين بشكل عام، وسقوط الإخوان في وحل التكفير والعنصرية بهذا الشكل، هو السر في سقوطهم السريع وتورطهم في التحريض الطائفي وإعلان الجهاد في سوريا وغيرها من السقطات التي عجّلت بالرحيل.
وقد كنت في السابق أعتب على مسؤولي الجماعة تبني خطابين متناقضين لا يمكن حل التعارض بينهما عمليًا؛ فهما خطابان وإن كانا مقبولين شعاراتيًا، ولهما أنصار وجمهور يرفعهما بشكل عاطفي؛ إلا أن التطبيق سيفرض نفسه في النهاية، وهذان الخطابان هما:
(تبني الإخوان مرجعية الشريعة الإسلامية، مع إقرارهم بحرية الرأي والعقيدة)، وهو تناقض صريح ينكشف وقت التطبيق أو المناظرة مع الآخر؛ فالشريعة الإسلامية الموروثة من الفقهاء تقول (بحد الردة)، ويعني هذا الحد قتل من كان مسلمًا وخرج عن الإسلام، وعند تمثيل هذه الحالة في الواقع نراها (تهمة) أكثر من كونها فرقة وجماعة معروفة؛ فلا توجد في الواقع جماعة اسمها مرتدين لها زعماء وعلماء وجيوش، ومن توجه له هذه التهمة ينكرها على الفور ويصف نفسه؛ إما (بالمجتهد أو المعارض) وبالتالي؛ (فالردة) هي تهمة في الواقع موجهة لكل مفكر معارض، والتاريخ الإسلامي يشهد ويؤكد أن كافة أحوال قتل المرتدين كانت موجهة ضد فقهاء مجتهدين قُتلوا على رأيهم، باستثناء جماعات مدعي النبوة بعد موت الرسول، والتي تقول بعض الروايات أنهم لم يُسلموا من الأساس ليكونوا مرتدين.
ولمزيد من كشف هذه الأزمة أذكر أنه وفي شهر أغسطس سنة 1992؛ أي بعد مناظرة دكتور فرج فودة مع الشيوخ في معرض الكتاب بسبعة أشهر، كتب الأستاذ ” فهمي هويدي” في الأهرام نقلاً عن “مصطفى مشهور” المرشد العام للإخوان المسلمين” هذا النص: ” الأمر يحتاج إلى تفرقة بين مرحلة الدعوة؛ حيث هناك أوضاع مفروضة ولا خيار للإسلاميين فيها، وبين نموذج الدولة التي يتصدرها الإسلاميون، وأنا لا أرى محلاً في الواقع الإسلامي لفتح الأبواب أمام المخالفين للإسلام للدعوة لمبادئهم؛ سواء كان هؤلاء من العلمانيين أو الشيوعيين، وهذا الموقف هو من قبيل الوقاية التي ينبغي التماسها لتأمين المجتمع، والدفاع عن قيمه الإسلامية وعافيته الإيمانية”.
وترجمة كلام مشهور: (أنه يجوز للإسلاميين الدخول في الانتخابات الديمقراطية ضمن مرحلة الدعوة، لكن بعد الفوز في الانتخابات لا يجوز فتح الباب للشيوعيين والعلمانيين أن يدعو لمبادئهم، وتُفرَض عليهم الشريعة جبرًا لوقاية المجتمع منهم والدفاع عن قيمه الإسلامية)، علما بأن الذي يتحدث هو مرشد الإخوان نفسه.
وقد رأينا بعد فوز د مرسي بالرئاسة كيف أن الإخوان بدأوا خطة التمكين بالتحالف مع كل من هو إسلامي ديني، وإقصاء واضطهاد وتهديد كل من يعارض وجهة نظرهم من أحزاب ليبرالية وأقباط وشيعة .. إلخ، وهذه المفارقة لم تكن لها أن توجد سوى أن الجماعة وكل تيارات الإسلام السياسي المنضوية تحت لوائها يفرقون بين مرحلتي (الدعوة والدولة)؛ الأولى تُرفع فيها شارات المهادنة والصداقة والسلام والسياسة والاعتدال؛ بينما الثانية تُرفع فيها شارات القتل والسجن والقمع لأي معارض بدعوى الكفر والحرب على الإسلام.
من هذا المشهد يمكننا أن نتلمس مستقبل الإسلام السياسي في مصر ببضعة محطات:
الأولى: أنه لا يمكن لجماعات الإسلام السياسي في مصر أن تعمل وفقًا لهذا النمط والتاريخ المكشوف؛ فقد عرضت أفعالهم للنقد وتاريخهم للطعن والتحليل، وتسابق الخبراء في كشف مواقفهم التكفيرية الداعية إلى العنف. وأن أسلوب الجماعة في مراحل ضعفهم يميل للمهادنة والصداقة والتواصل، وأن هذا الأسلوب عرف لديهم بمرحلة الدعوة التي تفرض عليهم هذا الأسلوب الذي شرحت بضع معالمه في مقدمة المقال، ووصفته (بالذكاء السياسي)، بالتالي لا يمكن أن يتكرر هذا الخداع مرة أخرى دون اعتراض في وقت تغزو فيه السوشال ميديا البيوت والدول، وتسجل هذه المواقف بالصوت والصورة حتى لا تترك أي فرصة ومساحة للنفي والتكذيب.
الثانية: القدرة الاستراتيجية لجماعات الإسلام السياسي الآن غير موجودة؛ فهم في مرحلة غضب وثورة دائمة يُعبرون عنها بشكل متكرر في وسائل التواصل؛ إما بتكفير لكل مسؤولي الدولة والنخبة والمعارضين، أو دعوات للتظاهر غير متقنة وغير مدروسة وليس لها أفق سياسي، وتتلخص معالم هذه القدرة الاستراتيجية في عدة أشياء؛ منها انخفاض وعيهم بالظروف والواقع، ويشهد على ذلك فشلهم الثوري المتكرر، والذي أعقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013؛ فإذا كان وعيهم محدودًا بالواقع؛ فوعيهم بفن تصميم تلك القدرة الاستراتيجية وخلقها من العدم أيضا غير موجود، بمعنى أن جماعة الإخوان لها نخبة مثقفة من شيوخ وزعماء وقادة ورجال دين، حتى الآن لا يمكن استنطاق أي منهج لتلك النخبة الإخوانية، تعي قدرتها على صياغة منهج موحد يعرفونه ويتفقون عليه ويسيرون خلفه، بالتالي بدلاً من هذا الغضب المتكرر وحالة الثورة الدائمة غير المدروسة، يظهرون بخطة عمل معبرة عن نواياهم بكيفية التعامل مع فئات الشعب المصري من (حكومة وجيش وليبراليين ومسيحيين ومعارضين.. إلخ)
ومن مظاهر عدم وجود قدرة استراتيجية أيضًا عدم وعيهم بكيفية تغير مصر للحكم المدني الديمقراطي، وقراءتهم للتاريخ مخطئة من هذا الباب؛ فلم يسبق لأي سلطة عسكرية في الشرق الأوسط أن تركت الحكم لغيرها (جبرًا وغصبًا)؛ بل بعمليات شاقة من التفاوض والحوار؛ فكان لزاما عليهم وهم يدعون قدرتهم على حكم مصر أن يدخلوا في مفاوضات مع الجيش بعد يناير 2011؛ لكن الذي حدث هو أنهم خُدعوا بظنهم أن ثقة الجيش فيهم كانت كافية لحكم الدولة، وتحقق عامل البقاء والاستمرارية، فاختاروا الصراع مع الجيش المصري – عسكريًا وسياسيًا – كوسيلة ضغط يحاولون بها التغطية على فشلهم وعجزهم عن الحوار، والأمر الأخير الذي يعبر عن فقدانهم للقدرة الاستراتيجية هو غياب الدافع؛ فالذي يحفزهم الآن يدعوهم للثورة فقط، وبالتالي فالدافع السياسي غير موجود، والثورة بالأساس ليست عملاً سياسيًا؛ بل هي مشاعر غضب موجهة، وبتعبير أوضح فغياب الدافع هو الذي ينتج فيهم عدم الشعور بالاستقلالية والحرية الفكرية؛ فهم مدفوعون بغرائزهم للثورة والصدام فقط لا غير، لكن غير مسموح للبعض أن يشك في هذه الحالة أو ينصحهم بتغيير وتعديل المسار، وإلا فسوف يعرض نفسه لاتهامات الخيانة والتبعية، أو يجري اتهامه بالكفر والانقلاب على الدين.
فمن أبرز سلبيات العمل الثوري التي تقضي على أي ثورة وتفشلها؛ هي (غياب الحرية والاستقلالية)، لأن المنطق الذي يحكم العمل الثوري هو (أكون أو لا أكون)، و (من ليس معي فهو ضدي)؛ مما يفسر عدم إنتاج أي ثورة لمفكرين كبار قادرين على النقد والتصحيح أكثر من إنتاج زعماء وقادة سياسيين وعسكريين .
المحطة الثالثة: غياب الابتكار والإبداع؛ فالحركة الإخوانية وتيار الإسلام السياسي بالعموم لا زال غارقًا في مستنقع الخلافة ودولة الشريعة، ويطالب بشكل متكرر بها حتى وهو يعاني، بينما في ظل الأزمات تنشأ الحاجة لعلاجها، فيخرج المبدعون والمبتكرون. والثابت حاليًا أنه وبعد مرور أكثر من 9 سنوات على رحيل الإخوان عن حكم مصر، لم يخرج أحد منهم بحلول وابتكارات تعالج أزمتهم؛ سوى بيان الإخوان الأخير منذ أيام الذي أعلنوا فيه دعوتهم للتصالح وخروجهم عما يصفونه “بصراع السلطة في مصر“.
وفي الحقيقة أن كلمة “صراع السلطة في مصر” هي أصدق تعبير عن أزمة غياب الإبداع والابتكار؛ ففي مصطلحات بيانهم غير قادرين على التفريق بين كلمتي: “صراع على السلطة” و “جماعة مهجر”؛ فالأولى تتطلب صراعًا بين قوى نافذة مصرية على الحكم، لها شعبيتها وقبولها، وهذا غير متحقق الآن لعوامل منها سيطرة الجيش.
بينما الثانية هي ما يخشى الإخوان على الاعتراف به؛ وهو أنهم صاروا في وضع شبيه بجماعة “مجاهدي خلق” الإيرانية أنهم مجرد “جماعة مهجر”، مع عدة فروق واعتبارات؛ منها أن قيم اليسار وأيدلوجيا النضال من زاوية الفكر المدني لا تساوي الآن قيم الثيوقراطية وأيدلوجيا القتال من زاوية الجهاد والشريعة؛ فجماعة خلق رغم أزمتها؛ لكنها حركة مدنية يسارية لها قبول في العديد من دول العالم؛ بينما جماعة الإخوان هي حركة دينية ثيوقراطية لا تتحصل على هذا القبول، نظرًا لما حدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، وموجات الإرهاب التي ضربت العالم من داعش والقاعدة. ومن الفروق أيضًا بين وضعية الإخوان ومجاهدي خلق؛ أن شعبية خلق تحددها رفض بعض الدول والسلطات للنظام الإيراني بوصفه نظامًا دينيًا أو سياسيًا معاديًا، ومن تلك الزاوية تندفع العديد من الدول لقبول خلق واستضافة مؤتمراتها، بينما هذا غير متحقق في الإخوان الذي لا يماثل فيه عدوهم (النظام المصري) نظيره الإيراني، بيد أن السيسي هو حاكم مقبول من معظم دول العالم، ودولته مصر ليست معادية أو خطرة ونظامها مدني وليس دينيًا.
ويمكن تلخيص أزمة غياب الابتكار والإبداع أنها تتعلق بغياب الاستقلالية الفكرية والحرية داخل الجماعات؛ فالمُبتكر أو المبدع لو وصل بذكائه أن الحل يكمن في ضرورة مراجعة الإخوان والإسلام السياسي لتصورهم للدولة والحداثة والعلم، ويطالب بمراجعة العلاقة بين الدين والدولة، وموقف الإخوان والسلفيين من العلمانية؛ سوف يتم قمعه ويصبح كافرًا مرتدًا، أو ربما يقيمون عليه الحدّ بصفته واحدًا منهم انقلب على الإسلام وصار كافرًا بمقترحاته !
وقصة وجود هذه الخطوط الحمراء أمام أي متدين أو منضوٍ تحت لواء الجماعات، هي السبب الأزلي القديم والحديث لتكلس تلك الجماعات فكريًا، وتوقفها الزمني عند الدولة العباسية، وفشلها السياسي في إنشاء أي دولة أو حضارة مؤثرة.
المحطة الرابعة والأخيرة: هي انشقاق الإخوان وفقًا لتوصيف الأستاذ “طارق أبو السعد” الخبير بشؤون الجماعات قوله: “إن الجماعة تعاني من انشقاق حاد في هيكلها التنظيمي؛ فهم وبعد فصل طويل من الاتهامات المتبادلة تحولوا إلى ثلاثة جبهات تنظيمية، تدعي كل منها أنها الممثلة الشرعية لجماعة الإخوان، وحارسة أفكار المؤسس “حسن البنا”؛ الأولى: جبهة نائب المرشد والقائم بأعماله “إبراهيم منير” والمستقر في لندن. الثانية: جبهة أمين عام الجماعة السابق “محمود حسين” والمستقر في تركيا. الثالثة مجموعة المكتب العام وهم بقايا مجموع “محمد كمال”، الذي كان يدير بمجموعته الجماعة في الفترة من 2013 وحتى قبيل مقتله في 2016، والمعبر عنها “محمد منتصر” المتحدث الرسمي الأسبق للجماعة”.. انتهى (مقال في صحيفة العين بتاريخ 18 مايو 2022)
وبرأيي أن هذا الانشقاق هو تعبير عن المحطات الثلاث الأولى التي هي في جوهرها أزمات يعاني منها الإسلام السياسي في منظوره الضيق ناحية السياسة والدين، وطريقة حل المشكلات، فحين تنشق المجموعات بهذه الطريقة التي ينعدم فيها الحوار، ويصل فيها الجميع لوضعية الصراع، تخلق كل مجموعة لنفسها (هوية مختلفة) تتصارع مع الهويات الأخرى، لكل هوية منها أسلوب وخصائص مختلفة، والثابت أن وصول الجماعة لهذه الحالة لم يكن له أن يحدث لولا الفشل الثوري المتكرر، وعدم إيجاد أي ضغط مؤثر على السلطة المصرية يدفعها للتراجع، أو يجعلها تفكر فيه أو تطرحه للمناقشة والاحتمالات؛ فنحن أمام جماعة قياداتها (متعددة الهوية)، ليس كما حدث سابقًا قبل يناير 2011 أنه مجرد خلاف وتباين في وجهات النظر بين “القطبيين والبناويين”، وقد سبق لي تحليل هذا الأمر بوصف ما يمر به الإخوان من خلاف بين القطبيين والبناويين أنها مرحلة صراع على احتكار منهج المؤسس، لكن هذا الخلاف سيتطور لاحقًا حول تقليد متصارعي هذه الحقبة؛ مما يؤدي للانشقاق أكثر، وبناء هويات مختلفة بأثر التقليد الحرفي وعدم التفكير والنقد لرموز هذا الصراع.
وتبقى مشكلة الإخوان الأبدية؛ هي خلطهم بين الدين والدولة، وتبعات ذلك من إضفاء القدسية على أفعال الحكام والأمراء ونتائجه في عدم القدرة على نقد السياسات والاعتراض على أفكار الأقوياء والنافذين منهم، وما يتعلق بذلك من غياب الحريات والمنافسة والدافع، وبالتالي لا يمكن تصور أي مستقبل للإخوان في مصر وجماعات الإسلام السياسي ككل، إلا إذا تحولت مصر جذريًا لدولة كهنوت ديني، وتم إلغاء الدستور وإعلان المسيحيين أهل ذمة وفرض الحجاب على نسائها. فحتى مع وجود محاولات نشطة لتحقيق ذلك، لكن هوية الدولة لا زالت راسخة في ضمير الشعب ويحميها الجيش بصفته الحارس ضد الفوضى والجماعات الدينية، علما بأن تلك الهوية شكلها المصري على مدار 200 عام منذ تبني الوالي “محمد علي باشا” مشروعًا لإيجاد دولة متقدمة تنافس أوروبا، ومن الصعب بعد رسوخ هذه الهوية في ضمير المصريين وتبني مؤسسات الدولة لها وفهم النخبة المثقفة لتحدياتها أن تتحول مصر لدولة دينية بمجرد رغبة جماعة عرضنا في هذا المقال جانبًا من أزماتها.
وأختم بأن قد الإخوان تخطوا مرحلة التربية ودخلوا مرحلة الصراع والسياسة منذ يناير، وانغمسوا في طُرقها وأساليبها الحربية الملحقة بها؛ أي أن عناصر وقيادات ونخبة الجماعة لا تعطي أولولويات التربية على أجنداتها أكثر من الغرق في دهاليز السياسة وآلام الصراع مع الغير، علمًا بأن الأدب الإخواني هو أدب مستقل عن المحيط الاجتماعي، وقد كانوا يهتمون بالتربية قبل ثورة يناير، وبعد الثورة انقلب هذا الاهتمام إلى أعمال شكلية بعيدة عن جوهر التربية.
ويمكن ملاحظة ذلك في التحول الأخلاقي السريع عند الإخوان، لدرجة أنه يمكن تصنيف فترة نضوجهم الأخلاقي إلى مرحلة ما قبل ثورة يناير 2011، وهي فترة ضعفهم وحاجتهم للمجتمع التي تحدثنا عنها بوصف “مرحلة الدعوة”، التي تختلف جذريًا عن مرحلة الدولة كما اعترف بذلك المرشد الأسبق “مصطفى مشهور”. فالأخلاق كانت براجماتية عملية للدفاع عن النفس ولفتح الأبواب أمام الانتشار، ولكن بعد أن ثار الشعب عليهم في يونيو 2013 أصبحت الأخلاق في قوام الوعي الإخواني لا معنى لها، فقتل المسيحي والشيعي أصبح حلالاً والتبرير جاهز؛ أن الأقباط والشيعة لم ينتخبوهم وتظاهروا ضدهم في الشارع، والشتم والكذب وسيلة للانتصار على الأعداء ونصرة ما يعتقدونه أنه”دين الله”؛ حتى لو تطلب ذلك الاعتماد على النصوص الدينية الضعيفة والموضوعة ومحل الشبهات.
فهل نقول بعد ذلك أننا بحاجة إلى استعداد جدي إلى نتائج انهيار الأخلاق عند هذا الفصيل؟ وهل يمكن توسعة هذا الانهيار حتى يشمل المتعاطفين معهم؟
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.