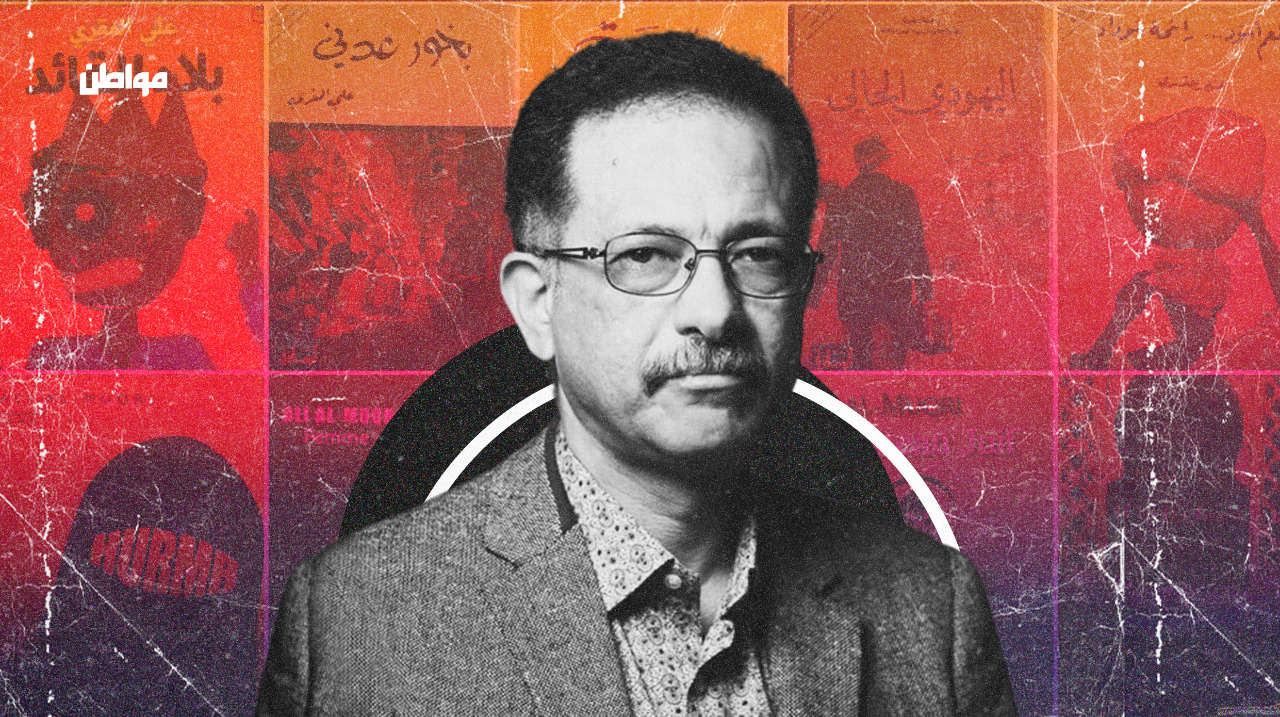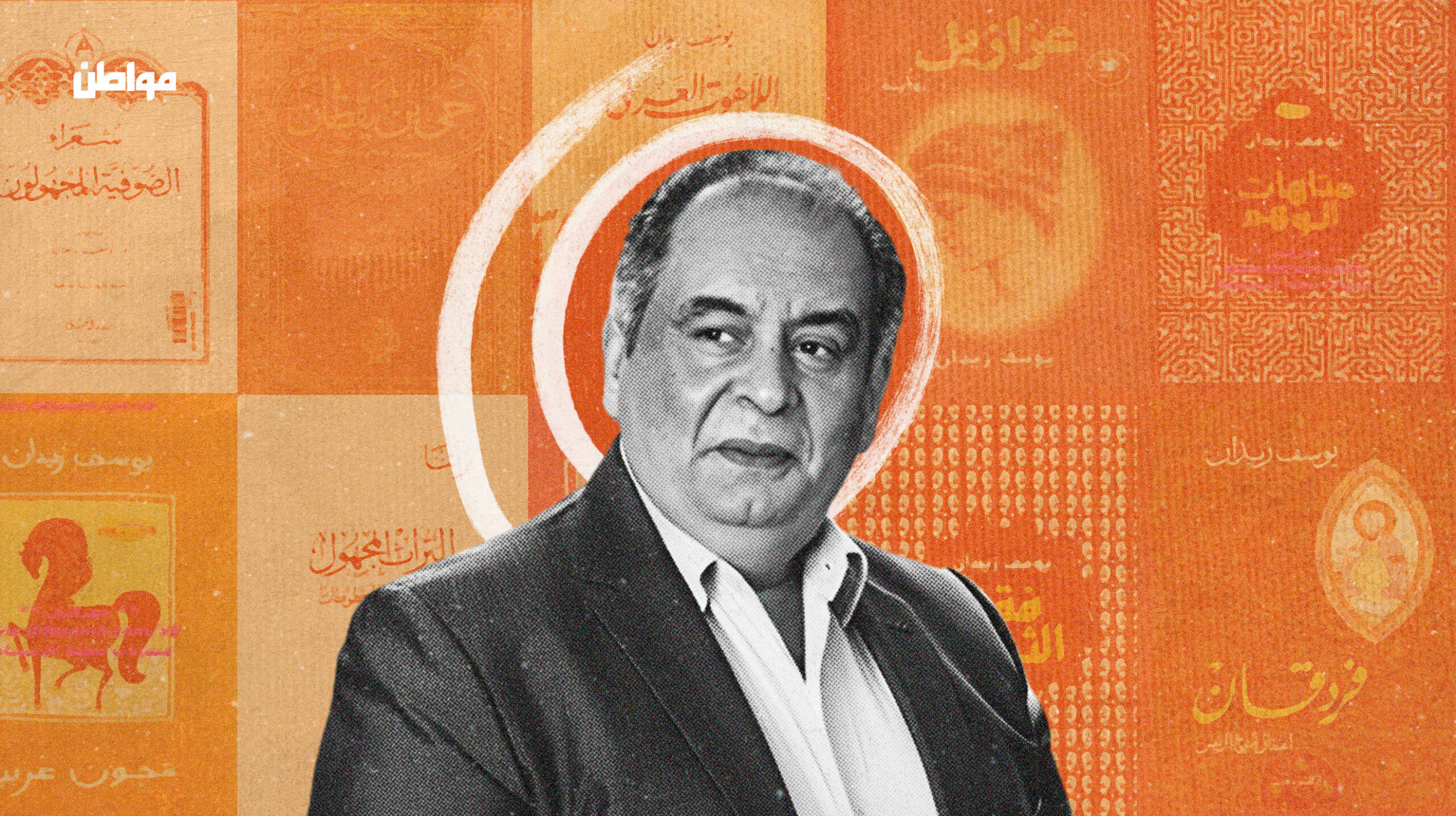نشر الكاتب والناشط الاجتماعي محمد عوض في “مواطن” مقالا بعنوان: التعبير الفني.. هل ينبغي أن يكون هادفًا؟ أم حرًا؟ يدرج المقال ضمن حقل فلسفة الفن. ومحمد عوض ليس بعيدًا عن الفلسفة؛ بل أتى من داخلها، وقد بسّط في مقاله قضايا ترتبط بالفن والجمال وعلاقته بالمنفعة والأيديولوجيا، ومن ثمَّ علاقته بالخير والشر وغيرها من القضايا المجردة التي قد لا تروق للمزاج الشعبي، وهي على تجريديتها إلا أنها في غاية الأهمية؛ إذ لا تمدّن ولا مواطنة دون الاعتناء بالجوانب النظرية، وقضايا الحوار في الفن لا تعرف الأبواب المغلقة، وحيويتها وتجددها بتجدد الحياة وتجدد الخبرة الجمالية والفنية.
خلا المقال من الأمثلة الحسية واكتفى بسرد الأفكار، وعلى الرغم من حياديته في أغلب أفكاره إلا أن القارئ يعثر على مواقع يعلن فيها عن تحيزه للفن الحر من القيود التي تتجلى بعناوين متباينة، مرّة باسم المنفعة ومرة باسم الضرورة الاجتماعية ومرة باسم المطالب الإيديولوجية. وهو مع طيران الفنان في سماء الإبداع دون قيود، وبالضد من الإكراه والإملاء في الفن، وعلى الفنان أن يصغي لصوته الداخلي وتلقائيته، ويترك ما عداه حتى يحافظ على حريته.
ورغبتي من هذا المقال الذي يأتي على هذه الصورة التعقيبية على مقال محمد عوض أن يصب في مجرى ممارسة الحوار المثمر الرامي لتوسيع المعنى والأفكار في المقال المنشور، كلما وجد مناسبة تستحق الحوار، أو كلما وجد جدوى في طرح السؤال، وسوف تكون البداية مع العنوان والحوار معه على صيغة سؤال على النحو الآتي:
هل الأعمال الفنية العظيمة التي كتب لها الخلود وتخطت الزمان والمكان؛ مثل الجريمة والعقاب لديستوفيسكي خالية من المقاصد والقيم؟ أم أنها محملة بالقيم؟
وينطبق هذا الأمر على الإخوة كارامازوف، ومن ثم؛ هل الهدفية الموجودة في هذه الروايات أخلت بحريتها وفنيتها؟ ومن الصعب التدليل على أن لوحة الجورنيكا لبيكاسو هي لوحة فنية خالصة؟ فهي على تجريديتها إلا أنها مشحونة بقيم ورسائل موجهة للمتلقي الرائي، وإن بطريقة غير مباشرة فهي بالضد من الحرب بكل المقاييس وصورت وحشيتها. ولعل أقرب مثال لنا في السرد المصري رواية عزازيل ليوسف زيدان؛ فهل هي من الروايات الفنية الخالصة التي تجردت من المرامي والأهداف؟
إذا كان الجواب بالنفي؛ فهل هذه الهدفية أضرت بفنيتها وحريتها. إن أغلب النقاد اتفقوا على فنيتها الممتازة، وهي بالضد من التعصب الديني والتطرف الذي يسمح بقتل وإبادة الناس باسم الدين الحق وما عداهُ باطلٌ.
ويبقى السؤال؛ هل الفن الهادف هو فن يفتقد للحرية، وهل هذا الأمر ينطبق على الأعمال الفنية؟ أم أن الفن العظيم يستطيع أن يجمع بين الهدفية والحرية؟
يرى محمد عوض في مقالته أن الفصل بين الفن ونتائجه مسألة مهمة، وتفسير الفن وفق نتائجه مسألة لا ترضيه، ولعل القارئ سوف يضع سؤالًا:
هل الفن الذي لا يترك تأثيرًا ولا نتائج، هل هو الفن المطلوب؟ أم أن من ينظر في الفن عليه أن لا ينظر لنتائجه؛ بل ينظر إليه في ذاته وباستقلال عن النتائج؟ فهذه الطريقة في النظر سوف تحميه من السقوط في الهدفية، وهل يمكن أن ندرج هذه الفكرة ضمن التيار الذي يقول الفن من أجل الفن بغض النظر عن المقاصد والنتائج؟ – هذه مسألة -، المسألة الأخرى هي أن المقال يريد للفن أن يطير إلى سماء الحرية المتحررة من قيود المنفعة والشرطية الأخلاقية، وغيرها من القيود التي تحدّ من حرية إبداع الفنان، ويرى أن هذه النزعة كانت خافتة في الماضي
أما في التاريخ الحديث والمعاصر فقد تطاولت هذه النزعة وتمكّنت. هل هذه النزعة هي السائدة الآن؟ أم أن هناك من لازال من لا يجرد الفن من هذه القيم؟ وهل خلت الروايات والأعمال الفنية من القيم؟ ويمكن للمتتبع لجوائز نوبل في الأدب أن يطمئن إلى أن الروائيين الذين اُعطيت لهم حضرت في أعمالهم القيم الفنية والجمالية؟ ولكن القيم الإنسانية لم تغب، ولعل أقرب مثال الروائي والأكاديمي (عبد الرزاق قرنح)، الذي مُنح جائزة نوبل في الأدب في 2021م، وأغلب رواياته تعكس كفاح الأفارقة للتخلص من جلودهم الاستعمارية، وما لحق بهم من قهر وفقر وحرمان وقمع والنضال العنيد لتأسيس هوية جديدة.
والقارئ لا ينكر أن هناك لوحات فنية تزعم أنها كيان من الجمال الخالص؛ مثل لوحة هانز هوفمان (فوران)؛ فهي لوحة بلا موضوع ،تتضمن خليطًا عجيبًا من الألوان، صورت في حالة من الفوران. ويزعم رسامها بأن يبقى الرائي في مجال المتعة الخالصة للفن، ولكن هناك حذاء الفلاحة لفان جوخ المعبرة عن معاناة الفلاحة في العمل على الأرض. وباختصار؛ فإن المشهد الفني لا يمكن أن يحسب بقضه وقضيضه لصالح هذا النزوع الجمالي الخالص الذي يسرح ويمرح باسم الحرية.
والمقال نفسه يقر بأن الجدل لازال قائمًا حول ما إذا كان للفن غاية في ذاته؟ أم وسيلة يخدم اتجاهًا ما؟ وبعد فالمقال يترك مسألة التباين في النظر إلى الفن من منظور الجمالي والنفعي، وينتقل الى المتلقي الأخلاقي والمتلقي الجمالي، وعلى الرغم أنه يقر بالالتقاء بينهما، إلا أنه يقر بأن المتلقي الجمالي ينظر الى الفن بوصفه معطى جماليًا في كليته بغض النظر عن انبعاثاته التي قد لا تكون أخلاقية أو نفعية.
وهذا القول يحتمل أن يكون أخلاقية أو نفعية، ومن المعقول القول بأنه لا يوجد نص نقي مئة بالمئة يصدح بصوت الجمال الخالص؛ فالقيم الإنسانية الكبرى هي جمال أيضًا من منظور فلسفي عميق، ويصرح المقال بأن من خلطوا بين قيم الجمال والحق والخير وقعوا في خلل منهجي، ومن الصعب تأييد هذا القول؛ إذ لا خلط هنا؛ بل كل فيلسوف يسعى لخدمة منظومته الفلسفية وتعزيز عناصرها الداخلية، ومن ثم فإن مرجعيات الأمم الكبرى لها تصوراتها الخاصة عن الحق والجمال والخير وغيرها من القيم الإنسانية؛ فهذا الفيلسوف أو ذاك يحاول أن يقدم رؤية فلسفية تحاول أن تكون منسجمة مع نفسها، ثم أن المقال يرى أن الحق هو ميدان العلوم، والأدق أن الحقيقة هي ميدان العلوم؛ فالحق أقرب إلى السياسة والقانون.
كما يرى المقال أن هناك تحولات تجري للجمال يقول بالفصل، إلا أنه يقر بالتداخل -ليس بالضرورة أن يكون الجميل خيرًا، كما ليس بالضرورة أن يكون الخير جميلًا-، ويفهم القارئ من ذلك أن الجميل ممكن أن يكون خيرًا، بمعنى أن الجميل لا يخلو من صفة الخيرية. وهذه المسألة فيها جدال لم يحسم بعد. ولعل سبب الجدال واستمراره هو التعقيد الذي يلف مثل هذه القضايا؛ إذ هناك تداخل بينها، وليس هناك تناقض حاد، ونعثر في بعض المواقع في المقال تأييد للتداخل.
أما عن تذبذب سنتيانا بين التصور النفعي والأخلاقي والجمالي في الفنون؛ فإن السياق اللاحق لا يظهر أي تذبذب، بل يظهر اتساقًا؛ فسنتيانا ينادي بالرجوع إلى الطبيعة البشرية؛ فهي ما يدفعنا ويحثنا على الجمال، لكن ما يحدث هو قتل هذا النزوع الكامن في طبيعتنا بمشاغل خارجة عن الجمال، وبمطالب أيديولوجية لا تكترث بهذا النزوع الإنساني للجمال، فضلًا عن إلحاح سنتيانا على ضرورة التحرر من التعصب للأفكار الضيقة من أجل التفاعل مع التجربة الجمالية، بوصفها عملية موحدة ومترابطة، وما يفسدها هو المشاغل الخارجة عنها؛ فيفوت ذلك على الإنسان الشعور الموحد والعميق بالجمال.
ولعل تولستوي من النماذج الواضحة في تأييد البعد الأخلاقي في الفن. وهذا التأييد لم يمنعه من إنتاج أعمال فنية خالدة مثل أنا كارينا - الحرب والسلام
وسنتيانا مع ألا يظهر البُعد النفعي في الفن بطريقة مباشرة؛ بل بطريقة غير مباشرة، وينبثق من داخله ليمثل المغزى العام، على ألّا يكون ذلك على حساب معايير الفن والجمال. أما عن رأي سقراط فهو ليس من أنصار ربط الفن بالمنفعة والفائدة فحسب مثلما يذهب المقال؛ بل يطالب الفنان بأن يسهم في تعزيز الفضيلة وخلق الناس الفضلاء.
وأفلاطون لم يبتعد في هذا المضمار عن أستاذه؛ إذ اعترض في الموسيقى على تلك المقامات الموسيقية التي تبث الرخاوة والنعومة في النفوس، وألح على المقامات التي تشد أوتار النفس فتقوي الإرادة في الإنسان. وباختصار إعداد شجعان لا جبناء من أجل القتال.
وبالعودة إلى سنتيانا فإنه يرى أن الاستجابة للمطالب الأيديولوجية وضرورات الواقع الضيق يفوت على الإنسان ملامسة الواقع الحي والمتجدد، والخداع الذي يصدر عن التضليل الأيديولوجي؛ فمثل هذا الفن يخسر نفسه ويفقد هويته الجمالية، ويصبح غير مقبول.
إن المقال يحذر من ذلك المتشدد الذي يتمسك بالأبعاد الأخلاقية، لأن هذا التمسك لا يترك فرصة تسرب الشر والانتصار له، لكن هذه النظرة للفن ليست بالضد من تصوير الشر ولا الانتصار له.
لكن ماذا عن المغزى العميق للفن؟ ولعل تولستوي من النماذج الواضحة في تأييد البعد الأخلاقي في الفن. وهذا التأييد لم يمنعه من إنتاج أعمال فنية خالدة مثل أنا كارينا – الحرب والسلام. وبالمناسبة فإن تولستوي يرى أن الفن يرفع من درجات الإحساس بالمحبة والأخوة والتعاطف بين البشر، ويبثها في المتلقي وعظمته تكمن في قدرته على توصيل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة.
والمقال وجد أنه من المناسب أن يعرض فلسفة هيغل عن وظيفة الفن وحقيقة هذا الوعي الفني؛ فالفن هو توق الروح للتعبير عن نفسها في الفنون من عمارة ونحت ورسم وموسيقى وشعر، وهي تمتطي هذه الوسائط لتظهر قدرتها وحريتها، والوعي يحرر المادة من ثقلها؛ ففي النحت يحول النحات بإزميله المادة العمياء إلى تمثال غاية في التناسق والتناسب، وتغزّل هيغل في جمالية الوجه الإغريقي، وفي الموسيقى يحرر الصوت من خشونته الطبيعية ويحوله إلى صوت فني يهز المشاعر والوجدان؛ فالموسيقى ليست فن الشعور بل التأمل، وحتى الفم البشري بفضل التدريب العميق يتخلى عن وظيفته البيولوجية ويتفجر بالنغم العميق والجميل كما هو في الصوت الأُوبرالي، وهيغل لا يجرد الفن من وظيفته؛ إذ يرى أن الفن يلطف أوحش المصائر، ويخفف من ثقلها على النفس، بمعنى آخر يحررها من الأحزان الغبية؛ إذ تصبح الأحزان والأوجاع المهولة لها معنى يسمح بتجاوزها، ثم أن هيغل لا يتردد في أن يلح على ضرورة أن يلتزم الفنان وهو يرسم المسيح برسم صورة إيجابية عنه، تؤكد قوة تحمله وتجلده وصبره اللامتناهي في مواجهة الصَلب وبكل كبرياء وإباء، ولا يرضى بتصويره في حالة ذل وخنوع مطأطئ الرأس.
ولا يخفي المقال تلك الحقيقة التي تذهب إلى أن الفنان إنسان لا يمكن أن يكون عديم الفكر والأخلاق، أي أنه بالضرورة سيتطرق لقضايا معينة قد تبدو هذه القضايا متعلقة بالمجتمع وقد تكون بعيدة عنه.
إن هذا الإقرار من المقال يجعل مسألة القيم حاضرة، ومن المستحيل إهمالها والتعامل معها بوصفها فضلات يجب التخلص منها حتى يبقى الفن نظيفًا تفوح منه رائحة الحرية، والمقال يرى أن الفن الذي يتطرق لمشكلات اجتماعية هو الفن المفضل، لكنه يصدر حكمًا على هذا التفضيل، ويدرجه ضمن التفضيل السياسي والاجتماعي، والمقال على حيادتيه؛ إلا أن مزاجه مع حرية الفنان ولو كانت تحلق خارج المجتمع، ولا يهمها قضايا المجتمع؛ بل أن مثل هذا الفن يقع في مصيدة التحيز الأيديولوجي وضحية للتكلف الضار بالفن.
ورغم هذه الأحكام التي يمارسها المقال تحت عنوان الفن الحر؛ إلا أنه يحفظ ماء وجه الفن الهادف فيعلن: أن تلقائية الفنان وحريته أساسٌ في خلق الأعمال الفنية، ولا يمكن كسر هذه الشروط بالضرورة أو المنفعة… ولا يعني ذلك بالضرورة غياب الفن الهادف.
هل يعني ذلك الإقرار والاستدراك السابق أن هدفية الفن لا تتعارض على الدوام مع تلقائية الفن وحريته؟ وإن المبالغة في إقصاء القيم باسم الحرية هو خلل من المناسب والمنطقي أن لا نصرّ عليه؟
ومن التجربة الفنية والإجمالية للفنون نرى أن وظيفتها النفعية ومراميها لا تظهر بمستوى واحد من التطابق؛ فالعمارة مثلًا مهما تطورت وتمادت في تجريديتها لا يمكن أن تسقط وظيفتها؛ فعجائب الدنيا السبع على جلالها وجمالها إلا أن ذلك لا يجعلها بلا وظيفة؛ فسور الصين العظيم له وظيفة الحماية. والموسيقى على خصوصيتها وقدرتها على متعة الوجدان والضمير والعقل، لكنها يمكن أن توظف في نواحٍ طبية؛ مثل علاج التوحد والاكتئاب؛ وخاصة الموسيقى المرحة والحيوية مثل مقطوعات موزارت، على الرغم أن موزارت حين ألفها لم يضع في باله أنها يمكن أن توظف لنواحي طبية، وقد أدرك الفارابي صاحب كتاب (الموسيقي الكبير) تأثير الموسيقى على المزاج الإنساني.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.