في كتابه “الامتلاك أو الوجود”؛ يقسم إيريك فروم أنماط حياة البشر من زاوية علاقتها بما حولها، إلى نمطين نعرفهما من العنوان. في النمط الأول، الامتلاك، تدخل الذات مع الآخر في علاقة قائمة على الاستحواذ. ومفهوم الذات المستحوٍذة لا يقف عند الفرد؛ بل ينسحب على المجتمع ليشمل كل ما فيه من أفراد ومؤسسات طبيعية واعتبارية، هذه الذات subject لا تعترف بأي ذات أخرى؛ فكل ما حولها، من البشر ومن الكائنات الحية والجمادات والقيم والمفاهيم وحتى الأنشطة، هي مواضيع objects جامدة وناجزة، لاستعمالها ولتعظيم رأسمالها الرمزي حسب تعبير بورديو؛ فالأب يستعمل زوجته وأبناءه كأدوات لزيادة رصيده الاجتماعي، والحاكم يستعمل شعبه أدوات لتثبيت وتمديد سلطته، وصاحب رأس المال يستعمل موظفيه كأدوات إنتاج لتضخيم ثروته، هذا عدا عن سعيه الحثيث لابتلاع الكوكب بما فيه من أشجار وأحجار وأنهار، والرجل الأبيض يستعمل شعوب العالم الثالث أدوات لبناء حضارته وتأكيد تفوقه، والمتدين يستعمل المختلفين كأدوات للوصول لفردوسه
والمثقف يستعمل المفاهيم كأدوات لتعزيز آيديولوجيته، والمثالي يستعمل القيم كأدوات لتحقيق يوتوبياه. أما النمط الثاني؛ الوجود؛ ففيه تتعامل الذات مع ذوات أخرى حيوية ومتطورة، تحترم وجودها وتعي استقلاليتها وتدرك ديناميتها وتتفاعل مع تغيراتها. المرأة والطفل والمواطن والموظف وعناصر البيئة والكافر بمعتقداتنا والقيم والمفاهيم، كلها كيانات لها وجود خاص متطور بهيراقليطية لا مجال للقبض عليها أو حبسها في قفص التعريف والاستملاك. وبعكس النمط الامتلاكي الذي يكتسب فيه الإنسان قيمته من ملكيته لموضوعات خارجة عنه، يبقى على الدوام في حالة خوف من فقدانها، تصدر قيمته في النمط الوجودي من تجاربه الداخلية وخبراته التفاعلية التي تعمّق مداركه وتنمي أمانه النفسي. على هذا الأساس، يكون الأب حرًا من التجنيد الذاتي الذي غالبًا ما يفرضه الآباء على أنفسهم لحراسة أبنائهم ومنعهم من الخروج عن حدود إرادتهم وملكيتهم. ومثله يفعل الحاكم والتاجر والرجل الأبيض.. إلخ. وهكذا يعيش الكل حياته كتجربة متدفقة بالحياة والحب والحرية، مفعمة بالنشاط الخلاق.
حسب الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية التي قام بها العلماء خلال القرن التاسع عشر، ومن أبرزهم السويسري يوهان باخوفن، فإن المجتمعات الأمومية التي عاشت قبل أكثر من عشرة آلاف عام، كانت محكومة بمنظومات اجتماعية قيمية وسلوكية تختلف عما عرفناه منذ حدث الانقلاب الذكوري وحتى اليوم؛ فقد كانت الأخلاق نابعة من الحرية لا من الطاعة، وأفراد المجتمع يعيشون في حالة من الشراكة والوئام بعيدة كل البعد عن التنافس والتحاسد الذي نعيشه اليوم، وكانت العلاقات مصبوغة بالقبول والحب اللامشروطين، لا تعكرها مكاسب متبادلة تعكس واقعًا نفعيًا مختبئًا تحت قناع التراحم التجميلي.
بالنظر إلى صفات المجتمعين؛ الأمومي والأبوي كما ساقها باخوفن، وسمات النمطين الوجودي والامتلاكي كما نظّر لها فروم، أجد أن هناك تماثلًا بالمقاربة على التوالي. لذا أزعم – وهذا افتراض أساسي في هذا المقال – أن المجتمعات الأمومية كان نمط حياتها وجوديًا، وقد انقلب إلى نمط امتلاكي مع الانقلاب الذكوري الذي أسس مجتمعات أبوية نعيش اليوم تحت ظلها.
اللوحة أعلاه معروفة باسم “الإحسان الروماني The Roman Charity”، وهي تصوير لحكاية رومانية كتبها الكاتب فاليريوس ماكسيموس عن عجوز يدعى سيمون، حُكم عليه بالموت جوعًا في السجن، ولم يُسمح لأحد بزيارته سوى ابنته بيرو. فكانت تزوره يوميًا، ولتنقذه من الموت كانت ترضعه من ثديها خفية عن عيون الحراس.
في رأيي أن هذه اللوحة تعبر عن صراع بين القيم الأبوية والقيم الأمومية، تكون الغلبة فيها للأخيرة؛ حيث تحيي فيها المرأة مبادئ الماضي البعيد، عندما كانت ثقافة الأم الرحيمة هي السائدة؛ فالأب سيمون يرمز للنظام الأبوي الذي يختزل جسد الأنثى في الوظائف الجنسانية، أما ابنته بيرو فترمز للنظام الأمومي المنفتح؛ لا على أنسنة الجسد البشري فحسب، بل على أنسنة كل عناصر البيئة. من زاوية جنسية، تتحدى الابنة أباها؛ هو يرى ثدييها غرضًا جنسيًا، ملكية مكتوبة باسم الزوج، يجب إخفاؤهما عن كل ما عداه من الرجال؛ خصوصًا عنه هو، الأب مصدر السلطة والهيبة. وهي، بوعيها النسوي، وبإدراكها لوجودها كذات مستقلة، ترفض هذه النظرة المستلِبة لجسدها، وتفرض رؤيتها العشتارية للثديين كمصدر للغذاء والحب والتعاطف؛ فتلقمه إياهما لتقتل جوعه، فيرضخ لكرمها.
رؤيته لثدييها ومصهما قد يحرك فيه غريزته الجنسية، لكن الابنة لا تكترث باعتبارات الحشمة الذكورية، ولا رغبة لديها حتى في محاكمة شهوته؛ فالمحاكمة والمعاقبة سلوكيات أبوية تأنف المرأة منها، كل ما يهمها هو أب ضعيف تريد إنقاذه. يظهر هذا من التفاتتها باتجاه يمنع التواصل البصري بينهما، ويوصل رسالة مضمونها أن إنقاذها إياه نابع من حب لا تشترط فيه مذلته، ولا تنتظر بعده شكره. من زاوية اقتصادية تحكر المنظومات الذكورية، القدرة الإنتاجية على الرجل، وتعيق المرأة عن ذلك، جاعلة منها عالة على الرجل، يعطيها متى شاء ويمنع عنها متى شاء، وفي الحالتين هو الغني المالك وهي الفقيرة المملوكة. إرضاع الابنة أباها، يرمز لانقلاب اقتصادي؛ حيث صارت المرأة هي المنتجة للغذاء الغنية به، والرجل مفتقر إليها. ولو تعمقنا أكثر، نلاحظ في النموذج الأول أن الرجل يعطي المرأة مالًا ليستمتع بجسدها، وفي النموذج الثاني المرأة تغذي الرجل حليبًا بلا مقابل.
لا تكترث الابنة لاعتبارات الحشمة الذكورية، ولا رغبة لديها حتى في محاكمة شهوة أبيها؛ فالمحاكمة والمعاقبة سلوكيات أبوية تأنف المرأة منها، كل ما يهمها هو أب ضعيف تريد إنقاذه.
المال أوراق قيمتها اعتبارية يكسبها الرجل من جهده لا من ذاته، وهو يملكها؛ لذا فحين يبادل بها جسد المرأة فهو يفترض بهذه الصفقة امتلاكه جسدها، أما الحليب فهو غذاء قيمته واقعية ينبع من ذات المرأة، وهو قابل للتدفق بلا انقطاع، بانسيابه من حلمتها إلى شفتي الرضيع، تعيش المرأة تجربة من التجلي العاطفي لا تضاهَى، لذا فهي حين ترضع طفلًا، فإن سعادتها بالعطاء تساوي سعادته بالأخذ. وهذا يعزز فكرتي أن الابنة بإرضاعها أباها، انقلبت على المبدأ الذكوري الاستملاكي؛ “المال مقابل الجنس”، لتطلق مبدأها الوجودي “الكل يستحق الغذاء والحب”.
من زاوية سياسية، ككل الأنظمة الأبوية التي تعامل بلدانها كإقطاعية خاصة، يملك حاكمها الأرض ومن عليها، أنزل الحاكم الروماني بسيمون عقوبة الموت جوعًا. وعلى عكس رغبة الحاكم في امتلاك شعبه، وعلى عكس القيم الأبوية القائمة على معاقبة كل عاصِ أشد عقوبة، كانت بيرو ترى أباها ذاتًا مستقلة لا أحد يملك حق التحكم بمصيره؛ بل على العكس من ذلك فهو يستحق الرأفة والرحمة الأموميتين.
انطلاقًا من تلك الرؤية الانتيغونية، تحدت بيرو سلطة الحاكم، وأشبعت أباها حين كان يجب أن يجوع، وأحيته حين كان يجب أن يموت. وهو تصرف يكشف عن عقلية ناضجة نفسيًا ومعرفيًا وأخلاقيًا، تدرك أن طاعتها للحاكم فيه حفاظ على حياتها، لكنها حياة تعيسة تكون فيها مملوكة لنظام أبوي قاسٍ. في حين أن عصيانه قد ينجم عنه حكم عليها بالموت، لكنه موت هانئ يحيي مبادئها ويسقي بذرة خلودها، وحسب تعبير أنتيغون، التي دفنت شقيقها متحديةً أمر الحاكم كريون الذي أمر بتركه ملقى في العراء، “أعرف أنني سوف أموت قريبًا، كيف لايكون الموت مكسبًا لمن تعيش وسط الأحزان مثلي؟ولكن؛ هل يوجد مجد أفضل من أنني وضعت شقيقي في قبره؟”.
إن سجن سيمون المميت إشارة إلى أن النظام الأبوي وحش يبتلع أبناءه ولا يشبع، فلا يستنقذهم منه إلا المرأة الوجودية بمنظومة قيمها الأمومية.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.




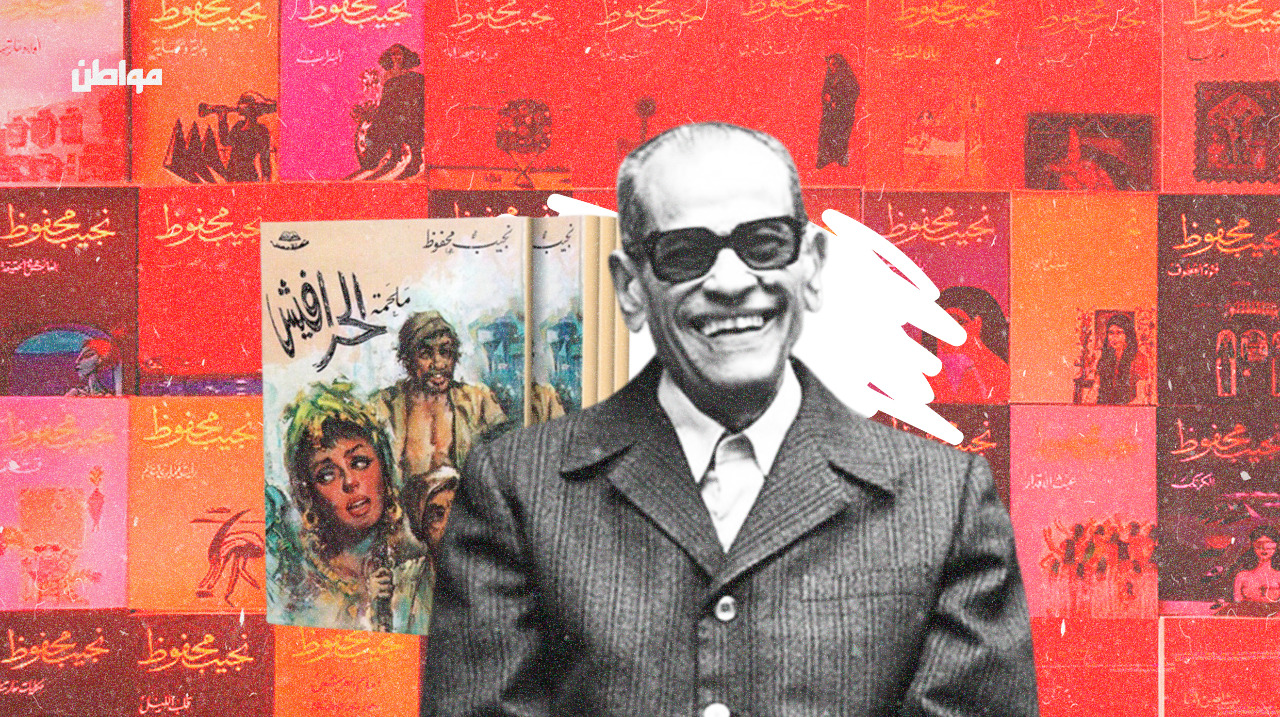



Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!