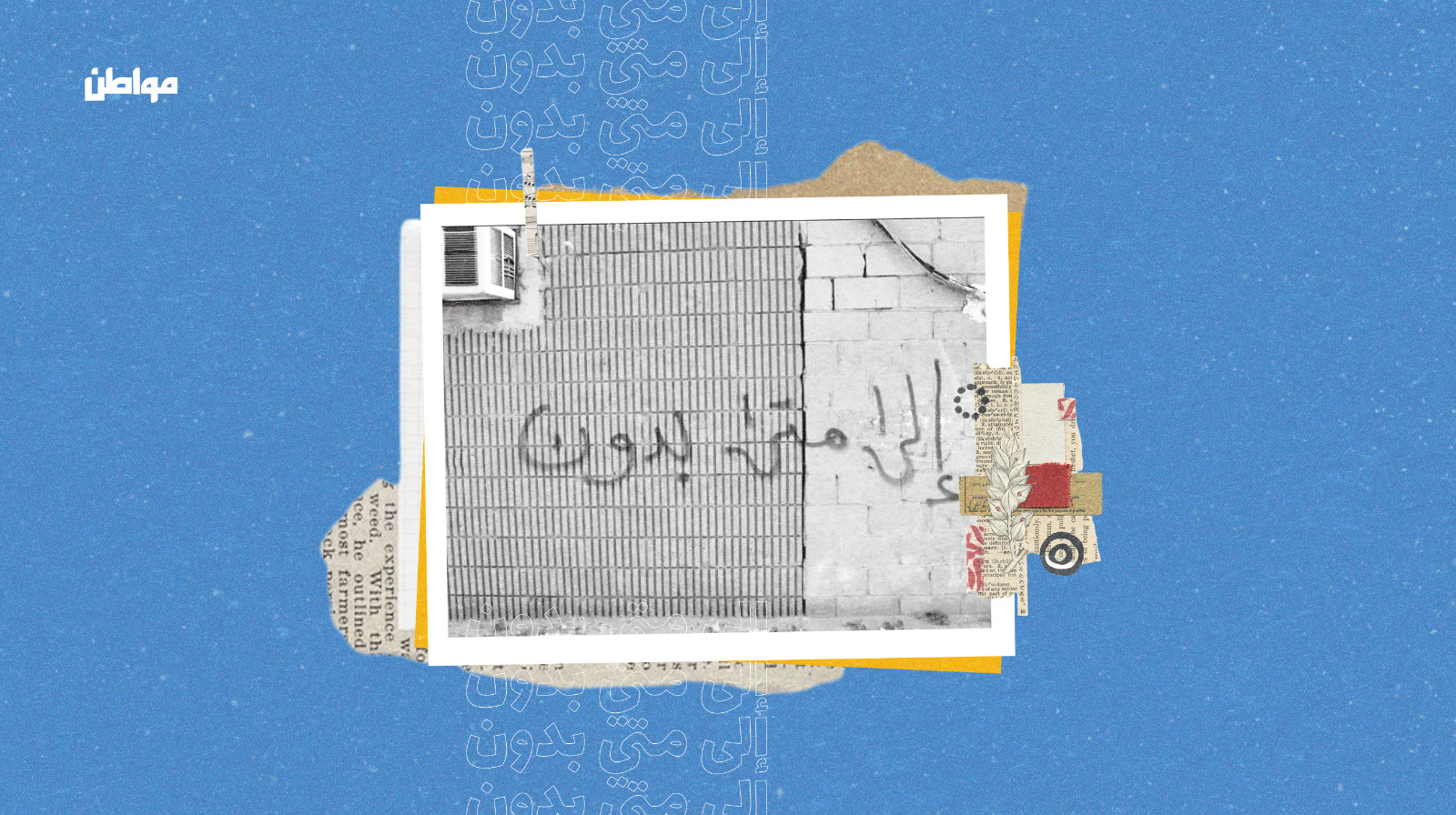تحرص “جوري” كثيرًا على أواني مطبخنا، تصر دومًا وبشدة على أن أعود بأي طبق أو صينية أكون خرجت بأحدها في زيارة ما محملة ببعض من أكلاتنا المنزلية، أسمع كثيرًا من سيدات أنهن لاحظن ذات الظاهرة؛ التصاق عاملات المنزل بأواني المطبخ، وكأن لهذه الأواني ألفة تبث في قلوبهن شيئًا من مشاعر الأمان والاستقرار.
نرتبط -نحن كبشر- بالأشياء المادية إذا ما عز الشعور بالأمان، وإذا ما تباعدنا ومواطننا وأماكننا التي اعتدنا عليها، ولربما هذا ما يدفع العاملات المنزليات للتمسك بطبق أو قِدر، والذي قد يشكل لها كينونة ثابتة في حياتها المتغيرة والذاهبة إلى المجهول. تذكرني هذه الظاهرة بفساد منظومة العمل المنزلي بأكملها في شرقنا الأوسط الداكن، بأن لا جانب من جوانب هذا العمل بصورته الحالية هو صالح إنسانيًا أو عادل قانونيًا، أو قابل للسيطرة أو التحكم فعليًا.
أكبر إشكاليات العمل المنزلي؛ خصوصًا في عالمنا الشرق أوسطي الأبوي والسلطوي النزعة، يتمثل في إقامة العاملة في منزل مستقدميها؛ مما يصعب عملية تمييز وفهم هوية هذه العاملة على أنها موظفة، ومما يسبغ مشاعر “العائلية” على العلاقة بها. الكثير من العائلات العربية، والخليجية تحديدًا، تفخر بمفهوم تحول العاملة إلى أحد أفراد المنزل، أنها أصبحت فردًا من أفراد العائلة، دون استيعاب أن هذه المشاعر هي في الواقع ما يعرقل تطبيق العدالة ويعطل الكثير من مفاهيم حقوق العمل.
حين تتحول العاملة من موظفة إلى فرد من أفراد العائلة، وغالبًا ما يتم هذا التحول من أول يوم لقدومها للمنزل محل عملها بسبب من دخولها المباشر في حيز العائلة الخاص، تشعر هذه العائلة بأن لها سلطة عليها تمامًا كسلطتهم على بعضهم البعض، وأن لهم الحق في فرض منظومتهم الأخلاقية والسلوكية عليها كي تندمج هي، طوعًا أو قسرًا في “عائلتها” الجديدة.
ولأن هذه العاملة تحيا معهم في المنزل دون أي فواصل تفصل حياتها عن حياة أصحاب المنزل، وساعات عملها عن بقية ساعات اليوم التي يفترض أنها ملك لها وموكولة لراحتها، تختلط المفاهيم كلها، وتتعزز فكرة عضوية هذه العاملة في العائلة، إلا أنها عضو في المنزلة الدنيا، العضو الذي يأمره الجميع، المتواجد دائمًا، المفترض به الطاعة المستمرة والذي لا تنتهي ساعات عمله أبدًا؛ فهو رهن الطلب في أي وكل وقت.
إن التواجد المستمر للعاملة المنزلية في محل عملها، المنزل المعني، لربما يمثل المعضلة الكبرى تحديدًا في مجتمعاتنا عشائرية الروح وأبوية السلوكيات؛ ذلك أنه حتى إذا ما تم إقرار قوانين عادلة تؤكد هوية العاملة المنزلية على أنها موظفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا “خادمة” بمضامين العبودية المقنعة؛ فإن مراقبة تطبيق هذه القوانين ستكون شبه مستحيلة؛ حيث لا يمكن فعليًا التحقق من أي اختلالات تطبيقية بسبب من خصوصية حيز العمل، سوى بشكوى من العاملة بحد ذاتها، والتي تعد -أي هذه الشكوى- عملاً غاية في الصعوبة ومصدر ذعر شديد لهذه الغريبة الوحيدة.
وعليه تندر الشكاوى من العاملات لعدة أسباب:
أولًا؛ يعتبر اللجوء لمراكز الشرطة في دولة غريبة، تتعثر العاملة في لغتها ولا تفهم قوانينها ومجريات أمورها مهمة مرعبة، ولربما معظمنا تذوق بعض رعبها إبان سفرنا في الخارج، وإذا ما أتت الحاجة للجوء للسلطات القانونية أو مراكز شرطة هذه البلاد الغريبة علينا، رغم أفضلية المنظومة القانونية الغربية.
ثانيًا؛ فإن الشكوى قد تكون عملية معقدة نفسيًا بالنسبة للعاملة التي قد تختلط عليها هي ذاتها الأمور الحياتية؛ مما يجعلها تستشعر مشاعر الانتماء للعائلة المعنية رغم معاناتها معها، وهي المشاعر التي قد تصعب عليها اللجوء للقانون في حال الإخلال بحقوقها، أو في حال إيذائها بأي صورة نفسية أو جسدية أو حقوقية.
كما وأن إقامة العاملة الدائمة في المنزل تصعب تحديد ساعات العمل؛ فيذوب اليوم في مجريات الحياة العادية، مما يجعل تحديد الساعات أمرًا عصيًا على كل الأطراف.
في جلساتنا النسائية، أسمع الكثير من النساء تتفاخرن بطيبتهن وحسن معاملتهن لعاملاتهن، و"لؤم" بعض العاملات تجاههن، غير مستوعبات أن الحديث بحد ذاته استشكالي في استعلائه وحس الملكية فيه.
هذا ويستخدم الكثير من مستقدمي العمالة المنزلية فكرة إقامتهن الدائمة عذرًا تبريريًا للكثير من السلوكيات المختلة حقوقيًا؛ فمثلًا قد يستشعر صاحب العمل أحقيته في أن يحتفظ بالأوراق الرسمية، والتي منها جواز السفر للعاملة، مثلها في ذلك مثل بقية أفراد المنزل، وخوفًا من هربها الذي قد يتسبب في مسؤولية قانونية و خسارة مالية كبيرة له. هذا ويستخدم الكثير من المستقدمين حجة اندماج العاملة في حياتهم اليومية، “هي تأكل من طعامنا، نحن نوفر لها كافة احتياجاتها الخاصة، نحن نهديها الملابس ونعطيها مبالغ مالية كهدايا بشكل مستمر”، لمنع بعض من حقوقها عنها.
فحين تختلط الصورة وتغيب فعليًا فكرة أن هذه العاملة هي موظفة بالأساس، تصبح حجة “كرم” الأسرة معها و”طيبة” سيدة المنزل تجاهها، و”هبات ونفحات” أهل البيت لها كلها كافية لاستيفاء حقوقها. لا يفرق المعظم بين صفة “الهِبة”، وصفة الاستحقاق المتمثلة في الراتب المستمر، والذي يجب أن يرتفع كل مدة، بالإضافة لاستحقاقات تحديد ساعات العمل؛ الإجازة الأسبوعية، استحقاقات نهاية كل سنة، استحقاقات نهاية الخدمة، إضافة إلى ضمان حقها في حرية التنقل وحرية المظهر وفي إنهاء ساعات عملها اليومية.
هناك مشاكل أخرى أكثر عنفًا وقسوة قد تترتب على الإقامة المنزلية؛ فالإقامة المستمرة تلغي كل الحواجز، مما يسهل التدخل في حياة العاملة الشخصية، ومراقبة أحاديثها التليفونية وطريقة ترتيبها لحياتها في حيزها الشخصي، إذا توفر هذا الحيز الذي كثيرًا ما يعز ويندر أو يتنافى مع أبسط قواعد صحية وراحة وخصوصية مكان الإقامة.
كذلك؛ فإن إقامة العاملة المستمرة قد تسهل عملية التحرش بها؛ خصوصًا في بعض المجتمعات التي تنظر لها فعليًا، بوجود نظام الكفالة السيئ في الكثير من الدول، على أنها شبه مملوكة، أو جزء من “الحريم” المباح. ومع التعود واستشعار “الألفة” يصبح التحكم في مظهر العاملة، مثل فرض الحجاب أو “اليونيفورم” الطبقي الكريه عليها، الصراخ في وجهها وتعنيفها اللفظي؛ بل وتأديبها الجسدي سلوكيات معتادة نوعًا، ليس فيه الكثير من الغضاضة؛ فهي “تعيش في بيتنا، وهي مثل بنتنا” وتأديبها هنا لربما يتحول في ذهن مستقدميها لتفضل أخلاقي وممارسة أسرية طبيعية.
في جلساتنا النسائية، أسمع الكثير من النساء تتفاخرن بطيبتهن وحسن معاملتهن لعاملاتهن، و”لؤم” بعض العاملات تجاههن، غير مستوعبات أن الحديث بحد ذاته استشكالي في استعلائه وحس الملكية فيه، وأن الطيبة ليست قانونًا يمكن الاعتماد عليه في كل البيوت وتحت كل الظروف، وأن ما يعرِّفنه على أنه لؤم؛ إنما هو ارتفاع صوت ومطالبة بحقوق تمامًا كما تطالبن هن بحقوقهن في مقار عملهن.
إقامة العاملات المستمرة في منازلهن وما يتبع ذلك من “إسباغ كرم” تقديم الفائض لهن، وإسباغ السيطرة على الحركة والسلوك والمظهر، وأحيانًا حتى على استعمال الهاتف أو التواصل مع الآخرين، كل ذلك يحول العلاقة إلى علاقة طفل وبالغ، حتى لا أقول (مالك وعبد)؛ مما يدخل كامل العلاقة في إشكالية حقوقية كبيرة، وفي منطقة غائمة يصعب خلال غيومها التحقق من سلامة وأمن واستكمال استحقاقات الطرف الأضعف.
إن الطبيعة العشائرية الراسخة في وعي شعوبنا العربية عمومًا، والخليجية تحديدًا تجعل من الصعب تقنين العلاقة بين المستقدم والعاملة، ومن العسير النظر إليها على أنها موظفة بالمعنى المكتمل للكلمة، ذلك أن نظامنا العشائري الراسخ لم يستوعب تمامًا فكرة العمل المستقل والتنظيم الإداري.
أذكر نفسي وأذكركم، هؤلاء السيدات المضحيات التاركات لحيواتهن وأسرهن، وكل ما يعرفن في الدنيا خلفهن من أجل كسب لقمة العيش، هنّ موظفات، وأجمل ما يمكن أن نقدمه لهن، وما نسبغه عليهن؛ هو احترامنا لهذه العلاقة.
نحن بعد لا زلنا ننظر لرأس السلطة على أنه أب أو شيخ قبيلة، وللحكومة على أنها نظامه المستوجب للطاعة، بعد نكرر جمل مثل “الله يخيلي حكومتنا”، أو “الله لا يغير علينا”، وبعد ننظر لمن ينتقد الدولة ونظامها على أنه خائن، قليل أصل خرج عن طوع رب نعمته، ومارق خرج عن نظام قبيلته ومجتمعه. بعد لا نفرق بين الوطن كمفهوم فلسفي ونفسي، والدولة كمفهوم إداري؛ فنحن رغم كل الأموال والتطورات، لازلنا في عمقنا نعيش بالمفاهيم الأبوية القديمة.
وعليه، سيصعب علينا كثيرًا الفصل في حيزنا المنزلي بين الطبيعة الوظائفية للعاملة وارتباطنا النفسي بها كشخص؛ ليس فقط معاشرًا لنا بشكل يومي، ولكنه مستضعف بيننا وتحت سيطرتنا التامة. فكرة أن العاملة هي شخص متساوٍ مع مستقدميها تمامًا، وأنها موظفة لها حقوق وعليها واجبات، وأن وظيفتها يفترض أن تقع تحت بند القوانين التي تنظم العمل؛ فتحدد ساعاته وأجوره الدنيا هي فكرة متعثرة في وعينا الهرمي الطبقي العشائري الأبوي.
نحتاج بلا شك لقوانين صارمة تنظم العلاقة لتحفظ حقوق الطرفين، ولترفع المسؤوليات عن صاحب العمل حتى لا يتحجج بها تحكمًا في حرية وأوراق العاملة في منزله. سيتطلب ذلك إلغاء تام لنظام الكفالة واستبداله بنظام عمل مدني ينظم المسؤوليات والحقوق، ويضع خطوطًا واضحة لها، خطوطًا لا تعتمد على “طيبة” أهل البيت أو “كرم” المجتمع أو ضمير المستقدم؛ إنما هي خطوط تراعي تمامًا حقيقة أن العاملة موظفة، وأن المستقدم هو صاحب العمل، وعليه فإن لهذه الموظفة كافة الحقوق التي يمتلكها صاحب عملها في وظيفته هو بحد ذاته، وأن حرية تنقلها ومظهرها وحيازتها لأوراقها وتحديد ساعات عملها، وحقها في استعمال هاتفها إلى آخره من الحقوق التي نعتادها نحن في وظائفنا هي حقوق لها كذلك لا تقل درجة.
شخصيًا، يصعب علي أن أنظر لــ “جوري” على أنها موظفة بالمعنى الرسمي؛ فهي في عمر ابنتي، وأنا أحبها محبة أمومية خالصة تختلف عن المشاعر التي يكنها الرئيس لمرؤوسه في حيز العمل الطبيعي. إلا أنني أحاول تذكير نفسي بشكل يومي بواقع العلاقة، بأنني لست أمها، وعليه فلا سلطات لي عليها مطلقًا، لا أخلاقية ولا نصائحية ولا حياتيه، وأنني إذا أكرمتها في شيئ فيجب أن أتذكر دومًا أنه كرم اختياري لم تجبرني هي عليه، وبالتالي لا يحق لي أن أطالب بحقوق أكثر في مقابله.
ورغم أنني أتضايق كثيرًا من خطيبها الذي تحكي هي أحيانًا، عنه والذي يبدو مراقبًا لها من بعيد ومحددًا لحراكها، ولاعبًا لدور الرجل “الحمش” رغم الأميال التي تبعدهما عن بعض، ورغم أنني “أزحلق” الكثير من ملاحظاتي “النسوية” والحياتية في حواراتنا معًا، علها تنتبه لسخف تحكمه، إلا أنني أعود فأراجع نفسي سريعًا وأحكمها بصرامة ألا تتطاول فتحول العلاقة إلى أمومية بحتة، علاقة رغم أن نفسي تجنح لها بطبيعتها، إلا أنها بكل تأكيد غير عادلة لــ “جوري”. أذكر نفسي وأذكركم، هؤلاء السيدات المضحيات التاركات لحيواتهن وأسرهن، وكل ما يعرفن في الدنيا خلفهن من أجل كسب لقمة العيش، هنّ موظفات، وأجمل ما يمكن أن نقدمه لهن، وما نسبغه عليهن؛ هو احترامنا لهذه العلاقة ولهذه المسافة ولهذا المقام العملي بيننا.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.