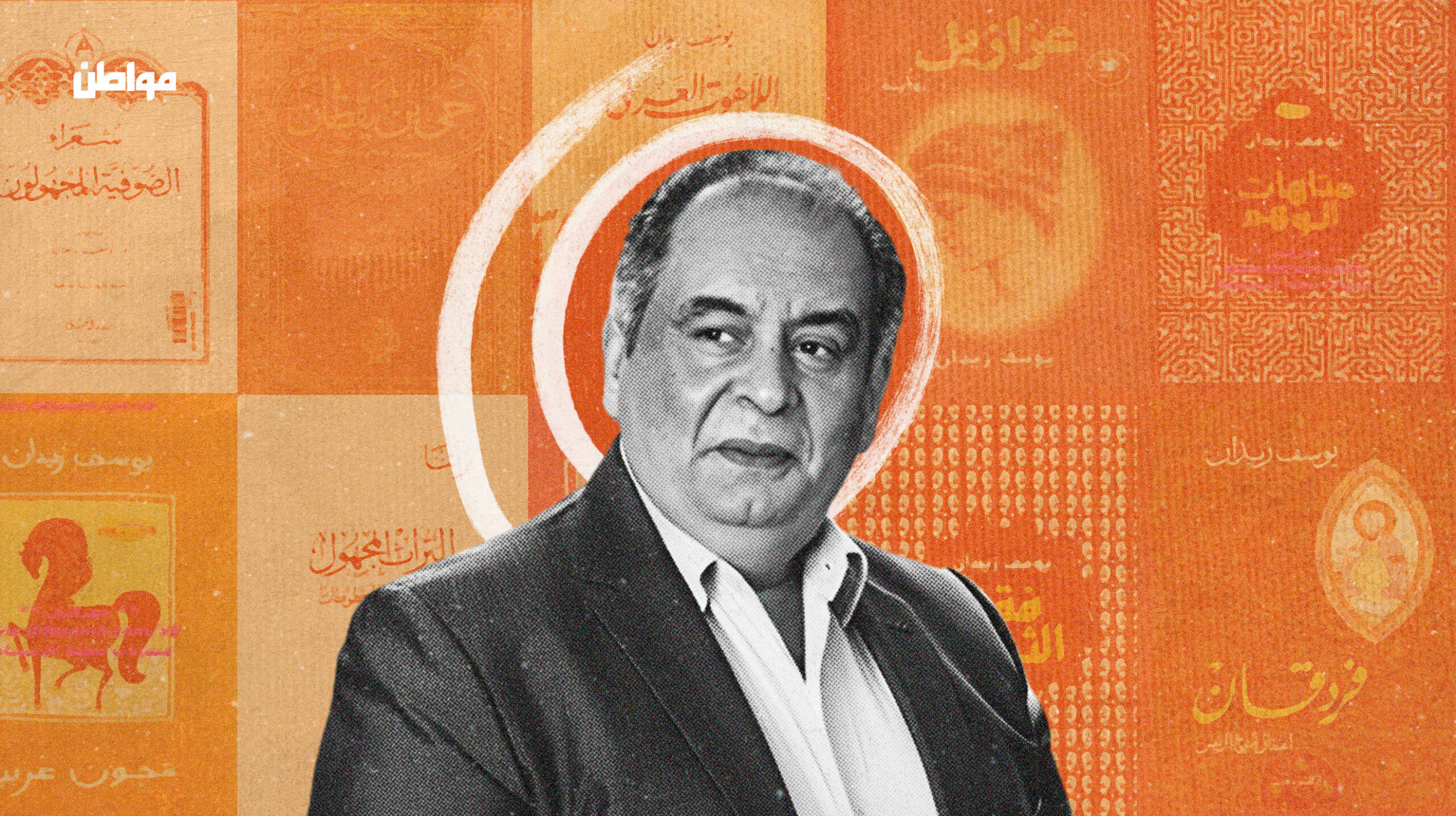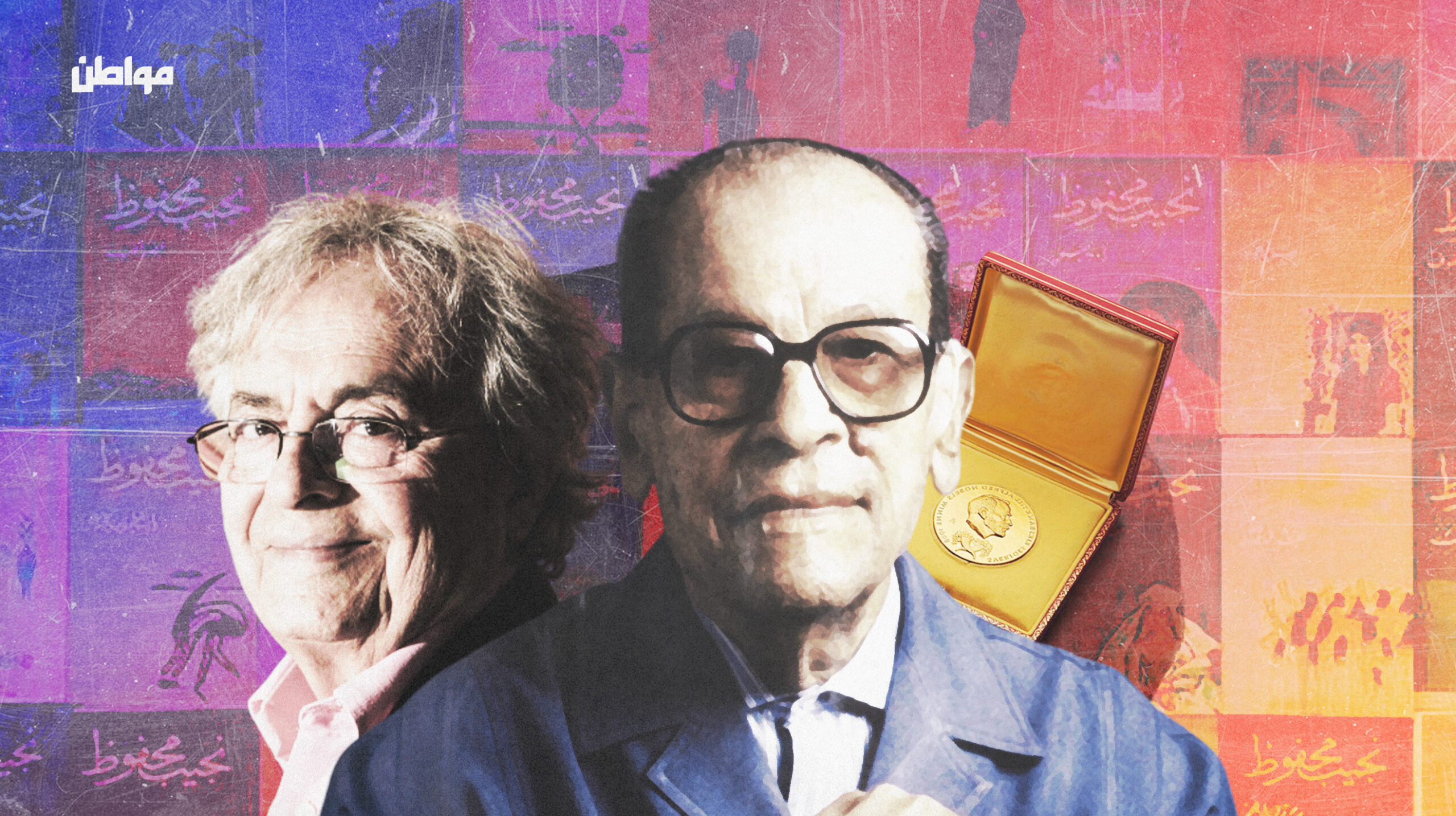150 عامًا مرت على انطلاق حركة “التنوير” العربية، من غير أن يكون لها أثر يشابه ما بلغته نظيرتها الغربية، ويعني هذا ببساطة أن اقتباس المفهوم ليس كافيًا لتحصيل نفس النتائج، غير أن هذا النص يزعم ما هو أبعد؛ أننا اقتبسنا السردية الغربية للتنوير برمتها، بمعنى آخر قمنا بتزييف السردية الخاصة بنا.
زعمنا أن انقطاعًا معرفيًا وقع بيننا، وما أسميناه بعصور التخلف والانحطاط، وأننا استقبلنا عصر نهضتنا، مع دخول الحملة الفرنسية إلى مصر كما هو معروف، ثم نصبنا أسماء مثل جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده.. إلخ روادًا لـ”التنوير”، ليلعب الأخير على وجه الخصوص الدور الأهم في سردية “تنويرنا”.
في الغرب تبدى التنوير حركة فكرية نتجت عن حراك علمي وثقافي، لهذا كان طبيعيًا أن تتسيد معاني العلم والعقل والحرية، بينما تمخض “التنوير” العربي عن “صدمة حضارية”، فغلبت عليه معاني الهوية والتراث والأصالة، وشتان بالطبع بين المسارين، مع ذلك رأى كثير من مثقفينا أن الاتفاق قائم، وأن تعثر “النهضة” راجع ربما إلى أنها لم تتمكن من تطوير “موقفها الدفاعي إلى موقف نقدي”، كما رأى اسم مثل جورج طرابيشي.
بحسب طرابيشي أنجزت النهضة العربية “في مطالع القرن العشرين تقدمًا مرموقًا على طريق النقد الذاتي، ولكن طغيان الأيديولوجيا في عصر الثورة، الذي نصب نفسه قيمًا على النهضة، وقاد نفسه وإياها في خاتمة المطاف إلى الفشل، ألغى المشروع النقدي من أساسه، ووضع نفسه ـ بل جندها بالأحرى ـ تحت راية مقولة جديدة: هي التعبئة، مع كل ما تعنيه التعبئة، بمفهومها العسكري والجماهيري معًا، من شحذ للانتماء الجماعي ومن إنامة للحس النقدي..” (جورج طرابيشي، من النهضة إلى الردة، الطبعة الأولى، دار الساقي، ص 83).
هذه الانتكاسة يرصدها اسم آخر مثل حسن حنفي وإن بصورة مغايرة، فحسب أن الردة وقعت حين تحول “التنوير الإسلامي” إلى “خطاب أصولي متمثل في جماعات العنف، جماعة الجهاد، وجماعات التكفير والهجرة، تعتمد على النقل دون العقل، وتتمسك بالعقيدة والشريعة، بالحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية..”.
كما رأى حنفي أن كبوة مماثلة في التيار الليبرالي تلت انطلاقة الطهطاوي حين أقام توازنا بين قيم التنوير الغربية والتراث، بعدما لم يجد فرقًا “بين مُثل التنوير الوافدة من الغرب وبين الموروث القديم، فما سمَّاه الغرب العقل، معروف عند المعتزلة في الحسن والقبيح العقليين، وفي الشرع، ولا فرق بين ما قاله مونتسكيو في “روح القوانين” وبين ما قاله ابن خلدون في العمران…”.
اختل هذا التوازن لصالح التنوير الغربي عند أحمد لطفي السيد، حين “بدأ الانعزال عن الثقافة الموروثة للأمة لصالح الثقافة الوافدة، وقد ظهر ذلك بوضوح في كتاب “مستقبل الثقافة في مصر” لطه حسين، الذي ظهر عام 1938، مؤكدًا ربط مصر بالغرب؛ باليونان قديمًا وفرنسا حديثًا في إطار ثقافة البحر الأبيض المتوسط بعيدًا عن العروبة والإسلام وآسيا وأفريقيا…” (حسن حنفي، حصار الزمن: الحاضر (إشكالات) الجزء الأول، نحو تنوير عربي، مؤسسة هنداوي للنشر)
يصرح طرابيشي وحنفي (وغيرهما) بذلك، أن “التنوير” انطلق بمجتمعاتنا، إلا أن عارضًا ألمّ بمشروعه فحجز انطلاقته، وهو عند طرابيشي الثورة أو الأنظمة العربية، ولدى حسن حنفي الأصولية الإسلامية، كذلك التيار الليبرالي الذي جنح إلى التغريب، لكن تتبع الخطاب الذي حمله رواد “التنوير” وأعلامه يقدم فرضية أخرى؛ أن سردية “التنوير” جرى استعارتها من الغرب ليس إلا، أي تزييفها؛ فخطاب “التنويريين” العرب لم يكن سوى امتداد لخطاب ما أسموه بـ”عصور التخلف والانحطاط”.
هذه الفرضية الكبرى لابد أن يعقبها ما يثبت صحتها، وهو أمر يستلزم بداية تناول خطاب رواد التنوير وأعلامه، وتعيين مفردات هذا الخطاب انطلاقًا من محمد عبده الذي دلف الجميع من باب شرعه، حين أقر أن مشروع “التنوير” يمر عبر التراث، مرورًا بأسماء مثل: العقاد وزكي نجيب محمود وطه حسين… (أُثبت أن نصه “في الشعر الجاهلي” لا ينتظم ضمن فرضيتي؛ إذ ينتمي لخطاب مغاير، لا تنتمي إليه جميع أعماله الفكرية الأخرى، وهو ما يحرضني على القول بأن هذا النص منتحل).
وصولاً إلى “الجيل الثالث للحداثة”، والتي استقبلت أعمالهم التراث أيضًا، كما لدى حسن حنفي الذي استند في مشروعه على إعادة بناء علوم الدين وفق العصر ومتطلباته، والطيب تيزيني حين اتجه إلى التراث متسلحا بمنهجية حداثية (المنهج المادي التاريخي)، وهو ذاته ما قدمه حسين مروة في “النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية”، بينما نحا محمد عابد الجابري إلى “استنبات الفلسفة الرشدية”، وقدم محمد أركون قراءة جديدة للنص، ولم يكن تبني هؤلاء الأعلام المذاهب والمناهج الغربية إلا قشرة سميكة تخفي خطابا زعموا أنهم قطعوا معه.
في الغرب تبدى التنوير حركة فكرية نتجت عن حراك علمي وثقافي، لهذا كان طبيعيًا أن تتسيد معاني العلم والعقل والحرية، بينما تمخض "التنوير" العربي عن "صدمة حضارية"، فغلبت عليه معاني الهوية والتراث والأصالة
المحدد الأول الذي يتبادر إلى الذهن بخصوص المنتجات الفكرية لهؤلاء الأعلام، أنها تلمست قيم وأفكار العصر في التراث، أو لأكون أكثر تحديدًا فأقول في النص، على اعتبار أن جميع المعارف التراثية تقريبًا قد قامت حول النص وفي خدمته، لتسعى تلك المشروعات إلى التطابق معه، وبالتبعية لا تعدو أن تكون في تعددها إلا انعكاسًا لشيء واحد، وبتعبير آخر أنها رغم تعددها فقيرة، حكمت على نفسها ألا تعرف غير الشيء نفسه، ألا وهو التراث أو النص.
المحدد الثاني أن هذا الخطاب بتوجهه نحو التراث أو النص يؤكد على أن الحقيقة مكانية، بمعنى أنها قيلت مرة واحدة وللأبد، والخطاب بذلك بلاغي، يستهدف الشرح والتفسير والوضوح لا أكثر، أما التفكير فيلوح كممارسة صورية ترد المتحرك (العالم) الذي لا يتوقف عن الحركة إلى وحدة ساكنة، ولا يذهب هذا بتلك المشروعات أبعد من أن تكون مجرد مخططات فكرية لا تترابط حتى تُكون شبكة مفهومية أو منظومة فكرية قادرة على التغيير، وهو ما كان.
بذلك أصبحت مهمة الفكر الوحيدة وفق الخطاب “التنويري” هو الاهتمام بالتشابهات الواقعة بين أفكار العصر من ناحية، والتراث من ناحية أخرى، وهذا بطبيعة الحال دعوة إلى إقصاء كل اختلاف (حتى مع رفع أصحابها شعارات مغايرة)، ولهذا السبب تشبث أولئك الأعلام في كتاباتهم ونقاشاتهم بعناوين من قبيل: الحداثة والتراث، الأصالة والمعاصرة…، لتمسي هذه الثنائيات شاهدة على عقم الفكر؛ إذ لا يقوى على الإدراك خارج نطاق التضاد والمشابهة”، وهو المحدد الثالث من محددات هذا الخطاب.
المحدد الرابع يتمثل في اعتقاد مفكرينا هؤلاء أن الفرد يمكن أن يمتلك معايير الصواب والخطأ في تحديد مراد النص، وبمجرد أن يدرك هذا المراد سينتقل على الفور إلى القيام بالفعل المطلوب، وذلك على اعتبار أن النص يشكل نسقًا من القواعد (المفارقة)، تملي على المرء ما ينبغي فعله، وعليه أن يمتثل.
أصبحت مهمة الفكر الوحيدة وفق الخطاب "التنويري" هو الاهتمام بالتشابهات الواقعة بين أفكار العصر من ناحية، والتراث من ناحية أخرى
لكن خلافًا لهذا التصور؛ فإن تلك “القواعد المفارقة” لكونها تستلزم حتمًا تقييمًا خارجيًا لا يقبل بها إلا من يشترك مع الداعي لها في نفس الظروف وطريقة التفكير؛ أي في الفهم، من ثم يمكن الاستنتاج بأن القبول أو الاتفاق لا يستند إلى القاعدة؛ بل سببه الفهم (المشترك)، وبالتبعية فإن هذا الفهم لا يكون صحيحًا إلا في إطار أو سياق خاص بجماعة من الجماعات، فلا يتعدى إلى غيرها، بمعنى آخر فإن القاعدة في هذه الحال ما هي سوى تبرير لموقف ما يخص هذه الجماعة أو تلك.
وهنا يجب التنبه أيضًا إلى أمر في غاية الأهمية، هو الخلط الحاصل لدى أصحاب هذا الخطاب بين “القاعدة” التي تلزم الكافة و”المعنى” الذي لا يلزم إلا أصحابه؛ فاعتناق الفكرة لا يكون نتيجة كونها قاعدة؛ بل هو راجع إلى قرار يخص أصحابها ويتصل بمعنى يتمثلونه، أما لماذا لا يشكل المعنى الذي يتمثلونه قاعدة تلزم الجميع؛ لأنه ببساطة ليس هناك قاعدة يمكنها أن تستشرف جميع العوامل والأحداث التي تتحكم في سلوك الفرد، والوضعيات التي تجري بها أفعاله؛ خاصة وإن كانت تلك القاعدة تنتمي إلى وضعيات سابقة مختلفة كل الاختلاف.
هذه المحددات الأربعة هي ذاتها التي شكلت خطاب “عصور الانحطاط”، ليتمثلها رواد “التنوير” العربي ومثقفوه في خطابهم، وهذا يعني ببساطة أن الانقطاع المعرفي لم يقع، وأن “الصدمة الحضارية” حرضت لا على “الموقف الدفاعي”، كما ذهب طرابيشي؛ بل على “التقمص” للآخر المتفوق، ليجري تزييف السردية الخاصة بـ “التنوير” العربي، لهذا من الطبيعي أن تمر 150 عامًا على انطلاق مشروعه ونصيبنا منه لا يغادر حاجز السؤال: لماذا لم ينجز مهمته؟.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.