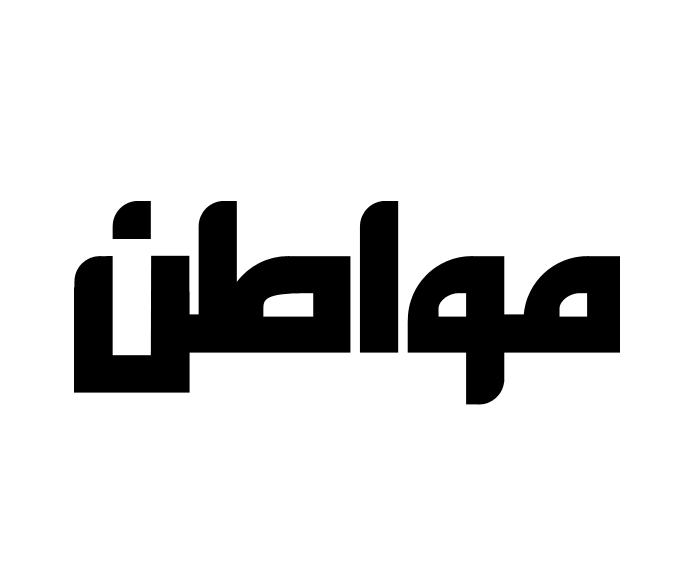في العام 1920، شهدت أحياء القدس أول مواجهة عربية – يهودية لم يشهد القدس مثلها من قبل. سيعاود الصراع دورته من وقت لآخر وصولًا إلى معركة البراق أواخر العشرينيات. صارت الأرض الهادئة إلى نقطة ملتهبة في الشرق الأدنى، وبدا البريطانيون -الحكام الجدد- عاجزين عن إدارة صراع يختلف في طبيعته عن أي صراع آخر عايشوه من قبل.
خلال عقد الثلاثينات، أدرك العرب واليهود على السواء أنهم ذاهبون في الصراع الوجودي إلى منتهاه، وكانت بريطانيا تنظر بعين إلى فلسطين، وبأخرى إلى ما يجري في ألمانيا؛ حيث النازية تملأ الأجواء، والنازيون-الإنجليز يتظاهرون في وسط لندن حاملين شعارات الهتلرية الألمانية.
رأى الإنجليز أن مستقبل القارة برمّتها على كفّ عفريت، وأن بنية النظام السياسي البريطاني على المحك، وما إن وضع النازيون أياديهم على السلطة في ألمانيا حتى فرّت أسراب اليهود من البلاد.
سهّلت بريطانيا وفرنسا انتقالهم إلى فلسطين؛ فلم تكن الدولتان مستعدتين لاستقبال شعب هو في الذاكرة الشعبية سؤال إشكالي؛ في فلسطين كانت معادلات الصراع تنمو على نحو متسارع منذ وضع البريطانيون يدهم على فلسطين بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية.
كانت فلسطين قد وقعت، منذ العام 1920، تحت الانتداب البريطاني وفقًا لاتفاقية سيفر، الوثيقة التي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن أراضيها الشاسعة بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى، تحت الرعاية البريطانية امتلك اليهود ثقة متزايدة وقرّروا إحداث تغييرات جوهرية في منطقة حائط البراق، أو حائط المبكى وفقًا للتسمية اليهودية.
بينما الصراع العربي-الإسرائيلي في طور التشكل في عشرينيات القرن الماضي، كان عرب فلسطين سلالات متناثرة من الفلاحين غير منتظمة مركزيًّا. الخروج العثماني من الأرض تركهم في فلاة مترامية الأطراف.
وفّرت بريطانيا حماية للمتظاهرين اليهود من طليعيي الحركة الصهيونية، الذين احتشدوا بأعداد كبيرة مطالبين بملكية حائط البراق، رددوا الأناشيد الصهيونية، أهانوا المسلمين وتوعدوهم، واقتحموا الحائط مرددين هتافهم الشهير “الحائط لنا”. من نتائج ذلك الاقتحام أن انفجر صراع مسلح بين العرب واليهود امتد من بئر السبع جنوبًا حتى صفد شمالًا.
وجدت بريطانيا نفسها عاجزة عن فهم ما يجري فضلًا عن احتوائه، سقط مئات القتلى، تعرضت قرى وأسواق للتخريب، وتوتر الجو العام على نحو غير مسبوق.
دوّن شكيب أرسلان تلك الأيام على هذا النحو: “عندنا مثال حديث العهد هو مسألة فلسطين: حدثت وقائع دموية بين العرب واليهود في فلسطين؛ فأصيب بها أناس من الفريقين؛ فأخذ اليهود في جميع أقطار الدنيا يساعدون المصابين من يهود فلسطين، وأراد العالم الإسلامي أن يساعد عرب فلسطين كما هو طبيعي؛ فبلغت تبرعات اليهود لأبناء ملتهم من فلسطين مليون جنيه، وبلغت تبرعات المسلمين كلها 13 ألف جنيه، أي نحو جزء من مئة”.
الأيام تلك من العام 1929 أسماها العرب: ثورة البراق، كان ذلك هو الصدام الثاني الذي يجري في القدس بعد أن صارت تحت الانتداب البريطاني، غيّر البريطانيون بنية السلام في المدينة، ووضعوها على فوهة بركان، ولا تزال كذلك حتى الساعة.
للمرة الثانية خلال عقد من الزمن، تندلع المواجهات في القدس وتمتد إلى خارجها؛ فحتى هيرتزل الذي زار القدس في العامين الأخيرين من القرن التاسع عشر أبدى إعجابه الكبير بالتنوع الثقافي لمدينة القدس، وبالسلام العميق بين الأديان والأعراق هناك. بدا أن بريطانيا ومعها الصهيونية الاستعمارية في طريقهما إلى إنهاء ذلك السلام ربما إلى الأبد.
خارج فلسطين -كما دوّن أرسلان-، بادر المسلمون واليهود، كل من جهته، إلى توفير الدعم الذي تتطلبه المواجهة. كان الدعم الإسلامي ضئيلًا على نحو لا يذكر. سيحافظ الدعم الإسلامي للمسألة الفلسطينية على ضآلته لقرن كامل، وستخرج إسرائيل على العلن كدولة، ليست وحسب ذات سيادة؛ بل قادرة على بيع السلاح النوعي إلى أوروبا. ألقى العثمانيون بفلسطين في المجهول، وذهبوا يتدبرون أمرهم، ولولا مجموعة من الضباط المتمرّدين على إرادة الخليفة لكانت تركيا نفسها قد اختفت إلى الأبد.
على ضوء ثورة البراق، وفي مساعيها لوضع حد لمثل هكذا اشتباكات في المستقبل، شكلت عصبة الأمم لجنة قانونية لدراسة مسألة الحائط. عادت اللجنة بتقريرها النهائي الذي منح عرب فلسطين الحق في الحائط؛ كونها أوقافًا عربية قديمة، ويحق لليهود الصلاة على الجهة الأخرى، وليس من حقّهم تغيير شيء مما هو قائم؛ بل أوصت لجنة التحقيق بمنع اليهود من جلب أدوات العبادة كالسجّاد والكراسي. تلقّت بريطانيا توصيات عصبة الأمم على نحو جاد، وبدأت تدرك جانبًا من معضلة فلسطين.
ستعاود هذه المعضلة التاريخية تكرار نفسها محتفظة بجوهرها: إصرار اليهود على اقتحام أملاكٍ تقول المقرّرات الأممية إنها ليست لهم.
في أول إحصاء أجرته بريطانيا للسكان 1919، وجدت سلطة الانتداب أن اليهود لا يمثلون سوى عشرة في المائة من سكان البلاد [70 ألف يهودي، مقابل 700 ألف عربي]، رغم موجات الهجرة التي تدفقت على فلسطين منذ مطلع القرن.
أدركت بريطانيا التعقيد التاريخي الذي صنعته بيديها، وستكابد تلك المعضلة حتى تقرر الخروج من كل فلسطين في العام 1948م، تاركة خلف ظهرها هويتين تتقاتلان من المسافة صفر.
بينما الصراع العربي-الإسرائيلي في طور التشكل في عشرينيات القرن الماضي، كان عرب فلسطين سلالات متناثرة من الفلاحين غير منتظمة مركزيًّا. الخروج العثماني من الأرض تركهم في فلاة مترامية الأطراف، بلا قيادة بديلة ولا بنية سياسية مركزية.
منح هذا الشتات الآخرين الحق في الادعاء بأن فلسطين أرض واسعة بلا شعب، الأوروبيون الأوائل، الذين وصلوا فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى، أسسوا مستعمرات زراعية وراحوا يبلغون أهاليهم بعثورهم على أرض واسعة ليس فيها الكثير من البشر.
بدا كأنهم يكتشفون أميركا جديدة، ثرية وفارغة سوى من بعض “العرب السمر”، كمقابل للهنود الحمر. مقابل الوكالة اليهودية، التي تأسست في العام 1908، أسس عرب فلسطين كيانًا هشًّا أسموه الحركة الوطنية الفلسطينية، وبقي عرب فلسطين بلا رابطة سياسية حقيقية؛ ما أفسح المجال لمفتي القدس، الحاج أمين الحسيني، ليملأ الفراغ.
بينما اختفت الإمبراطورية العثمانية من الوجود تلفّت، الحسيني يمنة ويسرة، ثم سافر إلى ألمانيا، التقى القيادات النازية المسؤولة عن ملف اليهود، وتحدث الطرفان عن تنسيق مشترك. وعده النازيون بغزو فلسطين لتخليص البلاد من اليهود، ووعدهم بالإسناد.
أفضى توتر ثلاثينيات القرن الماضي إلى الثورة العربية الكبرى 1936، التي كانت أولى المعارك التي خاضها العرب ضد قوة إحلالية لا يعرفون مدى قوتها ولا طبيعة أحلافها.
كما تخلّت الإمبراطورية العثمانية عن فلسطين، وهي تكابد محنتها الوجودية؛ فإن بريطانيا أوشكت أن تفعل الشيء نفسه مع المشروع اليهودي الذي أسسته.
فبعد الثورة العربية الكبرى 1936-1939 أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض، وهي مجموعة واسعة من اللوائح تعنى بإدارة الصراع العربي-اليهودي الذي أخذ يتعقد على نحو لم يكن في حسبان مملكة الأمواج، رغم خبرتها الواسعة في العالم. وافق مجلس العموم على الوثيقة في مايو من العام 1939، قبل أربعة أشهر فقط من اجتياح النازيين لبولندا.
آنذاك، كان اليهود يفرّون من ألمانيا إلى كل العالم، وكانت فلسطين واحدة من الوجهات المفتوحة. توقعت بريطانيا الحرب مع ألمانيا النازية، وكان آخر ما تريده أن تؤدي الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى إشغال سلطاتها بمسائل غير ذات بال.
حدد الكتاب الأبيض أمورًا حاسمة؛ مثل منع بيع الأراضي لليهود، وتحديد منسوب الهجرة إلى فلسطين على أن لا يزيد عدد الوافدين الجدد على 75 ألفًا خلال خمسة أعوام.
رُفضت الوثيقة يهوديًّا، وحدثت مواجهات دموية بين الطرفين. العرب أيضًا لم يقبلوا الوثيقة لأنها أعادت التأكيد على وطن لليهود، نجحت الثورة العربية الكبرى في إجبار بريطانيا على إيقاف شلال الهجرة أو الحد منه، وعلى دفعها إلى تجريم شراء أراضي الفلسطينيين أو إجبارهم على بيعها.
تغيّر مصير القارة الأوروبية، وباتت لندن في مرمى الصواريخ طويلة المدى التي لم تُرَ في حرب قبل ذلك. انقشع غبار الحرب الكبرى على جثث لمئات آلاف اليهود، ومعسكرات اعتقال تمتد من جنوب ألمانيا إلى وسط بولندا، وآن أن تتخلص القارة من صداعها المستدام، ذلك الكائن المثير للشك والجدل كما يبرز في أدبها وحكايتها الشعبية، المسمّى اليهودي.
بحلول العام 1948 كان اليهود قد فرضوا واقعًا جديدًا على جزء غير قليل من أرض فلسطين، كما استطاعوا بناء تشكيلات عسكرية عديدة مستفيدين من الرأس مال البشري القادم من أوروبا.
تاجر البندقية، المرابي الشرير، وفاجن، اليهودي الذي يختطف الأطفال ثم يحولهم إلى لصوص، لا بد وأن يجدا لهما بلدًا خارج القارة الأوروبية. هكذا برزت إسرائيل إلى الوجود كدولة قالت في خطابها الأول الذي ألقاه “بن غوريون”، إنها تمدّ يدها للسلام مع كل العرب، وأن هناك من الأرض ما يكفي لشعبين.
انفجرت حربٌ جديدة مع العرب، كسبها اليهود الذين صاروا إسرائيليين. أدرك الغرب المعضلة التي أدركتها بريطانيا في عشرينيات القرن نفسه، ثمّة شعب آخر يعيش على الأرض ويملكها وهو على استعداد للدفاع عن أرضه بكل الوسائل.
أعطى النازيون لأنفسهم الحق الأخلاقي -وربما الديني- في محو اليهودية من على وجه الأرض. وفعل اليهود -من الحركة الصهيونية- الشيء نفسه حيال الفلسطينيين.
عاود الصراع العربي- الإسرائيلي دوراته، وفي كل مرّة تنتهي الحرب باعتراف غربي بحق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس الشرقية، خدمة لفظية تقدم على أعقاب كل صراع، تقال بالطريقة نفسها رغم تبدّل الأزمنة والوجوه.
بالعودة إلى كتاب هيرتزل الذي أصدره في فيينا [الدولة اليهودية، 1896]، سنلاحظ أن المفكر الصهيوني الأبرز يقرّر أن أوروبا غارقة في كراهية السامية، وأنه ما من أمل لإصلاح تلك المسألة. لذا فقد اقترح على القوى العظمى أن تهب اليهود قطعة أرض في أي مكان في العالم حتى تستريح شعوبها من المعضلة اليهودية.
في عمل واسع، تجاوز الألف صفحة، تتبع الباحث وجدي نجيب المصري الأصول التوراتية للعنف الإسرائيلي، ووجد نفسه مضطرًا لطرح استنتاجه العلمي القائل إن الكتاب اليهودي المقدس مشكلة إنسانية عويصة.
كلما دنا اليهودي من كتابه وملأ عينيه منه مال قلبه إلى العنف، الاستعلاء، واحتقار كل آخر في العالم. الأوروبي الأول، ما قبل الاستعماري، كان مدركًا لهذه الحقيقة؛ لطالما هاجم الأوروبيون التجمعات اليهودية لمجرّد أن شاهدوا ظاهرة مقلقة ليس لها تفسير، أو سمعوا عن جثة طفل قتيل في مكان خلاء.
بالنسبة لهم فإن المسؤول الأخير عن كل ما هو ضار وشرير هو “كتاب اليهود”. اكتملت معاداة السامية في أوروبا على مدى قرون، وأخذت شكلها المدمر مع النازية الألمانية، فرّ الناجون إلى فلسطين، وهناك أقاموا معسكرات اعتقال جماعية لأهل الأرض وقتلوهم بقنابل الفوسفور.
حملوا الفعل النازي في حقائبهم ومارسوه على الآخرين الذين سيصبحون ضحايا الضحايا، كما هو التعبير الأثير لإدوارد سعيد. أعطى النازيون لأنفسهم الحق الأخلاقي -وربما الديني- في محو اليهودية من على وجه الأرض. وفعل اليهود -من الحركة الصهيونية- الشيء نفسه حيال الفلسطينيين؛ يأمر سفر التثنية أتباعه “وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربّ إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمةً ما”
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.