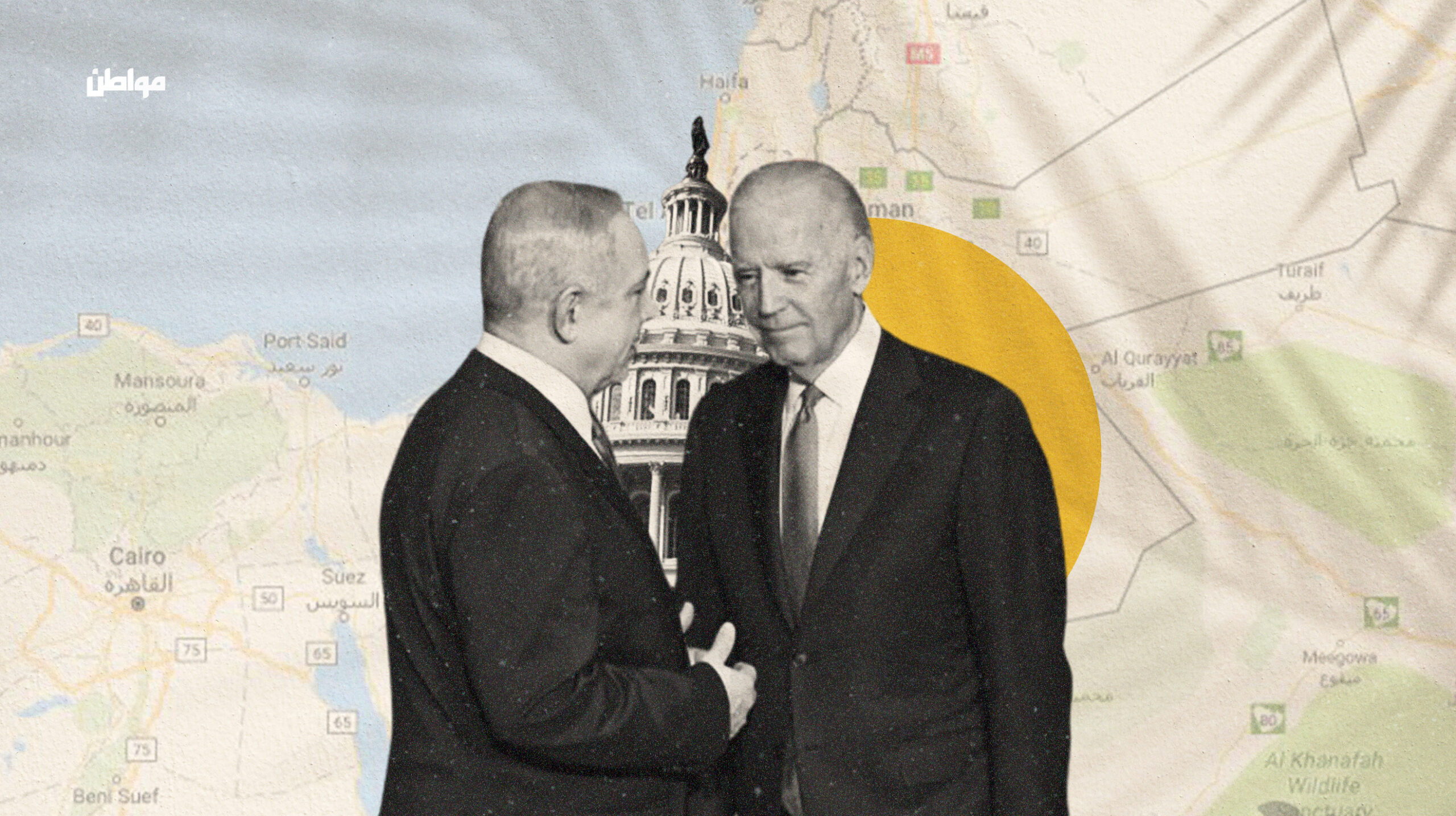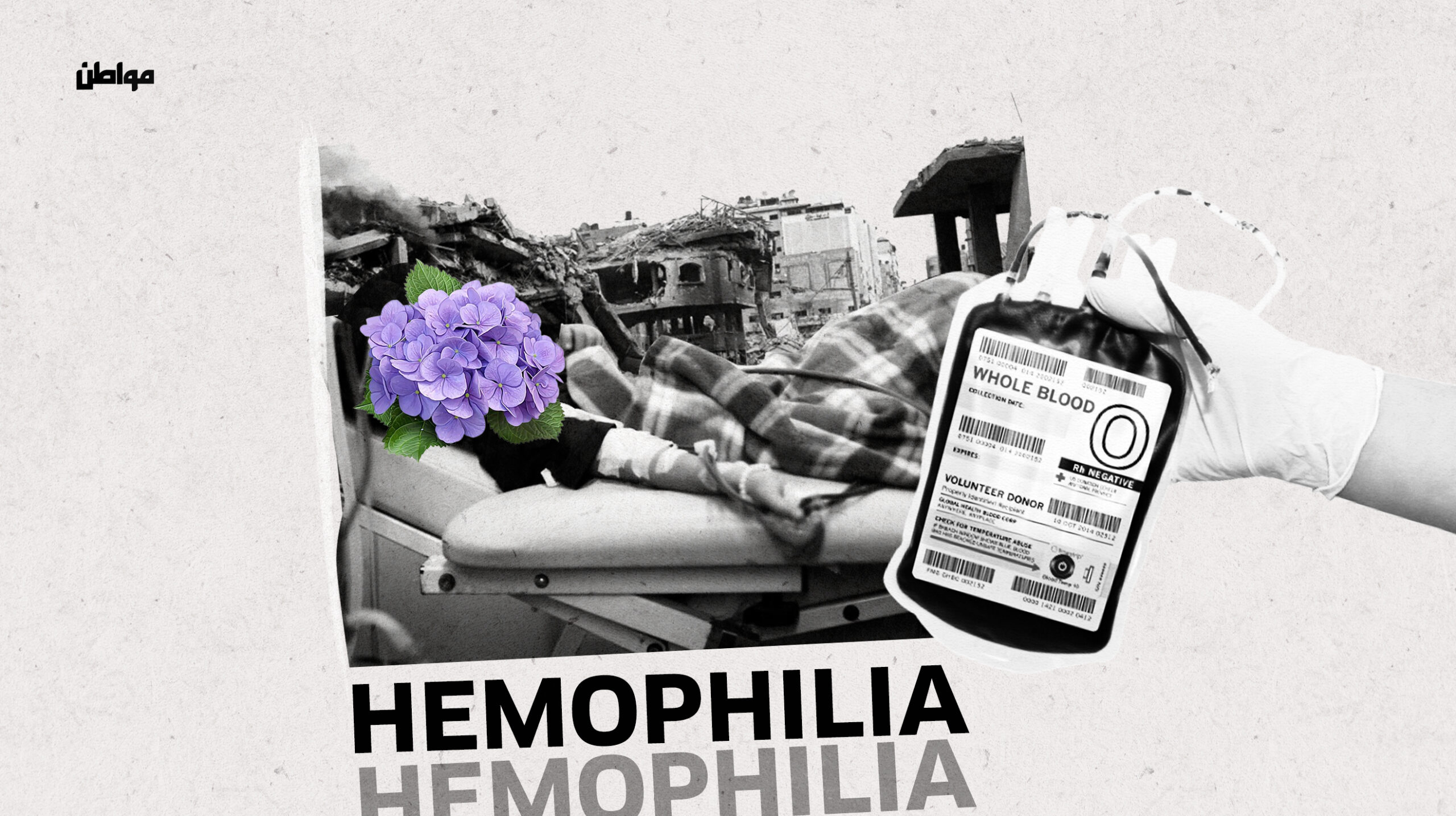مؤرخو إسرائيل الجدد.. هل يكتبون تاريخًا حقيقيًا لتأسيس الدولة؟
في سنة 2007 ترك؛ بل أُجبر إيلان بابيه على مغادرة جامعة حيفا التي كان يُدِّرس فيها، إلى بريطانيا، وتحديدًا إلى جامعة إكستير، ليبدأ مرحلة جديدة في تدريس تاريخ فلسطين وإسرائيل. لم يكن رحيل إيلان بابيه عن الجامعة مفاجئًا؛ حيث قادت بعض الأحداث المثيرة إلى هذا الرحيل الحتمي عن “إسرائيل”.
كان من بين تلك القصص المثيرة، ارتباط اسمه بأحد طلاب جامعة حيفا يدعى تيدي كاتس، الذي كان طالبًا في حقل الدراسات التاريخية بالجامعة سنة 1998، كان كاتس متخصصًا بتأريخ سنة 1948 عام النكبة، أو كما يطلق عليه في إسرائيل وفقًا للرواية الصهيونية، عام الاستقلال. عمل كاتس على إعداد رسالة ماجستير، تناول خلالها تاريخ خمس قرى تم تهجير أهلها بشكل قسري في جبل الكرمل بحيفا، معتمدًا بذلك على الوثائق التي تم الكشف عنها، بالإضافة إلى اعتماده على 135 شهادة شفوية لعمليات التهجير التي حدثت في تلك القرى سنة 1948، كان نصف تلك الشهادات يهودية ونصفها الآخر عربي، معتمدًا بذلك على شهادات الجنود أنفسهم الذي قاموا بعمليات التهجير في الجانب اليهودي، وعلى شهادات الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم جراء إعلان الدولة.
يُشير بحثه الذي حصل فيه على أعلى درجة ممكنة في الجامعة إلى وقوع جريمة تطهير عرقي في تلك القرى الخمس، لكن المأساة الأكبر كانت تحديدًا في قرية الطنطورة الساحلية، التي تقع في محافظة حيفا، والتي بلغ عدد سكانها حين ذلك 1600 نسمة، أسفرت تلك الجريمة عن استشهاد 230 فلسطينيًا وطرد سكانها
صيغت المصطلحات الإسرائيلية بشأن الحرب بعناية كبيرة؛ حيث تمنح الصهيونية وضعًا مساويًا لحركة تحرير تنتمي إلى العالم الثالث من مستعمِر (إنجلترا)؛ ولذلك لا يمكن ذكر حرب ضد العرب في هذا السياق، أو صوت لهم كمكون للأرض التي قامت عليها الدولة
إلا أن المشكلة الرئيسية التي واجهت تيدي كاتس هي أنه -وبعد عامين فقط من حصوله على درجة الماجستير- هي وقوع رسالة الماجستير في يد صحفي من صحيفة معاريف اليومية، قام بنشر بعض شهادات الجنود الذين نفذوا تلك المجزرة، نُشرت بتاريخ 21 يناير 2000، تسببت تلك المقالة في حالة من الذعر في الأوساط السياسية والاجتماعية؛ ما دعا الجنود والضباط الذين شاركوا تيدي كاتس شهاداتهم برفع دعوى قضائية عليه بتهمة التشهير، والتي أفضت إلى سحب رسالة الماجستير بعد أن أجبر على إظهار الندم والتبرؤ منها، عاني تيدي كاتس بسبب تلك الحادثة عناءً شديدًا؛ حيث أصيب بجلطة أودت به قعيدًا على كرسي متحرك.
فرضية التأسيس: شعب بلا أرض، وأرض بلا شعب
اتبعت إسرائيل نظام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في قانون الكشف عن الوثائق؛ حيث يتم الكشف عن الوثائق السرية بعد الحادث بثلاثين عامًا، إلا في استثناءات حساسة يمكن خلالها تأجيل عملية الكشف عن طبيعة تلك الوثائق. كانت أحداث سنة 1948 التي انتهت بتأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية ثرية إلى حد أكبر مما يتم تناوله واختزاله في إسرائيل في الثلاثين سنة التي أعقبت إعلان الدولة؛ حيث تم اختزالها في بعض الرؤى التي حددتها الرواية الصهيونية.
وكما يشير إيلان بابيه؛ فإن المصطلحات الإسرائيلية بشأن الحرب صيغت بعناية كبيرة؛ حيث تمنح الصهيونية وضعًا مساويًا لحركة تحرير تنتمي إلى العالم الثالث من مستعمِر (إنجلترا)؛ ولذلك لا يمكن ذكر حرب ضد العرب في هذا السياق، أو صوت لهم كمكون للأرض التي قامت عليها الدولة؛ حيث صيغ مصطلحان استخدما لوصف حالة حرب 1948؛ وهما “الاستقلال” عن التاج البريطاني، الذي صيغ في العبرية بلفظ “عتسامؤوت”، ومصطلح “التحرر” من نير الشتات، والتي صيغ في العبرية أيضًا بلفظ “شِحرور”.
بنيت إسرائيل فرضية التأسيس على هذين المصطلحين؛ حيث كان محور تكوين الدولة هو الأرض ذاتها التي كانت بلا شعب، وهو المبدأ الشهير “أرض بلا شعب”، لكن العائق الوحيد كما حال كل دول العالم الثالث هو التحرير من نير الاستعمار؛ سواء كان بريطانيًا كما حالة فلسطين، أو فرنسيًا كحال سوريا مثلًا.
أما المبدأ الثاني والذي يقوم على أساس الأرض أيضًا هو “شعب بلا أرض”، وهو تكوين دولة، وضم كل هذا العدد من يهود العالم في حدود تلك الأرض. إذًا لم يكن هناك حضور عربي أو فلسطيني على الإطلاق في الرواية التاريخية الإسرائيلية؛ حيث تم اختزال الوجود العربي فقط في الحرب ضد الجيوش العربية التي كان عليها أن تخوضها مكرهة بسبب العداء العربي لهم. أما الحروب التي خاضتها إسرائيل بعد تأسيس الدولة فهي حروب يسري عليها مبدأ “لا خيار”، وهو مبدأ أن إسرائيل مجبرة على دخول تلك الحرب، وأنه لا خيار أمامها سوى الدخول فيها.
رفع الستر عن الوثائق
بدأت تلك الراوية أو الفرضية الثابتة في أذهان بعض أكاديميي إسرائيل تهتز في ثمانينيات القرن الماضي، مع ثلاثة أحداث متوازية، الأول كان الكشف عن الوثائق نفسها، أتاح هذا المجال للمؤرخين أن يتجهوا إلى الأرشيف الوطني الإسرائيلي للعمل في حقول جديدة في الدراسات التاريخية الإسرائيلية، وهو ما جعلهم يتعرضون إلى حقائق مغايرة عما كانت معروفة لدى الجمع الإسرائيلي، والتي بدت تتجلى فيها أصوات الفلسطينيين الذين تم تطهيرهم قراهم عرقيًا من الأرض لتحل محلهم جماعة أخرى بهوية مختلفة وثقافية تلقيطية مضطربة، كانت تلك الوثائق تسجل شهادات الجنود والضباط والأوامر التي تلقتها الكتائب المختلفة، بشأن تطهير القرى والمدن في فلسطين أثناء تأسيس الدولة.
أما الحدث الثاني فكان اجتياح لبنان، الذي فرض أسئلة من نوع آخر غير مبدأ “لا خيار”، وهي ما فائدة تلك الحرب التي يبدو أن لإسرائيل الخيار الكامل في الدخول فيها؟ بالإضافة إلى الحدث الثالث وهو الانتفاضة الفلسطينية التي كانت مفاجئة للجمع الإسرائيلي.
ظهرت جراء تلك الأحداث مدرسة جديدة في كتابة التاريخ الإسرائيلي، وهي ما سميت بمدرسة “المؤرخون الجدد“، وكان المؤرخ بِني موريس هو صاحب هذا الوصف الذي أطلقه في مقال نشره في العام 1988 في مجلة يهودية تصدر في الولايات المتحدة، -بالرغم من أن الاسم لم يتوافق مع رؤية بعض المؤرخين الآخرين، وفضلوا أن يطلقوا عليه المدرسة التصحيحية- واجهت تلك المدرسة عددًا كبيرًا من الأزمات الأكاديمية والاجتماعية والسياسية بطبيعة الحال، كان أبرز تلك المشكلات هو التكوين العلمي للمدرسة؛ حيث لم يكن هنا وفاق كامل بين رؤى مؤرخي المدرسة؛ فبدت الأفكار مضطربة، منها ما كان يريد خدمة الدولة نفسها بتأريخ جديد وتصالحي مع الماضي مع استمرار قيام الدولة، بخطيئة قيام الدولة ذاتها والمشروع الصهيوني في أساسه، وبالتالي استحالة قيام الدولة مع طبيعة التاريخ الذي يتم تدوينه عنها؛ حيث إن استمرارية الدولة هو في حد ذاته استمرار لتلك الخطيئة.
نتائج مضطربة
لكن وبالرغم من اضطراب تلك المدرسة؛ إلا أنها أنتجت في النهاية تغييرًا في بعض المفاهيم الصهيونية، كان من بين تلك المفاهيم هو الحديث عن حرب 1948 نفسها، صاغت الرواية الصهيونية سردية أن الحرب التي جرت بين إسرائيل والقوات العربية في سنة 1948 كانت بين فئة قليلة غلبت فئة كبيرة، كما حال طالوت وجالوت، وبالتالي فإن نشأة الدولة تمخضت من خلال معجزة إلهية. أما الوثائق فتتحدث عن قوات عربية ضعيفة لم تكن على قدر كاف من التجهيزات أصلًا، بالإضافة إلى الكشف عن الاتفاقات التي أبرمتها الوكالة اليهودية مع شرق الأردن بخصوص تعمد تواطؤ القوات الأردنية في الحرب، مقابل أن تتنازل لها إسرائيل عن حكم الضفة الغربية. أنتج هذا الكشف من خلال الوثائق التي عمل عليها المؤرخون الجدد على إعادة صياغة للحرب التي أنتجت/ أنشأت الدولة، وبالتالي فإن أساس الدولة ذاته يواجه مشكلة رئيسة أثبتت من خلال الوثائق.
أما المعضلة الثانية فهي أن المجتمع الإسرائيلي يتحدث دائمًا عن خطر الإبادة الذي تعرض له أثناء تأسيس الدولة سنة 1948، وبالتالي فإن التسليح القوي والدفاع عن النفس بكل الأشكال حتمي وضروري لحماية الشعب، إلا أن الوثائق التي اكتشفت كانت تتحدث عن مجتمع عربي وفلسطيني أضعف من أن يحاول حتى القضاء على المجتمع الإسرائيلي أو مواجهته، وبالتالي فإن المجتمع الإسرائيلي لم يتعرض حتى لهذا الخطر المزعوم.
لم تنجح مدرسة المؤرخين الجدد في تأسيس منهجية قوية الأركان داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل كاف؛ خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة، كان التيار الديني الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل هو المتحكم الرئيسي في زمام الأمور
كان أكثر ما أرق كتابة التاريخ الجديد هو أصوات الفلسطينيين وسكان الأرض أنفسهم، من الذين تم تهجيرهم بشكل قسري. في حالة مثل تيدي كاتس فإن صوت الرصاص الذي أطلق على 230 فلسطيني في الطنطورة كنموذج ضمن مئات المجازر التي حدثت في فلسطين، كان قويًا بشكل كاف لأن يهدم كل الافتراضات الصهيونية الأخلاقية التي لازمت تأسيس الدولة. تحدث بني موريس بناءً على ما اطلع عليه من الوثائق عن أن الكثير من الفلسطينيين طردوا من قراهم ومدنهم أثناء تأسيس الدولة، حتى بالرغم من أنه كما يتحدث إيلان بابيه، لم يتوافق مع الرؤية التاريخية الفلسطينية التي طرحها وليد الخالدي والقائلة بأن الطرد كان جزءً من خطة عامة، إلا أن ما توصلت إليه الراوية الإسرائيلية بناءً على الوثائق يشير إلى استحالة تأسيس الدولة دون تطهير عرقي؛ فضلًا عن المجازر الأخرى التي قام بها الجيش الإسرائيلي المكون من العصابات الصهيونية أثناء عملية التأسيس العنيف للدولة .
كان من ضمن المشكلات التي تم التعامل معها كذلك، هي أن الحروب التي خاضتها إسرائيل لم تكن دفاعًا عن نفسها؛ بل كانت بشكل استباقي وبهدف استعماري، وهو ما تحدث عنه إيلان بابيه في كتابه: “أكبر سجن على الأرض. تاريخ الأراضي المحتلة”، أن حرب سنة 1967 لم تفرض على إسرائيل؛ بل استعدت لها قبل الحرب بأربعة أعوام؛ حيث كشفت الوثائق أن إسرائيل أعدت خطة شاملة لإدارة الأراضي التي ستحتلها إسرائيل بعد سنة 1967.
حجر في ماء آسن
لم تنجح مدرسة المؤرخين الجدد في تأسيس منهجية قوية الأركان داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل كاف؛ خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة، كان التيار الديني الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل هو المتحكم الرئيسي في زمام الأمور؛ فضلًا عن استحالة تصحيح تأريخ لا يتوافق مع مبدأ الدولة ذاته، والتي قامت على خطيئة في الأساس، لكنها استطاعت وبشكل محمود تحريك المياه الراكدة داخل هذا المجتمع، الذي كان يؤمن إيمانًا عميقًا وغير محدود بالرواية الصهيونية الرسمية التي اتبعتها دولة إسرائيل، لكن وجب التنويه إلى أن الأكاديمية الفلسطينية كانت قادرة على صياغة تلك المفاهيم من اللحظة الأولى، حتى قبل الكشف عن وثائق إسرائيل، لكن المختلف هنا أن مؤرخين إسرائيليين هم أنفسهم من يدلون بتلك الشهادات. لا يرجى من تلك المدرسة تغيير جذري، لأن المشكلة الرئيسية في دولة إسرائيل تكمن في وجودها.