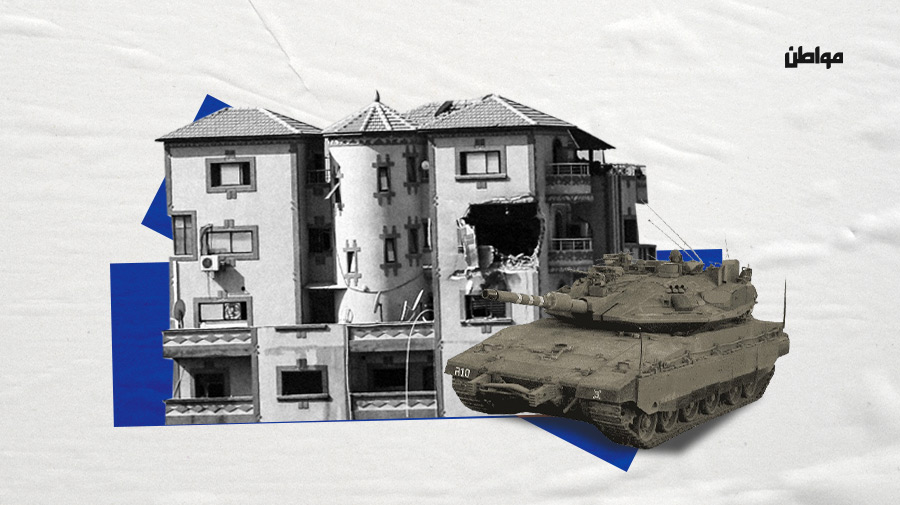خلص الأديب الفرنسي ألبير كامو في كتابه الإنسان المتمرد، إلى أنه على الإنسان التمرد في مواجهة الواقع، وإن كان الواقع يقر احتلالًا، وإن لم نكن قادرين على تغييره؛ فعلينا بعدم الاستسلام له والبحث عن الحرية. استوحى الأديب الفرنسي أفكاره من مشاركته في المقاومة ضد الاحتلال النازي لفرنسا في 1940.
وبين تداعيات الأحداث الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أجد نفسي في مداد استحضار أشعار محمود درويش وكلمات غسان كنفاني،كونهما جزءًا لا يتجزأ من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، ونماذج واضحة على علاقة الأدب بالمقاومة؛ فَشعرُ الأول يُلهمني بالتفاؤل والصمود، بينما تدفعني كتابات الثاني إلى روح التكاتف والتضامن في مواجهة القمع. وهناك نماذج متعددة، إلا أنني اخترتهما نظرًا لاختلاف موقفهما، على الرغم من وحدة الهدف.
اشتهر درويش بأشعاره التي تعد بوحًا شاعريًا قويًا ينبش في أعماق الألم عن الألم والأمل، بينما عرفت كتابات غسان بالنضال الثقافي والسياسي وتناول قضايا الهوية والكرامة. وهما رمزان للثقافة والفن الفلسطيني، وثقافة المقاومة والصمود.
يقول محمود درويش عن غسان كنفاني: “حين نعتنا بأننا أدباء مقاومة لم نكن نعرف أننا نكتب أدبًا مقاومًا، وإنما نكتب أدبًا نعبر فيه عن واقعنا”. فكانت هذه الجملة تمهيدًا للتعرف عن قرب على ماهية أدب المقاومة، وهو أدب يسعى لتشجيع الوعي والتغيير الاجتماعي والسياسي. فكيف برزت القضية الفلسطينية في أدب الثنائي؟
فلسطين في شعر درويش
يمتاز الأدب بالرمزية، ويمكن فيه للعلامة أن تأخذ عدة معان أعمق من وجودها مجردة خارج نص أدبي؛ فصرصار كافكا يعبر عن تفسخ حالة الإنسانية في العالم المادي ذات الطابع الحداثي، و سبعة أجيال من عائلة بوينديا التي تعيش في بلدة ماكوندو في رواية “مائة عام من العزلة” لجابيريل جارسيا ماركيز، تعكس تاريخ كولومبيا، وهكذا يمكن التعاطي مع الأدب، وأن لعلاماته معان متعددة.
وعند ذكر الزيتون في شعر درويش لا يبدو الأمر عاديًا، لكن بالعودة للسياق الثقافي الفلسطيني، نجد سردية تقول إنه بينما يرحل كبار السن، تبقى شجرة الزيتون متجذرة في أعماق الأرض، تزداد قوة وثباتًا. هذا ما يعتقده الفلسطينيون عن أشجار الزيتون التي سعى الاحتلال لتجريف مساحات زراعتها واقتلاعها من الأرض؛ في واحدة من محاولات الطمس الثقافي لهوية الأرض المحتلة، ومن هذه العلاقة المضادة بين صاحب الأرض والمحتل، جاءت كلمات درويش عن هذا: “لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعًا، يا حكمة الأجداد، لو من لحمنا نعطيك درعًا، لكن سهل الريح لا يعطي عبيد الريح زرعًا”.
كما حضر الزيتون بدلالات الصمود والهوية، لم يحضر البحر الأبيض المتوسط في أشعاره كمجرد بحر؛ بل كشاهد على الحب والحزن والشوق للوطن فقال: “و ساحل المتوسط اخترق الأبد، لا توقفوني عن نزيفي ساعة الميلاد، قلدت الزّمان، وحاولتني كنت صعبًا، حاولتني كنت شعبًا حاولتني مرةً أخرى”.
وحضرت القدس بكثرة في أعماله، واعتبرها قلب فلسطين؛ بل وجعلها محورًا مهمًا في أشعاره، نظرًالأهميتها التاريخية والدينية؛ حيث قال عنها: “هي الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض، وليس الوطن أرضًا فقط؛ بل هو الأرض والحق معًا”. وتعد القدس مركز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعتقد أن العمق الثقافي الفلسطيني في أعماله جعل منه شاعرًا له مكانة خاصة في الأدب.
فلسطين في روايات غسان
تمتاز البيئة الفلسطينية بالقدرة على منح كل العلامات دلالة الصمود، ومثلما حضر الزيتون كرمز مقاومة، نجد العود أيضًا يحمل نفس الدلالة في كتابات كنفاني؛ فالموسيقى تمسك بالحياة والإبداع في وجه المحتل، وهذا الحب للحياة والمقاومة، أوضحه بإحدى رسائله إلى غادة السمان، قائلًا: “أنا من شعب يشتعل حبًا، ويزهو بأوسمةِ الأقحوان، وشقائقِ النعمان على صدره وحرفه، ولن أدع أحدًا يسلبني حقي في صدقي”.
ومثلما كان يتمسك بحقه في الحاضر، تمسك بحق الأطفال في المستقبل؛ فقال بإحدى مقالاته الصحفية بجريدة الهدف التي ترأس تحريرها : “الأطفال هم مستقبلنا” وقال أيضًا في روايته: عائد إلى حيفا: “كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقًا صغيرًا يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود”. أي أن خسارة طفل خسارة لا توضع، هي بمثابة خسارة للغد وألم اليوم. والجدير بالتأمل هنا أن أوجاع الشعب الفلسطيني لم تختلف عبر الزمن، وما زال إلى اليوم الزيتون يقلع، والأطفال تقتل.
وكأغلب الفلسطينيين لم ينج الثنائي من تجارب السجن والاعتقال، وهو الأمر المستمر تجاه الفلسطينيين إلى اليوم، وعكس ذلك في أعمالهما من نقل صورة القمع والانتهاكات، وقال كنفاني بإحدى مقابلاته: “إن ضرب السجين هو تعبير مغرور عن الخوف”. ويعد ذلك ملخصًا لرؤية كنفاني، محللًا القمع الإسرائيلي، بالخوف المغرور.
أما عن الأسلوب الأدبي؛ فقد اشتهر غسان بأسلوب السرد الشديد الواقعي والوصف الدقيق؛ في حين نرى كيف كان محمود يتميز بلغته الشعرية الجميلة. كما نجد أن كنفاني كان يركز على تصوير الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال، بينما درويش ركز أكثر على عواطف الحنين والشوق والأمل، ونقطة ثالثة للاختلاف، وهي أن كنفاني تحدث بشكل أكبر عن السياسة والحقوق الإنسانية؛ بينما درويش ركز بشكل أكبر على العاطفة.
بين الدبلوماسية وحمل السلاح
يعكس أدب الثنائي اتجاهين مختلفين ومتقاطعين للمقاومة، وفي رواية غسان : ما تبقى لكم ، أكّد من خلالها موقفه بأنه لا يوجد حل لعودة الفلسطينيين إلا بالعمل الجماعي، وبأن اللجوء في المخيمات ليس حلًا، لقد كان غسان مدركًا وواعيًا لحقيقة مطلقة، مفادها بأنّه لا يمكن الاعتماد على أنّ الدول العربية ستحارب لعودة الفلسطينيين، وهي نفسها التي لم تسمح لهم بتشكيل تنظيمات.
وتعتبر قصيدة درويش الشهيرة “سجِل أنا عربي،”، المثال الأبرز عن التمسك بالهوية العربية، وأشارَ من خلالها لضرورة إسهام الفلسطينيين مع غيرهم من العرب في بناء تاريخيّ يهدف إلى تحرير الأرض .
وفي فترة الستينيات، انضم درويش إلى حركة التحرير الفلسطينية ولعبَ دورًا مهمًا حينها في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، كان ناشطًا سياسيًا ومشاركًا بالعديد من الفعاليات السياسية والنضالية لصالح حقوق الفلسطينيين، وكان دائمًا يدعو للحوار والتسامح، إضافة إلى أنّه كان لديه رؤية إيجابية حول مستقبل المنطقة آنذاك .
على عكس غسان كنفاني الذي انخرط كثيرًا في العمل السياسي والتنظيمي أواخر ستينيات القرن الماضي، وساهمَ برسم وتوضيح توجهات وسياسات الجبهة الشعبية آنذاك، والتي ارتكزت على الكفاح المسلح والعمليات الفدائية؛ فأصبحت بمثابة نهج ثابت لا تحيدُ عنه، وذلك من أجل تحرير فلسطين. وكان يرى أن القضية جزء لا يتجزأ من الحركة العالمية نحو العدالة الاجتماعية، وأسهم بنقل الأمل والصمود وكان يشجع على مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة رغم الصعوبات، وبالأخص نلتمس ذلك حين قال: “هذا العالم يسحق العدل بحقارة كل يوم”، من كتاب أرض البرتقال الحزين.
يقول غسان في رسائله إلى غادة السمان: "إنّ كلّ قيمة كلماتي كانت في أنّها تعويضٌ صفيقٌ وتافهٌ لغياب السلاح".
وعلى الرغم من الاختلاف في رؤية التحرر الفلسطيني بين العمل السياسي والمقاومة بالسلاح، إلا أنهما مساران متقاطعان، إذ يعمل كلاهما على خدمة الآخر، والمقاومة المسلحة إن لم تنطلق من هدف سياسي وتسعى لتحقيقه؛ فهي مقاومة عدمية لا تؤول إلى أي شيء، كالمسار السياسي بدون قوة الأمر الواقع، قد يفضي إلى دور مسرحي ينتهي بفشل أي تفاوض.
فبين قلم غسان كنفاني الذي خاض معركة النضال ضد الاحتلال بقوة الكلمة والسلاح، وبين قصائد محمود درويش التي خطّت الألم والأمل بحروفٍ ملتهبة بالشوق للحرية، نجد أنفسنا أمام أدب يتجاوز الحدود، أدب يصرخ بوجع الأرض السليبة، ويعانق السماء بطموح الحرية. ولا أجد أكثر براعة في تصوير الحنين والشوق للوطن المفقود والمناطق التي يُحرم من زيارتها بسببِ الاحتلال من قول درويش بغصّة ضمن ديوانه الشعري؛ في حضرةِ الغياب: “الحنين وجعٌ لا يحنُّ إلى وجع”. كما لا يغيب عن أذني في تلك اللحظة كلمات غسان “سأظل أُناضل لاسترجاع الوطن لأنّه حقي”.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.