إلى اليوم ما زلت أتذكر ذلك الكتاب الأخضر الصغير الذي كنت أختاره دائما من بين كل الكتب في مكتبة والدي وأعكف على قرأته، يومها كنت للتو قد تعلمت القراءة، لم أكن أفهم شيء بالطبع؛ فقد كنت منهمكة في فك رموز الأحرف. كانت تغمرني سعادة تشبه تلك التي يحسها المخترع بعد نجاح تجربته المئة، مازالت تلك الفرحة نفسها أشعر بها لليوم كلما أبدأ في قراءة كتاب جديد. فالقراءات الأولى تشبه الخطوات الأولى، كلاهن دهشة لا نستطيع الكف عنها.
وللقراءة تاريخ حافل ومتطور، بدأ من المنحوتات القديمة التي تظهر القراء مرورا بأساليب القراءة والمجازات. وطرق القراءة هي الأخرى تطورت عبر الزمن؛ فقد كانت القراءة على الآخرين بصوت عال هي السائدة في العصور الوسطى، وكانت القراءة بصمت عادة غريبة غير محببة كما يذكر ألبرتو مانغويل، أما اليوم؛ فالقراءة بصوت عال تعد أمر فج مناف للذوق خاصة في المكتبات والأماكن العامة منعا للإزعاج، واحتراما للآخر.
وكان مفهوم القراءة سابقا يقتصر على الكتب والمخطوطات، أما اليوم فقد توسع معناه، ودخل في غالب نشاطاتنا اليومية؛ فنحن نقرأ كل يوم رسائل الهاتف، ولوحات الشارع، وتعليمات الاستخدام، وشريط الأخبار في التلفزيون. إننا نفعل كل ذلك مدفوعين برغبتنا في المعرفة، وفي أن نحاط بأكبر قدر من المعلومات عن كل شيء.. ولكن لماذا؟. هل نفعل ذلك لنزيل الغموض عن الأشياء؛ بالتالي تبدو الحياة اكثر سهولة؟. وهل نجد الأمان في المعرفة؟. هل نفعل ذلك لنواكب الحياة ولا نبدو متخلفين؟
في الحقيقة، الأسباب عديدة ومعقده بحيث أن كثيرا من القراء لا يعرفون إجابة هذه التساؤلات البسيطة؛ فهي بالنسبة لهم أشبه بالأسئلة الكبرى عن الكون. أسوأ الإجابات هي أن يخبرك أحدهم أنه يقرأ لأنها هواية!، أي إنه يرى الأمر ترف يمارسه من أجل المتعة؛ فهذه الإجابة تجعلك تفكر كيف لمجتمع أن يتطور على يد أشخاص يعتبرون القراءة طبق تحلية يكملون به مظهرهم الاجتماعي المنمق.
على غرار السؤال الأزلي، هل كانت البيضة أولا أم الدجاجة، أتسائل: هل كان الإنسان قارئ أولا أم كاتب؟، وهنا أميل إلى الاعتقاد أن الإنسان كان في البدء كاتبا؛ وذلك لأن طبعه يميل إلى تناقل الأخبار والأفكار بكل طريقة ممكنه؛ فقد كان يعبر بالإشارات وبالكلام ثم تطورت وسائله إلى الكتابة، ثم أن الكتابة تعني أن ثمة شيء يراد له البقاء فتره طويلة؛ فالتاريخ المكتوب وإن كان يحوي على مبالغات ومغالطات، فهو الأرشيف الأول للإنسان لا يأنف من دراسته وتحليله. على الجانب الأخر؛ لو افترضنا أن القراءة كانت أولا فهذا يعني أن كل كاتب متأثر بمن قرأ له لذا فكل فعل كتابه هو امتداد لسلسلة تأثيرات، وعلى هذا الأساس ستكون حتى الكتابة بأسلوب جديد خلاصة تأثر بمجموعة من الكتاب.
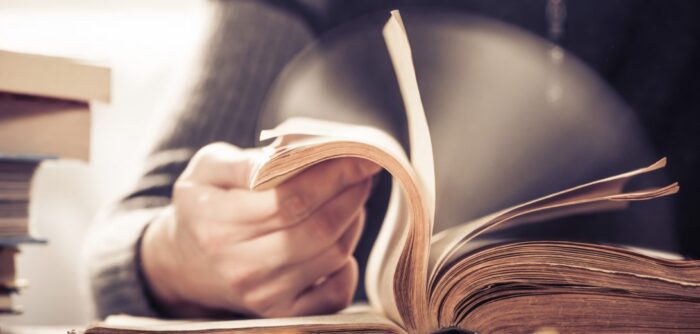
رغم ما أعيبه على برامج التواصل الاجتماعي من نشر الشائعات والتشهير اللاأخلاقي وتهويل الأمور، إلا أنها ساهمت كثيرا في توعية الناس وجعلهم يقرأون. برنامج مثل (الواتساب) كما يحوي الغث؛ فإنه يحوي السمين أيضا، وكان له الفضل في إيصال الكثير من الأفكار للناس التي لا تقرأ سواه؛ فقد ساهم مثلا في إيصال رسالة المعلمين العمانيين في إضرابهم الأخير، ولعب دورا كبيرا في إيصال مطالبهم للناس عبر مجموعة مقالات كتبها المعلمين أنفسهم. هذا على المستوى المحلي، أما عالميا فقد كان تفاعل الناس أكبر من سابقه في نقل وقائع الحرب على غزة، وتناقلوا الصور والفيديوهات تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. مع مرور الوقت ستتراجع الإشاعات، وسيصبح الناس أكثر وعيا في استعمال التقنية، وتمرير المعلومات عبرها.
القراءة المخصصة أحد الأمور التي يجب أن يلتفت لها كل قارئ. والسبب في ذلك بسيط وهو أن المعرفة لا محدودة، بينما الوقت محدود. كما أن القراءة المتخصصة تجعل الأفكار تتضارب والنظريات تتقارع؛ مما يزيد احتمال ولادة شيء جديد يضاف إلى مجال التخصص أو الاهتمام. القراءة هي مرحلة ما قبل الإنتاج للمختصين؛ لذا فهي دائمه متأنية وناقدة، وتصاحبها ملخصات وتعليقات وحواش كثيرة. إن القارئ هنا لا يكون طرف متلقي؛ بل إنه يشارك الكاتب ويتفاعل معه وكأنهما على طاولة واحدة.
من الإشكاليات التي تواجه قارئ اليوم: أنه يلمس فجوة كبيرة بين أمهات الكتب -خاصة الدينية منها- وبين الواقع المعاصر، وهو أمر طبيعي كون هذه الكتب دُونت قبل الآلاف السنين وبما يتناسب مع ظروف سياسة واجتماعيه معينه. ومن غير الطبيعي أن يتم معاملة هذه الكتب بقداسة؛ فيأخذها القارئ بكلها ويرفض نقدها. ومن السلبية أن تُعامل بعض الكتب كالوحي الذي يُوحى؛ فينصب بعضهم منابر للدفاع عنها وإتهام من يعيد النظر فيها بموضوعية “بالسطحية والسخف”، بينما السخف كل السخف أن يصدق القارئ كل ما يقرأ؛ فكما يقول أحدهم: ” توقف عن القراءة فورا، إن كنت تصدق كل ما تقرأه”.
إن القراءة أقرب ما تكون بالسلوك الثوري المستمر، أن تقرأ يعني أنك مستعد دائما للتغيير ولتغير محيطك. إنها رزمة مفاتيح لعوالم متداخلة، وعبر العصور فهم الديكتاتوريون هذا الأمر؛ فحرقوا الكتب ولاحقوا العلماء، بل أن التاريخ يذكر أنه في القرن الخامس قبل الميلاد أمر الامبراطور الصيني بحرق كل الكتب في امبراطوريته؛ فالطاغي يعلم أن سلاح الكلمة أقوى من جيوشه ودباباته؛ لذا هو في قلق دائم من أي وسيله للمعرفة، ويعمل دائما على سدها. وليس أكثر إلهاما من صورة طفل يقرأ بين ركام قريته المدمرة؛ فالعلم وحده سيعيد ترميمها ويبني بلده.




