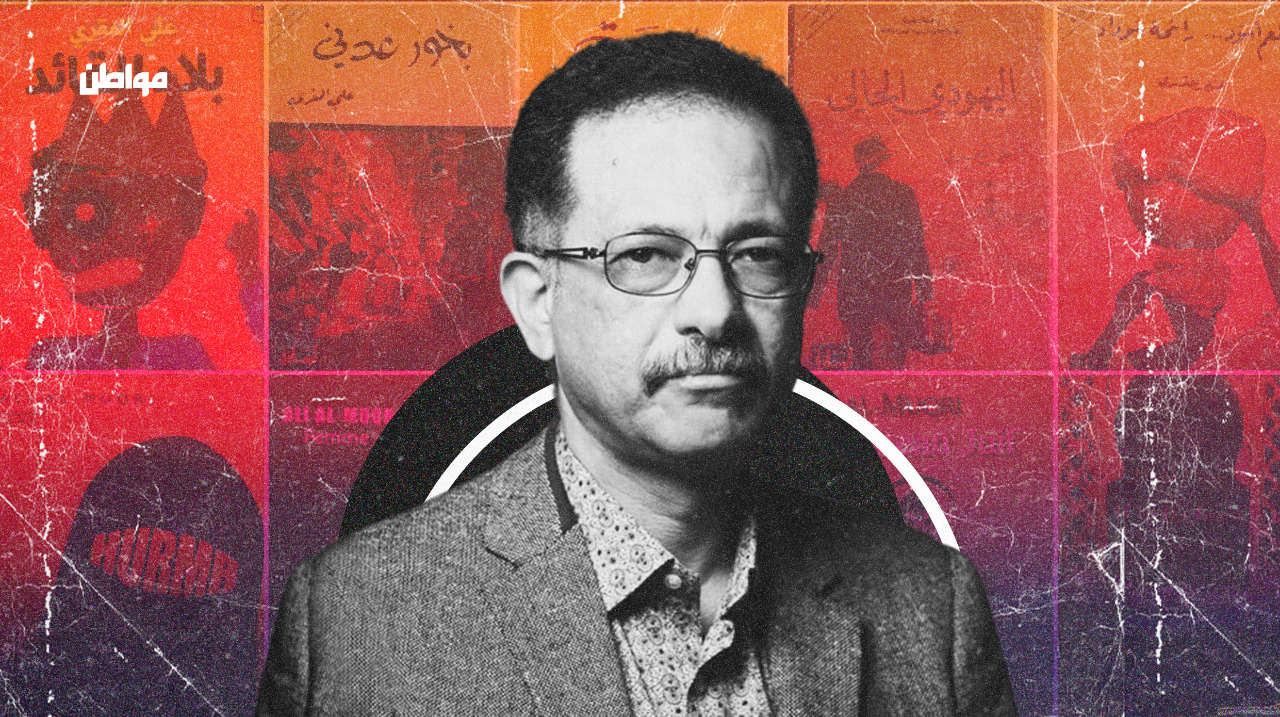حين فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل عزى المعترضون فوزه إلى التطبيع أو إلى روايته المثيرة للجدل أولاد حارتنا، لكن لا أحد من تلك الأصوات وقف عند أسباب أذاعها بيان الجائزة، وهي أسباب وإن شاركه بها البعض إلا أن من بينها سببا لم يتفوق عليه أحد فيه، هذا السبب الحاسم كان ليهب المعترضين حجة أبلغ للتشكيك بأحقيته، كذلك فإن هذا التفوق (المعيب ربما) يفسر لما لم يتحصل عليها مرشح دائم للجائزة في قيمة أدونيس ليفوز بها أديبنا الكبير.
حمل بيان الجائزة “أن أعماله تخاطبنا جميعا”، وذلك فيما أرى هو مصدر تفوق محفوظ على غيره والباعث الرئيسي على فوزه، وتتلخص مهمة هذا المقال في بيان كيف خاطبت أعماله الجميع؟ سؤال يحسن أن يسبق الإجابة عليه التعرف على خطاب بثته أعمال أديب نوبل.
ترشدك النظرة الأولى إلى نص محفوظ أنه نص يهب للقارئ معانيه على الفور، بحيث لا تتخطى عملية القراءة حاجز المعنى الواحد، فلا مجال لتوليد الاستعارات أو تعدد المعاني، أما الكتابة فمستقرة في فضاء المشابهة، ساكنة في عالم التكرار، مستهدفة بذلك تأكيد “النحن” وإثبات الهوية، ليولي النص دوما وجهته إلى حقيقة يعتقدها وتطابق ينشده ووحدة يؤكدها.
تتعدد شخصيات نجيب محفوظ في أعماله تعددا واسعا لكن رغم ذلك تبصرها فقيرة في اختلافها، بمعنى أن كلا منها لا يبالي بالآخر، لا يؤثر ولا يتأثر بغيره (من الداخل)، ليطابق كل منها ذاته مطابقة تجعل جميع شخصيات العمل الروائي توجد من أجل ذاتها، بهذا يمسي تعددها أقرب إلى صورة التعدد الرياضي أي أقرب للتجريدي منه إلى الواقعي.
هذا “الفقر” يمتد إلى الثيمات، فتستطيع بسهولة أن تحصر الأعمال الروائية (السابقة على الجائزة بحسب موضوع المقال) لأديبنا الكبير ـ على كثرتها ـ في عدد محدود جدا من الثيمات، ثيمة السقوط مثلما يمثلها “محجوب عبد الدايم” و”إحسان” في “القاهرة الجديدة”، حميدة في “زقاق المدق”، عيسى الدباغ في “السمان والخريف”، عمرو الحمزاوي في “الشحاذ”، جعفر الراوي في “قلب الليل”…
بينما التزمت أعمال أخرى بثيمة الفتوة الشرير ـ في أغلب الأحيان، الخير في أحيان أخرى ـ الذي يتجبر على آخرين خائفين مستسلمين عادة، متمردين نادرا. هو خوفو في “عبث الأقدار”، الملك في “رادوبيس”، ملك الرعاة في “كفاح طيبة”، السيد أحمد عبد الجواد (ممارسا الفتونة داخل منزله) في “بين القصرين”، شهريار في “ليالي ألف ليلة”، سعيد مهران في “اللص والكلاب”، خالد صفوان في “الكرنك”، الناجي وسلساله في “الحرافيش“… حتى في رواية مثل ثرثرة فوق النيل الفتوة حاضر وإن كان أقل إنكشافا (لأننا نخاف البوليس والجيش والإنجليز والأمريكان… فقد انتهى بنا الأمر إلى ألا نخاف شيئا)، لتجيء حكايات حارتنا فتنكشف عبرها هذه الدائرة المغلقة بصورة أكثر وضوحا، أننا أمام أعمال تتبدى في عناوينها متنوعة لكنها في حقيقتها واحدة، تبدو ثرية بشخوصها وأحداثها إلا أنها فقيرة في تكرارها، تروج للاستقرار ببحثها عن عناصر الاستمرار: الفكرة الواحدة والحاضر المستند إلى حتميات قارة و”النحن” الذي لا يطرأ عليه تغيير ذو بال، ليروج كاتبنا بذلك إلى وهم طالما كان جذابا لنا، وهم الخلود.
أما اللغة فهي بعيدة عن أن تكون نسقا يفيض بالمعاني أو تكثيفا يوحي بالتأويلات، إنما اللغة هنا كلمة ولفظ يحاصر المعنى ويحصره ليدركه الجميع على ذات الهيئة. الكتابة بذلك تحافظ على المعنى لكنها لا تنتجه، ليمسي هذا موطنا من مواطن الجذب في عالم محفوظ، إذ يجوبه القارئ في يسر وثقة، متنقلا بين جوانب هذا العالم في اطمئنان وسكينة؛ لشدة ما ألفه، فالقارئ في كل مرة يصادف داخل النص الحكمة التي ترددت على مسامعه مرارا وصوت الأخلاق الذي درج عليه والعقل الذي طالما حادثه بحديث لا يأباه.
الخطاب المحفوظي بذلك هو خطاب تواصل ووحدة، خطاب إقناع واقتناع، خطاب اطمئنان وسكينة، خطاب ألفة وحنين، خطاب ذاكرة واتصال، خطاب امتلاء (تكرار واعتياد) لا يترك حيزا للفراغ (الجدة والغرابة) خطاب انغلاق، خطاب الإجابة الجاهزة، خطاب الماضي.
وإذا انتقلنا إلى أدب أدونيس فنحن أمام نص يتبدى على صورة مقاطع تنفر من الوحدة من حيث هي انعكاس للمعنى الواحد، فأنت في مواجهة نص باذخ في معانيه، مفتوح أمام مختلف التأويلات، ذلك الاختلاف الذي يصل إلى حد أنه يجعل “الواقع ذاته بنية لاشعورية”، يتجاوز النص بذلك عتبة القراءة الواحدة إلى القراءات المتعددة، أما الكتابة فتضيق بمنطق الهوية (المغلقة) أو هي على الأحرى، لا تعرفه، لا حقيقة تركن إليها، ولا تطابق تسعى لإبرازه، معرضة عن معاني الاستمرار والوصل.
تفيض اللغة هنا بالمعاني إذن، فلسنا إزاء نص بل نصوص متعددة، ليمسي التعدد سمة الهوية والانفتاح صفة الوجود والكثافة خاصية الزمن، يتسم عالم أدونيس بالغرابة، لذلك فالتجوال خلاله يشعرك بالاغتراب، أنت تتجول في أروقة لم تألفها ودهاليز تتعرف عليها للمرة الأولى، الكتابة وفق هذا المنحى نشاط أو اسراتيجية لمرواغة اللغة أو هي “لغة تحارب اللغة”.
الخطاب الأدونيسي بذلك خطاب انفصال وقطيعة، خطاب تعدد، خطاب شك وحيرة، خطاب غربة واغتراب، خطاب حرية وتحرر، خطاب فراغ (جدة)، خطاب انفتاح وسؤال، خطاب المستقبل.
إذن نحن أمام خطابين مغايرين، فبينما توجه أدونيس بخطابه إلى المستقبل ( إلى اللا أحد) خاطب محفوظ الماضي المستقر فينا والذي يألفه الغربي ـ كذلك ـ كل الألفة، وينجذب إليه كل الانجذاب، فمنذ أيام الاستشراق الأولى والغربي شغوف بما كان ينقله المستشرق مما يقع في تلك الحارات المحافظة المنغلقة على سكانها، خاصة ما كان يجري في حرملك أهلها، ليتحايل المستشرقون التشكيليون ـ على سبيل المثال ـ بشتى الحيل لتصوير تلك المخادع وغالبا ما عجزوا؛ عندها كان خيالهم يجمح مشكلا صورا لحياة النساء تلهب خيال الغربي أكثر عن عالم الآخر.
خاطب أدب محفوظ شغفهم القديم، وعالج في مهارة وحرفية عالية صورة مستقرة بوجدان الغربي، فإذا كانت الجائزة مثلما أراد لها أن تكون لكاتب شرقي فمحفوظ كان مثلما ينبغي للكاتب الشرقي أن يكون، لذلك فكما سجل بيان الجائزة فإن أعمال أديبنا الكبير “خاطبت الجميع” على الحقيقة، بينما لم تخاطب أعمال أدونيس أحدا، فقد توجهت بخطابها إلى المستقبل، مستقبلنا.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.