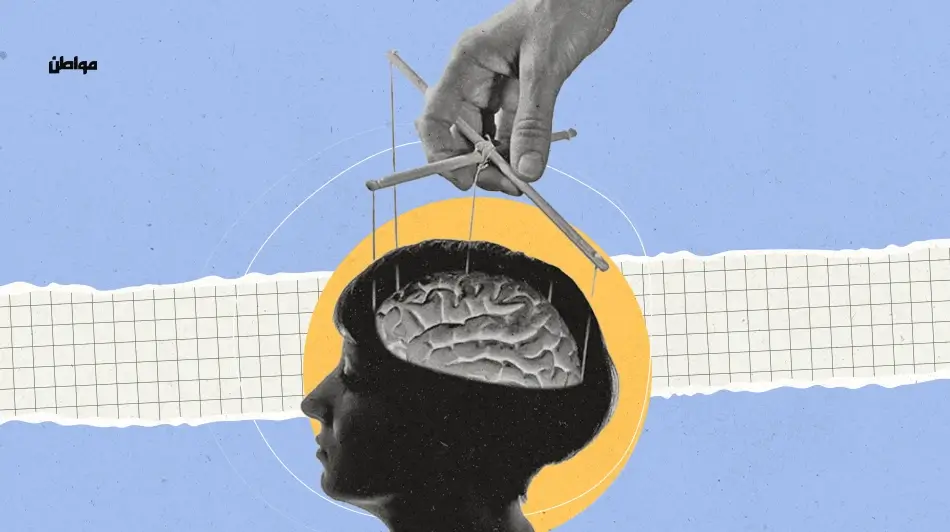صوفيون بطشت بهم السلطة إرضاء للفقهاء: السهروردي المقتول نموذجًا
عرف التاريخ الإسلامي -في الكثير من الفترات- صراعًا شرسًا بين الفقهاء والصوفية. نظر الفقهاء للدين باعتباره أوامر حرفية ينبغي تنفيذها بكل حزم؛ فيما تعاطى الصوفية مع الإسلام باعتباره تجربة روحية بالمقام الأول. ومن ثم أفسحوا مساحة واسعة للمشاعر والتجربة الفردية الحسية.
في خضم ذلك الصراع، اختارت السلطات الحاكمة -في أغلب الأوقات- أن تتبنى وجهة النظر الفقهية الأرثوذكسية، لما لها من قوة وحضور في أوساط العامة. في هذا السياق قُتل العديد من الصوفية بطريقة بشعة على يد الساسة المؤيدين بالفقهاء التقليديين، ومن هؤلاء كل من الحسين بن علي الحلاج في القرن الرابع الهجري، وعماد الدين النسيمي في القرن التاسع الهجري.
في هذا المقال، نلقي الضوء على واحد من أبرز الشخصيات الصوفية التي لاقت حتفها على يد التحالف المنعقد بين الساسة والفقهاء، وهي شخصية الصوفي الشهير يحيى بن حبش السهروردي، المتوفى في سنة 587هـ والمشهور باسم السهروردي المقتول. من هو السهروردي؟ وما أبرز المعالم التي ميزت منهجه الفكري وطريقه الصوفي؟ وكيف وقعت نهايته على يد السلطان الشهير صلاح الدين الأيوبي؟
من سُهرورد إلى حلب
ولد شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش سنة 549هـ في مدينة سُهرورد، التي تقع في الشمال الغربي من إيران. كان من المعروف أن أكثر سكان تلك المدينة من الأكراد الذين اعتادوا الإقامة في المعاقل الجبلية. يُنسب إلى سُهرورد مجموعة من العلماء الكبار الذين ذاع صيتهم في الحضارة الإسلامية، من أمثال أبي النجيب السهروردي المتوفى 563هـ، وشهاب الدين عمر السهروردي المتوفى 632هـ.————-
بعد فترة قصيرة من اتصال السهروردي بالأمير غازي، أدرك الفقهاء أن السهروردي قد تمكن من عقل حاكم حلب، ولذلك أرسلوا إلى صلاح الدين برسالة، وأكدوا فيها أن شهاب الدين السهروردي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأمور في حلب
يذكر الباحث العراقي الدكتور كامل مصطفى الشيبي في مقدمة كتابه “ديوان السهروردي المقتول”، المراحل الدراسية المختلفة التي مر بها يحيى بن حبش. يذكر الشيبي أنه تلقى دروسه الأولى في القرآن والحديث والتفسير في العاشرة من عمره على يد الشيخ مجد الدين الجبلي في مدينة مراغة، وقيل إن السهروردي في تلك الفترة تعرف على فخر الدين الرازي المتوفى 606هـ، والذي سيذيع صيته فيما بعد بوصفه واحدًا من أهم المتكلمين الأشاعرة، وإن الطفلين كانا زميلي دراسة في حلقة علم الشيخ مجد الدين.
تحرك السهروردي بعدها إلى أصفهان، والتقى فيها ببعض الفلاسفة المتأثرين بكتابات الفيلسوف ابن سينا. قام السهروردي في تلك المرحلة بكتابة بعض القصائد، كما أنه ترجم كتاب “رسالة الطير” لابن سينا إلى اللغة الفارسية. انتقل بطلنا بعد عدة شهور إلى ديار بكر، وعبّر عن التطور الذي طرأ على أفكاره ومعتقداته من خلال تصنيفه للكتاب المعروف باسم “الألواح العمادية”. قيل إن السهروردي ألف ذلك الكتاب لواحد من أمراء الأراتقة الذين كانوا يحكمون جنوب الأناضول وشمال الجزيرة الفراتية.
انتقل السهروردي بعد ذلك لبلاد الشام، زار دمشق ومكث فيها لفترة قصيرة، ثم انتقل إلى حلب سنة 579هـ وكان في الثلاثين من عمره وقتها. تزامن ذلك مع نجاح سلطان مصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في إخضاع حلب وضمها إلى أملاكه الواسعة.
في حلب: من الشهرة إلى القتل
اشتهر أمر السهروردي بعد دخوله لحلب، ودفعت علومه الواسعة في مجالات الطب والفلسفة والمنطق الناس دفعًا للقائه والسماع منه. كان أحد العوامل المهمة التي تسببت في شهرة السهروردي يتمثل في ميله الدائم للتقشف والزهد. يُحكى أنه كان يلبس الثياب البالية، وأن هيئته كانت أقرب للفقراء والمساكين. ذكره أحمد بن علي الدَّلجي المتوفى 838هـ في كتابه “الفلاكة والمفلوكون”؛ فوصفه بقوله: “كان زري الخلقة دنس الثياب وسخ البدن، لا يغسل له ثوبًا ولا جسمًا، ولا يقص ظفرً ولا شعرًا، وكان القمل يتناثر على وجهه ويسعى على ثيابه”. روي عن السهروردي أنه لمّا سُئل عن سبب قذارة ثيابه أجاب بقوله” “ما حييت لغسل الثياب، لي شغل أهم من ذلك”.
سمع حاكم حلب، غازي بن صلاح الدين عن السهروردي، فالتقى به وسمع منه، وعرف أن عنده معارف وعلومًا لم تُمنح لغيره من علماء حلب، لذلك قربه من مجلسه، وصار غازي -الذي لم يصل العشرين من عمره بعد- واحدًا من مريدي السهروردي. يقول ابن أبي أصيبعة المتوفى 668هـ في كتابه “عيون الأنباء في طبقات الأطباء”، واصفًا تلك الظروف: “وناظر بهَا -أي بحلب- الْفُقَهَاء، وَلم يجاره أحد فَكثر تشنيعهم عَلَيْهِ؛ فَاسْتَحْضرهُ السُّلْطَان الْملك الظَّاهِر غَازِي بن الْملك النَّاصِر صَلَاح الدّين يُوسُف بن أَيُّوب، واستحضر الأكابر من المدرسين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين ليسمع مَا يجْرِي بَينهم وَبَينه من المباحث وَالْكَلَام؛ فَتكلم مَعَهم بِكَلَام كثير؛ فبَان لَهُ فضل عَظِيم وَعلم باهر، وَحسن موقعه عِنْد الْملك الظَّاهِر وقربه وَصَارَ مكينًا عِنْده مُخْتَصًّا بِهِ”.
مواضيع ذات صلة
كان من الطبيعي أن يلفت السهروردي الأنظار إليه. أقبل العلماء والفقهاء على مناظرته ومناقشته في أفكاره. عرفوا بعد مدة قصيرة أنهم لن يتمكنوا من التغلب عليه؛ فأوقعوه في بعض الحيل عندما سألوه إن كان الله بقادر على أن يخلق نبيًا بعد النبي محمد، أجاب السهروردي على هذا السؤال بقوله: إن الله لا حد لقدرته. اتهمه الفقهاء بعد تلك الإجابة بالكفر والزندقة، وقيل إن: الأخوين الفقيهين زين الدين ومجد الدين ابني جهبل، هما اللذان تزعما حركة معارضته وتفسيقه.
بعد فترة قصيرة من اتصال السهروردي بالأمير غازي، أدرك الفقهاء أن السهروردي قد تمكن من عقل حاكم حلب، ولذلك أرسلوا إلى صلاح الدين برسالة، وأكدوا فيها أن شهاب الدين السهروردي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأمور في حلب. يذكر المؤرخون أن صلاح الدين -المشهور بمعاداته للفلسفة والمنطق- كتب إلى ابنه في سنة 587هـ يأمره بقتل السهروردي. يقول ابن أبي أصيبعة: “فَبعث صَلَاح الدّين إِلَى وَلَده الْملك الظَّاهِر بحلب كتابًا فِي حَقه، وَهُوَ يَقُول فِيهِ إِن هَذَا الشهَاب السهروردي لَا بُد من قَتله، وَلَا سَبِيل أَنه يُطلق وَلَا يبْقى بِوَجْه من الْوُجُوه”. تختلف الأقوال في الطريقة التي قُتل بها السهروردي. تذكر بعض الروايات أنه قتُل خنقًا، فيما تذكر روايات أخرى أنه طلب من صديقه غازي أن يُترك لحال سبيله في مكان ليس به ماء أو طعام؛ فظل يعاني العطش والجوع في ذلك المكان حتى مات، ولم يتعد الثامنة والثلاثين عامًا عند وفاته.
تقييم السهروردي المقتول
أتفق الكثير من المؤرخين على القول بسعة علم السهروردي. على سبيل المثال وصفه ابن أبي أصيبعة بأنه “كانَ أوحد أهل زمانه فِي الْعُلُوم الْحكمِيَّة، جَامعًا للفنون الفلسفية، بارعًا فِي الْأُصُول الفلكية، مفرط الذكاء جيد الْفطْرَة فصيح الْعبارَة، لم يناظر أحدًا إِلَّا بزه، وَلم يباحث محصلًا إِلَّا أربى عَلَيْهِ”.
على الجانب الآخر، اختلف المؤرخون في تقييم عقائد وأفكار السهروردي. يذهب الكثيرون إلى أنه كان سنيًا شافعيًا، بينما يميل البعض للقول بأنه: كان يعتنق الأفكار الإسماعيلية النزارية، وأنه كان يدعو سرًا لنشر الفكر الباطني في بلاد الشام.
تمنحنا الإشارة السابقة مفتاحًا مهمًا لفهم السبب الذي شجع صلاح الدين الأيوبي لإصدار قراره السريع ضد السهروردي. كان صلاح الدين قد أسقط الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر منذ أعوام قلائل، لم يكن يحتمل ظهور أي دعوة جديدة للشيعة الإسماعيلية في بلاد الشام. زاد الطين بلة أن السهروردي ارتبط بعلاقات متينة بأمراء الأراتقة الذين حاربوا صلاح الدين مرارًا في شمال الشام. معنى ذلك أن صلاح الدين نظر للأمر بشكل سياسي بحت. كان السهروردي حليفًا محتملًا لأعدائه، وكان التخلص منه أمرًا لا مفر منه؛ خصوصًا وأن فقهاء الشام قد طلبوا قتله والتخلص منه من قبل مرارًا وتكرارًا.
تظاهرتْ مجموعة من العوامل أدّتْ إلى مأساةِ شهاب الدين السهروردي، ومن ذلك حقيقة ظهورِه على سلطةِ النّخبة الدينيّة في حلب –والتي كان عليها اعتماد الأيّوبيّين في شرْعنةِ سيطرتهم السياسيّة على المدينة
على الجهة المقابلة، يمكن القول بأن أفكار السهروردي عن فلسفة الإشراق، استعصت على أفهام معاصريه من الفقهاء والعلماء؛ خصوصًا وأن شهاب الدين اعتمد على الأمثال والنماذج التي استخدمها حكماء بلاد فارس قديمًا. يظهر ذلك في قوله في كتابه حكمة الإشراق: “إنّ قاعدة الإشراق هي طريق النور والظلمة التي كانت طريقة حكماء الفرس، مثل جاماسب وفرشادشير وبزرجمهر ومَن قبلهم”.
يذكر سيد حسن نصر في كتابه “ثلاثة حكماء مسلمين”، الأثر الفارسي الواضح في كتابات السهروردي، فيقول: “قد استخدم الرموز الزرادشتيَّة، كما استخدم آخرون كجابر بن حيَّان مثلاً الرموز الهرمسيّة للتعبير عن تعاليمه”. ظهرت تلك الرمزيات في مؤلفاته المشهورة، ومنها على سبيل المثال “التلويحات اللوحية والعرشية” و”اللمحة” و”هياكل النور” و”المعارج والمطارحات”.
أيضًا، ظهرت فلسفة السهروردي الصوفية الباطنية في الكثير من الأشعار المنسوبة إليه؛ فقوبلت تلك الأشعار بمعارضة الفقهاء الملتزمين الذين رأوا فيها نوعًا من أنواع الكفر والزندقة. من تلك الأشعار قوله:
إليكَ إشاراتي، وأنت الذي أهوى… وأنت حديثي بين أهل الهوى يُروى
وأنت مراد العاشقين بأسرهم… فطُوبى لقلب ذاب فيك من البلوى
محبوك تاهُوا وتولَّهوا… وكل امرئ يصبو لنحو الذي يهوى
حاولت المستشرقة روكسان ماركوت في مقالها المنشور على موقع موسوعة ستانفورد، أن تبيّن العوامل المختلفة التي أسهمت في خلق المأساة التي تعرض لها شهاب الدين السهروردي، فقالت: “تظاهرتْ مجموعة من العوامل أدّتْ إلى مأساةِ شهاب الدين السهروردي، ومن ذلك حقيقة ظهورِه على سلطةِ النّخبة الدينيّة في حلب –والتي كان عليها اعتماد الأيّوبيّين في شرْعنةِ سيطرتهم السياسيّة على المدينة، على صعيدٍ آخر، اتّهِم السهروردي باعتناقه أفكار الزنادقة، وهي تهمة غامضة دعمتْ باعتمادِه على أعلام ورموز فارس ما قبل الإسلام، التي وجِدتْ مبْثوثةً في بعض كتبه، وادِّعائِهِ الإلهام الإلهيّ، ومساءلتِه أخيرًا عن قدرة الله المطلقة وعلاقتها المنطقيّة بختْمِ النّبوّة”.
يبقى السهروردي المقتول واحدًا من الشخصيات المحيرة، تلك التي اختلف الناس في أمرهم عبر القرون. يوضح ابن خلكان المتوفى 681هـ في كتابه “وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان” ذلك الاختلاف؛ فيقول إنه لمّا زار حلب وسأل أهلها عن شهاب الدين السهروردي: “رأيت أهلها مختلفين في أمره، وكل واحد يتكلم على قدر هواه؛ فمنهم من ينسبه إلى الزندقة والإلحاد، ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من أهل الكرامات، ويقولون: ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك، وأكثر الناس على أنه كان ملحدًا لا يعتقد شيئًا”.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.