في المقالين السابقين ألقينا الضوء على الجذور الدينية للعلاقة بين إسرائيل والعالم الغربي، وخصصنا المقال الثاني للحديث عن لعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تحديدًا، مقدمة تعريفية بسيطة عن الصهيونية المسيحية وآثارها وزعمائها ومؤسسيها وطريقة انتشارها في العالم الغربي، ولسنا بصدد تكرار ما قلناه فيهما.
أما اليوم؛ فنغطي جوانب أخرى جديدة نشرح فيها المذهب “الصهيو- مسيحي”، وكيف اختلط على البعض تسمية ذلك المذهب وآثاره وانتشاره بالعالم، ونخصص جزءً من ذلك الجانب في مناقشة الجذور الفكرية التأسيسية، بهدف استيعاب ذلك الفكر وهضمه؛ فلا مانع من عقد المقارنات بينه وبين جوانب من الفكر الإسلامي كمثال للتبسيط؛ فالآثار التي ينتجها ذلك المذهب على الواقع المعاصر تفرض علينا هذا الاهتمام والتبسيط مع الوضوح الكامل لسد الثغرات والإجابة على الأسئلة الغامضة، ورأيت أنه من المناسبة للغاية شرح هذا الفكر الصهيوني بالتوازي مع الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في قطاع غزة ضد الفلسطينيين؛ حيث يجري تمثيل الماضي في الحاضر والنظرية في التجربة.
الصهيونية المسيحية أو Christian Zionism هو أحد أشهر وأقوى الأيديولوجيات الدينية والسياسية المؤثرة في العالم الحديث، ويقوم في جوهره على الدعوة إلى تسكين وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة بفلسطين لإنشاء دولة أرض الميعاد، التي هي شرط أساسي للمجيء الثاني للسيد المسيح، والذي يقوم بدوره ببناء الهيكل الثالث بعد تهدمه مرتين، الأولى سنة 587 ق.م على يد “بختنصر البابلي”، والثانية سنة 70م على يد الإمبراطور الروماني “تيتوس”، ويدعم هذا التيار أفكاره الدينية من نصوص بعدة أسفار في العهد القديم أو التناخ في العبرية، أشهرها التكوين وإشعياء وحزقيال وصموئيل وغيرها، وهي نصوص مقدسة في الدينين اليهودي والمسيحي، مع خلافات في أوجه التعاطي والتناول هو الذي خّصّ المذهب الإنجيلي/ البروتستانتي المسيحي تحديدًا، دون بقية طوائف المسيحية في الإيمان بالصهيونية، وهذا ما سنشرحه في السطور القادمة.
مارتن لوثر وابن تيمية
تبدأ القصة من القرن السادس عشر الميلادي مع القس الألماني “مارتن لوثر” (1483- 1546م)؛ حيث دعا للثورة على الكنيسة الكاثوليكية متضمنًا رفض صكوك الغفران وقدسية الكهنة والاعترافات وغيرها من القضايا التي شكلت فارقًا بالقرون التالية، بين المذهب البروتستانتي التابع لمارتن لوثر، والذي يُشار إليه بالإنجيلي، وبين المذهب الكاثوليكي الذي ما زال يعتمد على قدسية الكهنة والكنيسة ووجوب صك الغفران والاعترافات للتكفير عن الخطايا والذنوب، وسمي مذهبه بالإنجيلي لنداءاته بالاعتماد فقط على الكتاب المقدس – بعهديه القديم والجديد – كمرجع وحيد للإيمان المسيحي، ونبذ ما عداه من رسائل وكتب للكهنة والبابوات.
كان ما يدفع مارتن لوثر لاعتناق أفكاره أنه يرى بأن العلاقة بين الله والإنسان هي علاقة مجانية ومباشرة يمكن فيها التوبة والغفران دون تكاليف مادية، وأن الذي يُرهق المسيحي بصكوك الغفران والسيمونية (شراء الرهبانية) هم الكهنة الكاثوليك، بعيدًا عن جوهر المسيحية التي لم تقل بهذا الشئ، وأن الإيمان الحقيقي هو إيمان سلف المسيحيين الأوائل الذين لم يعرفوا كتب وتعاليم الكنيسة والبابوات، وتلك الجزئية أبرز ما يُحدث الفارق بين المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي، والذي بنظرة فاحصة بالتاريخ الإسلامي نراه قد تكرر في التاريخ برفض الحنابلة والوهابيين الفكر الصوفي والأشعري المتضمن قدسية الأولياء والتوسل والاستغاثة ووجوب الذهاب للأضرحة؛ فكان الوهابيون يعترضون على ذلك بأن العلاقة مجانية ومباشرة دون وسيط، وأن الإيمان الحقيقي هو إيمان سلف المسلمين الأوائل الذين لم يعرفوا الأضرحة والأولياء والأئمة، وهذا الذي حمل بعض المفكرين بالقرنين التاسع عشر والعشرين، بوصف الوهابية بأنها ثورة إصلاحية قبل فحص جوانبها ولمس منتجاتها السياسية والدينية لاحقًا، والذي تبين بشكل مؤكد أنها عنيفة ودموية.
ثورتان دينيتان متشابهتان
إن ثورة مارتن لوثر شبيهة بثورة ابن تيمية الحراني، مع فوارق كبيرة لا يتسع المقام لذكرها، وسنركز هنا على بعض التشابهات بين الاثنين، والذي سنسوق فيه التشابه بين منتجهما الفكري وليس لشخصيهما؛ فالمقارنة إذًا ستكون بين البروتستانتية والمذهب الوهابي أو التيميّ المعاصر.
البروتستانتية هي قراءة ظاهرية للكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد)، لم يهتم فيها المفسرون المسيحيون ببواطن ومقاصد النصوص، ولا بالنزعة التأويلية التي تبحث في ما وراء المعاني، وهو نفس الاتجاه الذي ميز ابن تيمية الحراني والوهابيين بالمجمل، مقلدين فيها الحنابلة الأوائل الذين تميزوا بالفكر الظاهري والإيمان بالحرفية النصوصية، التي جعلتهم في مرمى الاتهام بالتشبيه والتجسيم لعجزهم عن تأويل النصوص أو التفكر فيها فلسفيًا وعقليًا، تابع مقالنا المنشور على مواطن في تاريخ 23 مارس 2023 بعنوان “أضواء على المجسمة بالتاريخ الإسلامي“.
والذي حمل البروتستانت على هذا التوجه الظاهري هو نفي الوسيط المتأمل والمتفكر الذي كان ينزع أحيانًا للتأويل والتدبر العقلي من أجل التوفيق بين النص والعلم؛ فنفي قدسية الكنيسة والرهبان وعدم جدوى صكوك الغفران والاعترافات كلها آليات ووسائل جعلت المسيحي محتكًا بالنص الديني مباشرة دون أن تكون لديه المرجعية العلمية الكافية، أو الوسائل العقلية والعلمية التي تساعده في صياغة مرجعية مستقلة، أو حتى مشروع ديني خاص أو نظرية عقائدية محكمة، لذا فعند قراءة البروتستانت بعض الآيات في أسفار التكوين وحزقيال وإشعياء وصموئيل وغيرها، والتي تبشر بقدوم دولة أرض الميعاد على أنها شرط أساسي لمجيء السيد المسيح الثاني؛ فلا خيار آخر سوى الإيمان بحرفية النص دون تأويله، لأن إمكانية التأويل منعدمة.
والأمر الآخر الذي ساعد على بروز الفكر الظاهري في البروتستانتية هو خروجها من رحم المجتمع الإنجليزي، ثم انتقالها للمجتمع الأمريكي مثلما شرحنا في الدراسة السابقة بعنوان “أميركا وإسرائيل، تحالف ديني أم شراكة وتبعية سياسية؟”، والفكر الإنجليزي متميز فلسفيًا بالتحليل والمنطق والبراجماتية، وهي رؤية فلسفية مادية تحمل الإنجليز على أن يكونوا أكثر ظاهرية في رؤية الأحداث، والميل جانبًا عن التأويل والتفكر فيما وراء المعاني، وقد خضنا في ذلك بعدة حلقات فلسفية أشرنا فيها إلى دور المجتمع الإنجليزي في تأسيس “الوضعية المنطقية” و “الفلسفة التحليلية“، وكذلك دور المجتمع الأمريكي الذي هو أحد صنوف العقل الأنجلوساكسوني البريطاني في تأسيس وصياغة الفكر البراجماتي، وهي جميعها أفكار وفلسفات لا تهتم بالتأويل، بينما تُقدم الحس والبرهان العملي على النظريات والميتافيزيقا.
التشابه الثاني
ولأن المذهب البروتستانتي ظاهري الفكر؛ فهو مشتبك دراميًا وتطبيقيًا مع النص الديني، ويتخيل أحداثه في الواقع المعاصر، ويميل لتطبيق حرفيته النصوصية دون النظر للمقاصد والمصالح، ذلك لأن الفكر المقاصدي هو خصيصة للعقل المتدبر الذي يبحث في الدلالات التضمنية والسياقات، ونظرًا لهذه الطبيعة للبروتستانت فقد اشتبكوا أولاً مع الكاثوليك الذين يرون الدين المسيحي بطريقة مختلفة فيها تأويل وتدبر، وبالتالي فالنصوص السياسية بالكتاب المقدس لا تؤخذ على ظاهرها، ومن بينها دولة أرض الميعاد، التي هي وفقًا للكاثوليك يجري تفسيرها بمعزل عن التاريخ، ووفقًا لتيار القطيعة مع التراث الذي يرى أن نصوص ذلك التراث سياسيًا لها مقاصد وتأويلات ليست في الواقع الحسي.
وأشهر هذه النظريات التي يراها الكاثوليك والأرثوذكس عمومًا لدولة أرض الميعاد، هي أنها في السماء، أو أنها كانت تجربة تاريخية أكثر منها فريضة دينية واجبة، لذا فمجرد القول عند الكاثوليك بإقامة دولة سياسية دينية مختلفة عقائديًا، هي إعلان حرب دينية عليهم، ومشروع هدم للمسيحية يستوجب المقاومة، وهذه أحد أبرز دوافع وأسباب اشتعال الحرب الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت بالقرون الوسطى، والتي حصدت أرواح عشرات الملايين فيما بين القرنين 16 و 19م
البروتستانتية هي قراءة ظاهرية للكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد)، لم يهتم فيها المفسرون المسيحيون ببواطن ومقاصد النصوص، ولا بالنزعة التأويلية التي تبحث في ما وراء المعاني، وهو نفس الاتجاه الذي ميز ابن تيمية الحراني والوهابيين بالمجمل
وذكري هنا لمثال أرض الميعاد ليس إشارة إلى مركزية وسببية هذه الحروب لأرض الميعاد، ولكن لشرح طريقة التفكير والعلل التي أدت لهذه الحروب، بيد أن فكرة أرض الميعاد الدينية ووجوب إقامة دولة لليهود بفلسطين ظهرت متأخرًا في القرن 19م، ولم يُلحَظ وجودها في التاريخ قبل ذلك مثلما شرحنا في الحلقات السابقة، ويمكن تشبيه هذه الحرب الطائفية بالثورات الوهابية ضد العثمانيين والشيعة التي كانت في جوهرها دينية طائفية، يميل فيها الوهابيون لتطبيق ظاهر الحرف الديني ونصوصه التاريخية، وإحياء الشق السياسي المعطل بالتراث، ضد الصوفيين والشيعة المسيطرين على العالمين الإسلامي والعربي في القرون من 18 – 20م
التشابه الثالث
تميل السلطة السياسية للقطيعة مع الظاهريين الحرفيين، بينما تفضل أصحاب الفكر والتدبر والتأويل حفاظًا على مصالحهم، وهذا سر العلاقة الوطيدة التي حكمت خلفاء بني العباس مثلاً مع فقهاء الأشعرية والماتريدية منذ وثيقة القادر بالله سنة 408هـ وحتى اليوم، وسر العلاقة الوطيدة أيضًا بين الكنيسة المسيحية والإمبراطور الروماني التي ظلت في جوهرها تتعلق بتأويل وقياسات وآراء الكهنة للنص الديني غير المتناسب مع الواقع، في ظل إمكانية إحياء هذا النص الديني لضرورة التصدي للأعداء أحيانًا، أو عندما يرغب الإمبراطور في التوسع وضم الأراضي، مثلما حدث ذلك في حروب الإمبراطورية الرومانية المقدسة الأخيرة قبل سقوطها سنة 1806م.
يعني هذا أن السلطة الإنجليزية لم تتحالف مع زعماء البروتستانتية لطبيعة أفكارهم الظاهرية المتشددة، لذلك سارعت بفصل الدين عن الدولة، واندفعت تحت ضغط الحاجة والضرورة لإعلان أول دستور في بدايات القرن 18 بعد إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689م، وقانون الاتحاد سنة 1707م، وانتقل ذلك للولايات المتحدة آليًا في نهاية القرن سنة 1787م، ومن ذلك يتبين أن أشهر وأهم دول البروتستانت (إنجلترا والولايات المتحدة) هما أول من سارعا بفصل الدين عن الدولة، وإعلان العلمانية رسميًا خشية الاشتباك مع النص الديني التاريخي غير المتناسب، ويفسر هذا الجانب أيضًا سهولة مسارعة الإمارات والكويت مثلاً – ونوعًا ما السعودية حاليا- برفع شعارات فصل الدين عن الدولة وتطبيق العلمانية رغم طبيعة أفكار شعوب هذه الدول الحنبلية، والمتأثرة بابن تيمية الحراني.
بينما يصعب ذلك في دول كمصر التي يسود فيها المذهبان الأشعري والصوفي، ويجلس الأزهر كمؤسسة دينية عريقة تاريخيًا لحماية هذا المذهب وجوانبه في التأويل، مما أعطى للفقيه المصري مرونة في التعامل مع النص الديني مكنت السلطة السياسية في الاعتماد عليه طوال التاريخ منذ العصر العباسي، حتى في ظل الثورة العلمية والتنويرية والحرية الليبرالية بالقرن العشرين، ظل فقهاء الأزهر لا يرفعون شعار القطيعة مع التراث كاستجابة آلية للسلطة السياسية ومصالح الدولة؛ بل فضلوا خيارا آخر ظلوا يعملون عليه حتى اليوم، وهو تأويل النص السياسي والصمت عن معظمه المكتوب في المدونات القديمة، وهذا الذي أوقعهم في مأزق أمام الجماعات التكفيرية -ظاهرية الفكر وحنبلية العقيدة- الذين أحيوا هذا النص السياسي واتهموا الأزهر بالعمالة للسلطة الكافرة برأيهم.
حدث نفس الحال في فرنسا حين ظلت قوة الكنيسة الكاثوليكية حاضرة للأسباب التي شرحناها عاليه بعد الثورة الفرنسية العلمانية (1789- 1799م)، وعادت لتهيمن من جديد، مما أشعل ثورات وإمبراطوريات ظلت تضرب فرنسا طوال القرن 19م، منها الإمبراطورية الفرنسية الأولى (1804-1814)، ثم استعادة البوربون (1814-1830)، وملكية يوليو التالية (1830-1848)، ثم أصبحت الكاثوليكية الرومانية مرة أخرى دين الدولة، وحافظت على دورها كدين الأغلبية بحكم الأمر الواقع خلال الجمهورية الفرنسية الثانية (1848–1852) والإمبراطورية الفرنسية الثانية (1852–1870)، ثم الحياد المطلق للدولة فيما يتعلق بالمذاهب الدينية، ثم قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة (1870- 1940) والرابعة (1946- 1958م)، والخامسة العلمانية التي تحكم الآن منذ 4 أكتوبر سنة 1958م.
سنرى من خلال هذا العرض أن الدول التي يشكل فيها البروتستانت أغلبية الشعب تسارع فيها السلطة للعلمانية وفصل الدين عن الدولة وفقًا لأهم قواعد السياسة، وهي (المصالح)، لأن الفكر الظاهري البروتستانتي لا يهتم بالمصالح ويرى المقاصد ثانوية، وبما أن فرنسا ذات أغلبية كاثوليكية؛ فتجربة العلمانية فيها كانت مؤلمة ضحى فيها الفرنسيون بالملايين، بينما لم يُضح الإنجليز والأمريكان البروتستانت بنفس القدر من التضحية، لأن خوفهم من الاشتباك مع الحرفية النصوصية الإنجيلية كان هو الدافع لإعلانهم القطيعة، ومسارعة الدولة بفصل سلطات رجال الدين عن المؤسسات، وهذا الذي يخدع البعض من المستنيرين الذين يرون أن العلمانية الأولى في دول البروتستانت دليل على عقلانية وتنويرية هذا المذهب، وهذا غير صحيح؛ حيث يمكن مناقشة عقلانية المذهب البروتستانتي بعيدًا عن السياسة، لأن تصوره السياسي حرفي للغاية، بينما يمكن رؤية عقلانية واستنارة رهبان البروتستانت في جوانب أخرى نظرية في الفلسفة واللغة وعلم النفس، إلخ.
التشابه الرابع
انتشرت البروتستانتية في أوروبا بفعل استفادتها من أجواء الإصلاح العقلي والعلمي، وفي ظل النهضة الأوروبية التي كانت تجتاح ميادين مختلفة آنذاك، ويعني هذا أن رهبان البروتستانتية لم يكونوا مؤسسين للنهضة؛ بل هم نتاج طبيعي لها في تطوير أسس التفكير، وهذا الذي حدث للسلفية الوهابية بالضبط؛ حيث استفادت في صراعها ضد الصوفية والتشيع بالمجتمع الإسلامي من رفض خرافات القرون الوسطى المتمثلة بالكرامات والأضرحة والتوسل والاحتفالات الدينية، التي كان يصاحبها العنف وغياب العقل أحيانًا، ومن تلك الجزئية حصلت على دعم وتعاطف العديد من الأدباء والكتاب الذين لم يقاوموا نزعة العنف والإرهاب فيها، وركزوا فقط على دعايتها ضد الثقافة الدينية الشائعة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأولياء الصالحين وكراماتهم، والتي يمكن تلمس بعض هذا التعاطف في فيلم “قنديل أم هاشم” مثلاً، فبرغم طبيعة العمل المشجعة للعلم، لكنها كانت تحمل رفضًا وثقافة جديدة معادية لمسألة الكرامات والادعاء بالإعجاز واللا سببية.
وأذكر هنا نصًا للشيخ “سيد قطب”؛ حيث أبدى إعجابه بالبروتستانتية، وأنها قامت على أساس إسلامي سلفي، والذي يعني في مرجعية قطب نفي القداسة عن الإنسان، وإرجاعها إلى الله بما فيها موضوع الحكم والدولة، يقول “قطب”: “وقد ظلَّ الحق المقدس للكنيسة والبابوات في جانب، وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقًا مقدسًا كحق الكنيسة في جانب، ظل هذا الحق أو ذاك قائمًا في أوربا باسم الابن أو مركب الأقانيم، حتى جاء الصليبيون إلى أرض الإسلام مغيرين؛ فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على «الحق المقدس»، وكانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و «كالفن» و «زنجلي» المسماة بحركة الإصلاح على أساس من تأثير الإسلام، ووضوح التصور الإسلامي، ونفي القداسة عن بني الإنسان، ونفي التفويض في السلطان لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام”. (في ظلال القرآن 2/ 299)
فوفقًا لسيد قطب فقد اجتمع التصور الإخواني للدولة – والمستقى من الفكر الوهابي السلفي مع التصور البروتستانتي حول التفويض للسلطان، ونفي الدور المؤسسي البشري في العلاقة بين الله والبشر، وأن هذا السلطان قائم حصريًا على عبودية وألوهية، وهو معنى الحاكمية عند سيد قطب، والتي رآها متمثلة في الفكر البروتستانتي الإنجيلي.
التشابه الخامس
انقسمت البروتستانتية لعدة مذاهب واتجاهات فكرية بفعل الظاهرية الحرفية النصوصية، وطريقة إدراك وفهم تلك النصوص في الذهن وفهمها مرة أخرى في الواقع؛ فقد انفصل أولاً السويسري “زفينكلي” المتوفى عام 1531 عن مارتن لوثر، وكذلك الفرنسي “جان كالفن” المتوفى عام 1564م وأتباعه الذين يعرفون بالكالفينية، ثم “الأناباتيست” المعروفون “بتجديدي التعميد”، الذين يرفضون تعميد الأطفال، ومع افتراق هؤلاء جميعًا، لكن اجتمعوا في القراءة الظاهرية للنص الديني، ولم تفارق طريقة مارتن لوثر في قراءة الكتاب المقدس عقول هؤلاء الرهبان وإن اختلفوا في فهم تلك النصوص، تبعًا لإدراكاتهم وقدراتهم العقلية، ويمكن مشاهدة طريقة عيش بعض المنتسبين للأنابيست مثلاً في “جماعة الأميش” البروتستانتية المسيحية، التي تعيش معظمها في الولايات المتحدة، ويرفضون فيها معظم الطرق العصرية للعيش، ويتبعون نمطًا بدائيًا يستخدمون فيه الخيول بدلاً من السيارات.
يتفق البروتستانت مع اليهود في الإيمان بالتوراة العبرية خلافًا للكاثوليك والأرثوذكس المؤمنين بترجمتها السبعينية اليونانية
ويمكن رؤية طُرق عيش الأميش في طُرق عيش بعض الوهابيين السلفيين الذين استغنوا عن الطرق الحديثة والوسائل المتطورة في القرن العشرين، لصالح ملابس وأدوات القرون الوسطى بالخصوص تلك الجماعات التي انطلقت في السبعينات، كالتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وغيرهم، والمشترك الذي جمع بين هؤلاء البروتستانت الأميش، وبين الوهابيين هو الذي نقصده بإيمان هؤلاء الحرفي النصوصي لدرجة عيشهم كُليًا في الماضي وتقديس الأجداد وعدم القدرة على الخروج عنهم، أو نمط عيشهم، وبالتالي عدم القدرة على الخروج عن أفكارهم واعتبارها مقدسة.
وكذلك يمكن فهم انشقاق البروتستانت بانشقاق الوهابيين؛ حيث اختلفوا أولاً لمذهبين؛ الأول جهادي معارض، والثاني مؤيد، اصطلح على الثاني بالسلفية العلمية التي تقول بطاعة الحاكم الظالم في دولة الشريعة، بينما الأول عرف بالسلفية الجهادية الذي يقول بوجوب إزالة الحكم الظالم وعدم طاعته، وقد رأينا ذلك في انشقاق الوهابيين الأبرز إبان معركة السبلة سنة 1929 بين مؤيدين الملك عبدالعزيز ومعارضيه من جماعة “إخوان من أطاع الله”، وكلاهما من الفقهاء ورجال الدين السلفية، وهو الذي ألقى بظلاله في التاريخين السعودي والمصري الحديث؛ حيث تمثلت عدة فرق وجماعات انبثقت من كلا التيارين، كجماعات الإخوان المسلمين وجهيمان العتيبي والتكفير والهجرة، ثم لاحقًا جماعات المدخلية والجامية والسرورية، وفرق كثيرة كانت تختلف إما عقائديًا وفقهيًا أو سياسيًا وحركيًا، وفي الغالب كان ترتيب الأولويات هو الطاغي.
ولولا غياب التأويل العقلي والسيطرة الدينية ما حدث ذلك الانشقاق السريع والكبير عند البروتستانت والسلفية؛ حيث يعاني الإيمان الحرفي النصوصي من غياب آليات حل المشاكل وإدارة الخلافات، من حيث تتبع هذه الآليات والحلول للرؤى العقلية والاجتهادات الحديثة، وهي حلول وآليات يملكها أصحاب العقل والتفلسف والتأويل حصرًا، ومتوفرة عند من يؤمن بالاجتهاد والتجديد لا غير، ويتمتع بها من يضع النص التاريخي والديني كموضعه في محل الفهم والاجتهاد والتطوير والنسبة والتناسب، وهي أمور غابت عن كلا المذهبين في الإسلام والمسيحية لصالح تطبيق هذه النصوص الدينية والتاريخية على ظاهرها، دون إخضاعها للفكر وعوامل الشك والملاحظة والمصلحة.
التشابه السادس
يتفق البروتستانت مع اليهود في الإيمان بالتوراة العبرية خلافًا للكاثوليك والأرثوذكس المؤمنين بترجمتها السبعينية اليونانية، وهو اتفاق أوجد مشتركًا بين العقل اليهودي والبروتستانتي تمثل في رفض البروتستانت مثلاً لسفر “طوبيا” الذي تؤمن به كنائس الكاثوليك والأرثوذكس، بينما يرفضه اليهود، وهو اتفاق أوجد خيالاً وذهنية دينية لدى البروتستانت جعلتهم يقرؤون الكتاب المقدس بعيون يهودية، وكان ذلك سببًا في قبول الصهيونية في المجتمع البروتستانتي؛ حيث أصبحت دعاوى الصهيونية –برغم أنها يهودية الجذر النصي– لكنها تتماشى مع العقل البروتستانتي المصمم عبريًا لغة وثقافة في قراءة النص الديني، وهو ما يُلحَظ وجوده في العقل السلفي المتأثر بالإسرائيليات والأساطير والقصص وملاحم آخر الزمان الشائعة في كتب التراث، وكانت سببًا في تغييب وعي المسلمين حاليًا وربطهم بأحداث ماضوية والعيش الكلي في عالم موازي ومفارق.
التشابه السابع
يتفق البروتستانت مع السلفية الوهابية (نظريًا) في أنه لا وسيط بين الله والإنسان؛ فلكل مؤمن له الحق بقراءة كتابه المقدس، كما أن له الحق في فهمه دون العودة للكنيسة أو الأولياء الصالحين، وعلى تلك الدعايا حصل مارتن لوثر وابن تيمية على شعبيتهما، وقلت نظريًا لأن التجربة العملية قالت شيئًا آخر، وهو أن السلفية الوهابية استبدلت عصمة وقدسية الأولياء الصوفيين بعصمة وقدسية ابن تيمية وابن عبدالوهاب أنفسهما، واعتمدوا في ذلك على قدسية وعصمة الصحابة الذين يملك الوهابيون والتيميون الحق الحصري في تفسيرهم وفهمهم، وهو ما اصطلح عليه في الأدبيات السلفية بعبارة (فهم سلف الأمة)، وعند البروتستانت كان ذلك واضحًا؛ فبرغم دعوتهم لإلغاء قدسية الكهنة والكنيسة، إلا أن التجربة قالت بحصول قساوسة البروتستانت على شعبية هائلة وتقليد حرفي واتباع لخطبهم ونصوصهم بتعصب شديد، وقد سقنا في الحلقات الماضية أسماء بعض رموزهم المؤثرة قديمًا وحديثًا في المجتمعين الإنجليزي والأمريكي.
السر في نشوء ذلك المشترك أن عقول العامة ظاهرية فاقدة لأدوات العلم والعقل والقياس، وفاقدة أيضًا للمعلومات وخبرة التجارب التاريخية، وهذه الأدوات موجودة عند القساوسة والشيوخ ورجال الدين؛ فبرغم ظاهرية هؤلاء القساوسة والشيوخ، إلا أن لديهم ما لا يملكه العامة؛ فتنشأ الحاجة نفسيًا عند الجمهور بضرورة الاستماع والتبعية إليهم، وهذا لا مفر منه في أي دين، والقول بوجاهة نفي الحاجز المعرفي بين الإنسان والنص يصطدم فورًا بتصنيفات العقول عند بعض الفلاسفة؛ أشهرهم ابن رشد بالعقل البرهاني والمنطقي والخطابي، وهو الذي يجعل ما يليق بالفقهاء والفلاسفة لا يليق بالعامة.
من خلال تلك التشابهات السبعة يمكن فهم لماذا خرجت دعاوى الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة من رحم الحنابلة ومذهب ابن تيمية الحراني الذي نشره الوهابيون، والمعروف حاليًا بالتيار السلفي، ولماذا في المقابل خرجت دعاوى الحكم اليهودي والمسيحي لدولة أرض الميعاد بفلسطين، التي هي شرط أساسي للمجيء الثاني للسيد المسيح، وبناء الهيكل الثالث للنبي سليمان من رحم المذهب البروتستانتي الإنجيلي، ومن خلال تلك التشابهات نفهم أيضًا كيف أن مجتمعات العرب الصحراوية اعتنقت مذهب الحنابلة وابن تيمية ونشرت الوهابية، وأن مجتمع الإنجليز في المقابل اعتنق البروتستانتية ونشر الصهيونية؛ فالعقلية الصحراوية المادية التي ترفض التأويل العقلي وتميل للظاهرية الفكرية بما جعلها في مرمى الاتهام بالتجسيم، هي نفسها العقلية الإنجليزية التي تميل لتفسير الكون وفقًا للحس والبرهان العملي، بما جعلها في مرمى الاتهام بالمادية والإلحاد والذرائعية وإنكار القيم الأخلاقية.
الأقباط في معظمهم معارضون لإسرائيل، وينتقد جزء كبير منهم جرائمها وينشطون مع المسلمين في ذلك، ما يعني أن هناك فارقًا ما بين (الصهيو- مسيحية) و (المسيحية)
فالذي حدث أن الوهابيين السلفيين أحيوا نصوص السياسة التاريخية لتصبح دينًا، والتي عُرفت بالسياسة الشرعية التي هي عماد الحُكم الديني في الفكر الإسلامي؛ فالنص التاريخي لم يعد مجرد رواية لها ظروفها بالزمان والمكان، لكنه دين وشريعة واجبة التطبيق، وهذا الذي حدث مع البروتستانتية بالحرف؛ حيث اندفع العديد من قساوسة البروتستانت في القرن 19م لإحياء دولة بني صهيون القائمة على فكرة المجيء الثاني للمسيح، وهي دولة دينية محضة لا تختلف عن دولة الإمامة في الفكر الشيعي والخلافة في الفكر السني، وكل هذه الدول الدينية من خلافة وإمامة وصهيونية هي دول تاريخية، منها ما جرى تطبيقه بشكل عملي كالخلافة، ومنها ما ظل في الإطار النظري والخيال الأدبي كالإمامة والصهيونية، مع الفارق بين هذه الدول طبعًا؛ حيث تتباين وتختلف عن بعضها في مقدار العنف وأولوية القيم الأخلاقية والعقلية ودور المصالح، إلى آخر هذه التباينات التي ليس هذا مجال ذكرها.
في الفرق بين "الصهيو- مسيحية" و"المسيحية"
أشير إلى أن هذه المشتركات السبعة هي حصرًا بين البروتستانتية الغربية والسلفية الوهابية، ولا تخص الفكر البروتستانتي الشرقي أو الأفريقي لعوامل أخرى، منها ما حدث في جنوب أفريقيا مثلاً حيث يغلب البروتستانت على مسيحيي هذه الدولة؛ فيميل هؤلاء – إضافة ليهود جنوب أفريقيا- إلى معارضة الصهيونية باعتبارها نظام فصل عنصري قومي وديني، وجنوب أفريقيا أكثر من عانت من هذه العنصرية؛ فهم على وعي كبير لتمثلاتها في بعض الدول، وإدراكًا لتجاربها في التاريخ؛ فيهود جنوب أفريقيا مثلاً كان لهم دور رئيسي لمقاومة التفرقة العنصرية، اقرؤوا عن السياسي “جو سلوفو” والكاتبة “روث فيرست” والمناضلين “دينيس غولدبرغ” و “ريموند سوتنر” و “راي ألكسندر سيمونز” و “روني كاسريلس”، وغيرهم”
ويمكن الاطلاع على تفاصيل بعض مذابح العنصريين البيض، ومنها مذبحة “شاربفيل” سنة 1960 ضد السود، وكيف أنها غيرت مواقف وحشدت آراء كثير من البيض ضد النظام السياسي العنصري الجنوب أفريقي، علمًا بأن الكثير من يهود العالم غيروا مواقفهم من إسرائيل في الـ 15 عامًا الأخيرة لمذابحها المتكررة ضد الفلسطينيين، فلم يعد بروتستانت هذه الدولة على رأي نظرائهم في الغرب، ويمكن القول بأن ذلك الفارق بين أبناء المذهب الوحيد لم يكن له أن يوجد دون تجربة سياسية مؤلمة، مما يشي بأن مستقبل الصهيونية في العالم معدوم، نظرًا لتجاربها المؤلمة في الحاضر، وأن ما نراه الآن من مجازر وإبادة جماعية في غزة، هو ثمن أي عمليات تحرير حدثت في الماضي، وسينظر لها الأحفاد باعتبار.
أما عن بروتستانت الشرق فأنقل لكم هذا النص من مقالي المنشور بتاريخ مايو 2021 على الحوار المتمدن بعنوان “أضواء على المسيحية الصهونية“:
“كل ما يقال عن الأقباط وعلاقتهم بالصهيونية محض كذب؛ فعلاقة أقباط مصر بالصهاينة تشكلت في عهد بطاركة وبابوات يحملون الفكر القومي المصري في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، كان أشهرهم البابا شنودة الثالث؛ فالأقباط في معظمهم معارضون لإسرائيل، وينتقد جزء كبير منهم جرائمها وينشطون مع المسلمين في ذلك، ما يعني أن هناك فارقًا ما بين (الصهيو- مسيحية) و (المسيحية)؛ فالأولى قامت على خلط الدين بالسياسة وإحياء نبؤات مخلص آخر الزمان في العهد القديم، وبقراءة ظاهرية محضة للنص الديني، بينما قامت الثانية على كراهية السلطة ومبدأ ما لقيصر المشهور، لكن الأولى تنشط بفعل المال للتأثير على مسيحيي الشرق بالخصوص، وهو ما سنشرحه في السطور المقبلة.
علمًا بأن مسيحيي الشرق يفضلون التأويل والقياس عن القراءة الظاهرية للنصوص الدينية، وبرغم إيمانهم بالعهد القديم فقد نجحوا في تأويل دولة أرض الميعاد عن معناها الظاهري؛ فصار مسيحيو الشرق غير مؤمنين في الغالب بإسرائيل، لكن البعض منهم يقع حاليًا فريسة للظاهريين الإنجيليين بأثر كراهيتهم للدواعش، بخلاف بعض مسيحيي الغرب الذين يغلب عليهم المذهب الإنجيلي الظاهري؛ فهم يكرهون التأويل والقياس، وتورطوا في الإيمان بدولة الميعاد اليهودية وخلط الدين بالسياسة؛ بل ضاقت الفجوة بينهم وبين الدين اليهودي حتى صار العهد القديم لديهم مركزيًا كالجديد، وتعاليمه السياسية واجبة؛ فكل من يؤمن بضرورة هدم الأقصى وبناء معبد سليمان مكانه، وفي ذات الوقت يؤمن بحق اليهود الآن في أرض الميعاد بفلسطين، هو صهيوني متطرف حتى لو كان مسلمًا؛ فالبعض ممن رفعوا شعار التنوير ونقد الجماعات يصحح دعوة الصهيونيين في ذات الوقت، وهنا الخطورة التي تشعل معارك طائفية لم تنقطع منذ عقود.
بتوضيح أكثر؛ فموقف الأقباط من إسرائيل هو موقف (كنسي) يختلط فيه الرفض السياسي مع الديني؛ فالأقباط يميلون لتأويل نصوص العهد القديم الخاصة بأرض الميعاد كما تقدم، وهو اتجاه فكري يرفض ظاهر النص الذي آمن به تيار المسيحانية الإنجيلية المؤيد غالبًا لإسرائيل من منطلق ديني؛ فالقبطي إذًا متأثر بالقومية المصرية التي لمعت واشتعلت في القرن 20 بزمن الصراع مع إسرائيل، وفي التفسير الديني يؤمن بقداسة رؤية الكهنة التي أولت أرض الميعاد عن ظاهرها، وهو اتجاه فكري مختلف عن الطابع الإنجيلي الظاهري الحرفي، ومسيحيو الشرق بالعموم (أقباطًا وسريانًا وآشوريين وكلدان ومارون..إلخ) غير مؤمنين بالصهيونية، وطريقة تفكيرهم مختلفة، علمًا بأن العهد الجديد لا تشغل فيه المساحة السياسية جانبا يُذكر؛ فالمسيحية وقتما كتب العهد الجديد لم تحكم دولاً؛ بل كانت مستضعفة على أيدي الرومان، وبالتالي نفهم لماذا يلحظ القارئ للعهد الجديد غياب السياسة والطمع في الحكم والثروات فيه بشكل ملحوظ؟”.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.


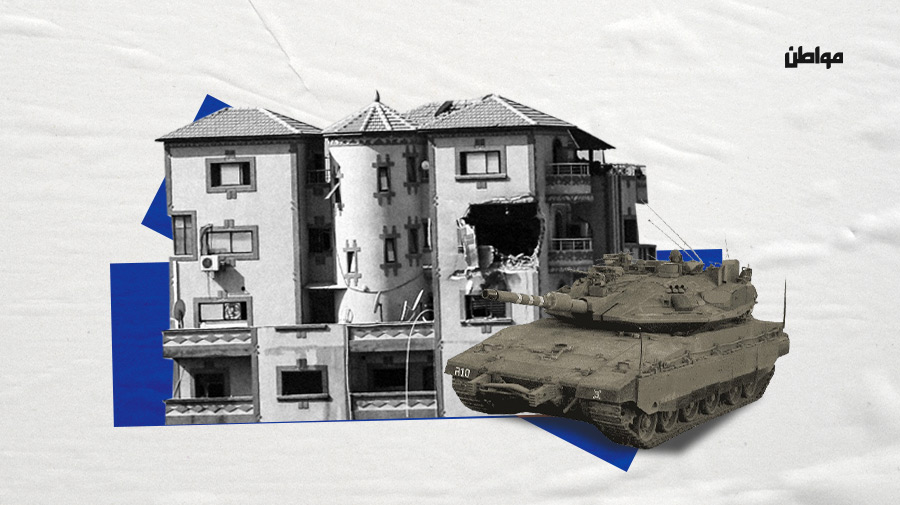





التعليقات 1